ليلى عيد: التنظيرات تهدر جوهر قصيدة النثر

الكثير من النصوص الشعرية التي تكتب اليوم تحاول الفكاك من التنظيرات النقدية، خاصة قصيدة النثر، التي تروم الفكاك من كل القيود الشكلية التي يرفضها الكثير من الشعراء، على غرار اللبنانية ليلى عيد التي تراوح قصيدتها بين ذاتها الأنثوية والتأمل في عمق الوجود. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الشاعرة.
تمتلك الشاعرة والروائية اللبنانية ليلى عيد حالة خاصة من الشفافية والرهافة، مكّنتها من تحويل آلام الإصابة بالجلطة الدماغية وتداعياتها إلى نايات وأناشيد ورقصات تنزفُ فنّا.
وعلى أعتاب صدور ديوانها الجديد “آخر الضوء.. أوّله”، التقتها “العرب” وسألتها حول تجربتها في إشعال قصيدة الومضة المختزلة كدمعة لا تجف في العيون، ومزج الشعري والسردي، والذاتي والعام، واتخاذ تفاصيل المرض ومحطّاته فهرسا لإبداعات نابضة، تتحدّى السقوط، وتقهر المصائر الحزينة.
أنا ما أكتب
منذ بواكيرها، اعتادت ليلى عيد في كتابتها المتمردة أن تبتلع السكاكين، وتسير على النيران صوب عشق فائر، لا تخفت ألسنته، ولا تبرد لواعجه، وأنتجت ديوانين هما “من حيث لا يدري” عن دار الساقي، و”أحيانا أرقص لو تراني” عن دار نلسن، ورواية عن دار الآداب بعنوان “حانة رقم 2”.
وقبيل الموعد المحدد لسفرها إلى مهرجان “لوديف” بفرنسا عام 2014، فاجأتها الإصابة المباغتة التي أربكتها في بداية الأمر، لكنها لم تستسلم طويلا لما فُرِضَ عليها من تقليص للحركة والتحدّث والإمساك بالقلم، فعانقت الكتابة بقوة، وكانت برقيّاتها الشعرية القصيرة فضاءات متّسعة للدهشة والشغف، وتمدّدتْ دفّتا ديوانها الوليد بين آخرِ الضوءِ وأوّله.
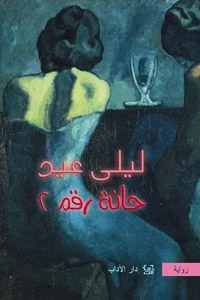
في كتابها الشعري الجديد، تبدو ليلى عيد أكثر تحررا وانفلاتا من أعمالها السابقة، بغير سذاجة في الانجراف إلى خلخلة التابوهات، فالقصائد مشحونة بالرغبة في البوح بلا قيود، والإفضاء بغير سقف، وتسجيل كلّ ما تمخضت عنه اللحظات القاسية.
والمفارقة أن تكثيف القصائد قد زاد تركيز حمولتها الانفعالية والتصويرية، ما منحها الطول الملائم لاستيعاب الدفقات البركانية: “أجراس تقرع أبواب عزلتنا التي تطول/ أين تقع مقابر الحب؟/ أريد أن أدفن قلبي وأستريح”.
تقول الشاعرة لـ”العرب”، إنها لم تضع شروطا لأي شيء، فجاءت الكتابة في منطقة وسطى بين الشعري والسردي وأدب الاعتراف: “يا شفيع الضالين مثلي، أيعقل هذا الكم من صدقي وصراحتي، حتى حدود الاعتراف؟ هل يكون هذا معيبا؟ لا أعرف”.
ترتحل الأديبة اللبنانية إلى الاتجاهات كلها، رافضة التصنيف في إطار، والتشرنق في قالب، وترى أن كل التقعيدات حول قصيدة النثر ومستجداتها قد صارت في الواقع أمورا متداولة وعادية، فيما لا يزال الكثيرون يغفلون الجوهر.
وتضيف “بعد تجربتي الطويلة والمريرة، لم أعد أجد أي أهمية في الوقوف عند الشكل. الشروط تفسد الأدب، والتنظيرات تهدر جوهر قصيدة النثر، لقد أدركتُ أن الشعر هو الشعر فقط، وكل ما يدور حوله لا يعنيني، أنا أحب وأحيا، وهكذا أعيش الشعر، وهكذا أعرّف عن نفسي: أنا ما أكتب”.
تحفر ليلى عيد بأظافر العناد نفقها نحو لؤلؤة السر، رافضة أن يخطئها الربيع، أو أن ينقطع في قلبها تدفق الغيم. لا يضيرها أن تبكي بكاء عظيما، طالما أن الأرض الخصبة من تحتها سوف تُنبت أعذب الثمرات. الحياة، أيّا كانت، هي المحنة الحقيقية، والصندوق المظلم، والكتابة هي الخلاص والانطلاق “أكتب لكي أتخفف من محنة الحياة”.
هي تستجيب لنداء اللاوعي، وتترك للكلمات العنان، لتسبح، وتطير. هل لذلك وَجَدَتْ في الغيبوبة ضالتها؟ تقول “آه يا أنا، يا ملكة الغيبوبات الخفيّة، أين أكون عندما لا أكون”.
وهي تمضي في كتابتها كمن تلقّى للتوّ ضربة قوية على رأسه، بعينين مفتوحتين، ربما لا تريان شيئا، وأحيانا تتحرك كالآلة المبرمجة، تضحك لأنها لم تقع، ولم ترتطم بشيء.
وحين تطالع نصوصها النهائية، تكتشف أنها لا تزال تتنفس، وأن اليقظة هي المظلة التي تحميها من العتمة والخسارات: “ارفعي رأسك يا ابنة الغابة/ أنتِ أجمل من أن تنامي طويلا/ هذا الليل الذي تظنينه ظلاما أو جنازة، سيعبر/ مثل زورق مليء بشهوات ملونة”.
هكذا، بإمكان الشعر أن يجعل الألم أملا، والتشنّجَ توتّرا إبداعيّا، والصراخ تهجّيا لألوان قوس قزح، وأن يوجد صيغة لتوحُّد الذات مع ذاتها، وإعادة قراءة الآخرين، والتفاعل الصّحّي معهم، عن قرب وعن بعد، بغير خدوش متبادلة.
أشرطة ومشاهد

تؤكد الشاعرة في حديثها لـ”العرب”، “هل هواية جمع الأقنعة التي تشغلني جزء معبّر عني؟ لن أكون محللة نفسية، سأكتفي بالقول إنني أتأمل تلك الوجوه، وتلك التعابير المختلفة، وقد أجدني أضطر أحيانا إلى أن أضع قناعا، لكن فقط أمام الناس، حرصا على عدم خدش مشاعرهم أو إيذاء نظرهم، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على السلامة العامة واللياقة الاجتماعية”.
وإن لم يكن بمقدور اللحظة المعيشة أن تصنع معجزة، أو تزيل لغما، فإن بإمكان الحلم أن يستخلص من الموت بعثا وخلودا، وأن يعوّض الذات الشاعرة التي لا تجد وطنا، بأن تكون هي وطن الذين لا أوطان لهم.
وتقترح الشاعرة شلالات من المآسي والتيه والسفر والعشق والجنون والصديقات والشبان المتبسّمين، وتواصل خيالاتها الأسطورية التي تهزم بها وَهنها ووجعها.
وتوضح “حلمتُ مرات بأن أكون وردة العشق، ونجمة أول البحر وآخر الغيم، سكونا وصبرا ووطنا لمن لا أوطان لهم، أنا الدمعة الوحيدة في عيون الآخرين، أعيشُ حتى نهاية الغبار. فرَسٌ جامحة، تلمعُ كأنها اللؤلؤ. المسافات التي قطعتها وأطويها في سِرجي لم تنتهِ بعد”.
هذه اللغة المراوغة التي تنتهجها ليلى عيد في حديثها، مثلما في شعرها، تفهمها الريح، وتوقظ ربابة في الجبل البعيد. أما دايفيد كوبرفيلد، ساحر القرن، فلربما تعلّم منها أسرار الإيهام والدهشة، واختراق فراغ العقول والقلوب والأجساد، ورسم نظرات الذهول، وخلق علامات الاستفهام.
وتستطرد شاعرة الكبسولات المضغوطة: “آه يا كوبرفيلد، علّمني كيف تستكين بعد كل عرض أو بعد موت قصير، ماذا تفعل عندما لا يصل الصوت؟”.
في شعرها، كما في سردها، تستحيل الذكريات الفردية والنشاطات الجمعية إلى أشرطة ومشاهد وصور دائرية، بغير توقف ولا انقطاع.
وفي روايتها “حانة رقم 2”، تقصّت ليلى عيد قماشة المجتمع اللبناني المهترئة في أعقاب الحرب الأهلية المدمّرة، مبرزة السلاسل المتكررة من الانكسارات والعلاقات المشوهة، وفي قصائدها الأخيرة، ثمة حضور للتشرذمات والانهيارات نفسها، على مستوى الذات الأسيرة، وفي تواصلها مع الآخر والعالم من حولها: “مهما ارتفعتُ/ مسافرةٌ في سماء/ أنحني وسط المسافة/ أنكسر/ غيوم خضراء/ استعارت طراوتي”.
تتكئ قصيدتها على دوال شتى، من رموز ومجازات وإحالات، لكنها دائما ذات صوت هامس، كأنه في وعاء صغير، يخص صاحبته والقارئ المقرّب، دونما تعميم، وبلا طنطنة موسيقية.
ينوب التعمق الرأسي هنا عن التوسع الأفقي، والتكريس لمعنى أو قيمة يمحو وطأة الغياب: “ليست كلمات هذه/ هي قطع من قلبي/ أرتق بها ثقوب غياب”.
أما العشق، فإنه السبيل الوحيد للرجوع من المتاهة، وتجاوز السراب، ولملمة النثارات، مثلما تؤكد الشاعرة في حديثها لـ“العرب”، “سنابل القمح تطير من وجهي، والمجرات. لعله الحب الذي يعيدنا، من يدري”.
الشاعرة لا تضع شروطا لأي شيء، لذلك جاءت كتابتها في منطقة وسطى بين الشعري والسردي وأدب الاعتراف
تقتحم الذات الشاعرة كوكب الأنوثة بنضج نسوي مكتمل التحقق “أنا أجمل امرأة في الكون/ لا تغار النسوة مني/ ﻷنني أنجبتهنّ آلهات كل حلم”.
ومع ذلك، فهي تحن إلى النوم في رحم أمها “جنينا”، لربما هو السأم، أو الزهد في حاضر لا يتحرك للأمام، ولربما هي حالة اللامبالاة التي تراها ليلى عيد عنوانا للمرحلة الراهنة، على كافة الأصعدة.
وعن هذه الحالة من الفتور تقول ليلى عيد في حوارها مع “العرب”، “تخذلني عبقرية هروبي وكسلي، ولم أجد المبرّرات والأعذار لنفسي لأفسّر لها أو نحلّل معا حالة القوقعة واللامبالاة الحميمة جدّا، التي تنتابني بين فترة وفترة، والتي طالت مؤخرا”.
وترى الشاعرة اللبنانية أن ما لا يُدرَكُ بالأيدي في الواقع، تستشفّه الحواسّ بالكتابة، وأن السّكنى في الحروف هي إقامة لهذا العالم المائل، أو ارتحال إلى ما هو أبقى وأجمل: “ارحلي بشمسكِ كتابا طازجا/ إلى حيث يكبرُ اللؤلؤ البكر”.




























