خطاب الأزمة وعلاقة بنية اللغة بهوية الأنثى

إذا كانت الهوية هي”السردية التي نرويها عن أنفسنا”، كما يقول ناقد ثقافي بريطاني، فهذا يمكَننا من تأكيد أن معرفة كيف تشكلت هذه الهوية مرهونة بالضرورة بتحليل بنية اللغة التي نسجت منها وبها هذه السردية في هذه الثقافة أو تلك الثقافة الأخرى، وأكثر من ذلك فإن عملية التحليل هذه لا تستقيم دون الكشف عن تضاريس تاريخ وانتماء سارد تلك القصة وخاصة موقعه أو موقعها الاجتماعي والظروف المحاطة به أو بها، ودون سبر العلاقة المتبادلة بين اللغة وبين بناء الشخصية سواء كانت ذكرا أو أنثى.
لا شك أن نقاد الثقافة قد اعتبروا اللغة مكونا أساسيا للهوية مما أدى بأحدهم إلى الجزم بأن المرأة، مثلا، لا توجد خارج السجل الرمزي. على أساس هذا فإن إدراك تاريخية تراتبية الاختلاف الجنسي في المجتمع غير ممكن دون تشريح الأسباب المادية والثقافية (اللغة جزء محوري من الثقافة طبعا) المنتجة والمكرسة للهيمنة الذكورية.
وفي هذا السياق نجد الناقد المصري نصر حامد أبوزيد قد خصّص جزءا مهما من كتابه “دوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأة” لتحليل علاقة اللغة بهويّة المرأة في بلداننا، وفي هذا الخصوص قام أبوزيد برحلة استكشاف داخل تضاريس متون التراث الثقافي والفكري العربي-الإسلامي واستنتج بعض النتائج المهمة وفي مقدمتها أن إدراك التمثلات المكرسة للمرأة في مجتمعاتنا مشروط بتحليل بنيات الخطابات السياسية والعقائدية، والاجتماعية، والدينية في تلك المجتمعات.
فهو يبرز أيضا أن تفكيك نص الطبري، مثلا، هو تفكيك لبنية اللغة كحامل لخطاب أسطوري ذكوري حول المرأة، ولا شكّ أن تحليل اللغة الذي قام به أبوزيد يعني أن أوضاع المرأة ووجودها ككيان هما من تشكيل الخطابات الثقافية/اللغوية والشروط المادية معا.
معاصرة رؤية أبوزيد
من الملفت للنظر هنا أن نصر حامد أبوزيد يتميز برؤية معاصرة حيث يلتقي توجهه النقدي مع أحدث النظريات الفكرية التي وظفها منظرون بارزون، أمثال ميشال فوكو وإدوارد سعيد لتحليل الدور الذي تلعبه منظومة السجل الرمزي في إنتاج الذوات والقوة معا وباعتبارها سلسلة الدوال التي تصنع جزئيا هذا الشكل أو ذاك الشكل من هوية هذا الذكر أو هذه الأنثى أو تلك.
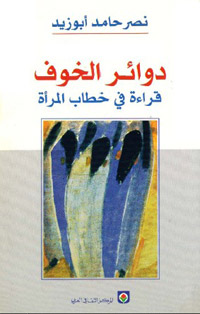
ويبدو واضحا أن معاصرة نصر حامد أبوزيد تظهر في كونه استثمر المنظورات الفكرية التي تتجاوز تحليل الوقائع والوثائق إلى تفكيك للخطاب/القوة، وفي هذا الخصوص بالذات نجد الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو في كتابه “تاريخ الجنسانية” قد قدم مسحا نظريا للأطوار التي أنتجت أنماط التمثلات للمرأة الأوروبية، ودور اللغة في ذلك.
وفي هذا الشأن كتب أبوزيد قائلا “فرضت الرعوية المسيحية كواجب أساسي مهمة إدخال كل ما له صلة بالجنس في طاحونة الكلام التي لا حدود لها، فمنع بعض الكلمات، والالتزام بنظافة العبارات، وكل الرقابة الممارسة على المفردات قد لا تكون سوى تدابير ثانوية بالنسبة إلى هذا الإخضاع الكبير، وسوى طرق لجعل الإخضاع مقبولا من الناحية الأخلاقية ومنتجا من الناحية التقنية”.
وفي الواقع فإنّ نصر حامد أبوزيد يشدّد على مركزية اللغة ودورها في إنتاج الفوارق بين الأعراق، وكذلك بين الذكر والأنثى، وهكذا يلاحظ أن “للخطاب العربي المعاصر جذوره في بنية اللغة العربية ذاتها، من حيث هي لغة تصر على التفرقة بين الاسم العربي وجذوره في بنية اللغة العربية ذاتها، من حيث هي لغة تصر على التفرقة بين الاسم العربي والاسم الأعجمي بعلامة يطلق عليها في علم اللغة ‘التنوين’ أو ‘التصريف’ وهو ‘نون’ صوتية تلحق آخر الأسماء العربية على مستوى النطق لا على مستوى الكتابة”.
ويضيف موضحا أكثر أن “هذا التمييز بين العربي وغير العربي على مستوى بنية اللغة وعلى مستوى دلالتها ينبع منه تمييز آخر بين ‘المذكر’ و’المؤنث’، وهو تمييز يجعل من الاسم العربي المؤنث مساويا للاسم الأعجمي من حيث القيمة التصنيفية. فبالإضافة إلى تاء التأنيث التي تميز بين المذكر والمؤنث على مستوى البنية الصرفية، يمنع التنوين عن اسم العلم المؤنث كما يمنع عن الاسم الأعجمي”.
هذا ويستنتج أبوزيد أن البنية اللغوية الصرفية “تمارس نوعا من الطائفية العنصرية لا ضد الأغيار فقط”، بل ضد الأنثى من الجنس نفسه كذلك، وهذا في تقديره أمر له امتدادات على مستوى الخطاب السائد المعاصر حيث تعامل المرأة معاملة “الأقليات” من حيث الإصرار على حاجتها للدخول تحت “حماية” أو “نفوذ” الرجل. ومن جهة أخرى يلاحظ أبوزيد أن بنية اللغة العربية لا مجال فيها لما “يسمى الأسماء المحايدة”، أي الأسماء التي ليست مذكرة أو مؤنثة كما هو الأمر في بعض اللغات الأجنبية.
توسيع مفهوم الخطاب
إن تحليلات نصر حامد أبوزيد لبنية اللغة في التراث العربي الإسلامي وإبرازه للخطاب اللغوي كخطاب منتج للهيمنة الذكورية ولتبعية المرأة ذات أهمية دون أدنى شك، ولكنني أسجل بعض الملاحظات النقدية التالية، وهي أن مفهوم خطاب اللغة عند نصر حامد أبوزيد ضيق أحيانا، لأنه محصور عنده غالبا في البنية النحوية والصرفية، والصحيح في تقديري هو أن النظام الرمزي يتجاوز نطاق النحو والصرف ليشمل أبنية الوعي واللاوعي الثقافيين السائدين في هذه المرحلة التاريخية أو تلك المرحلة التاريخية الأخرى. ولذلك فإن دراسة الأنظمة المدعوة بالأنساق الرمزية أمر ضروري لفهم علاقات القوة وكيف تنتج ولتفكيك إكراهات الهيمنة الذكورية وقصد صنع الذات الفاعلة.
ثم إنه ينبغي القول أيضا بأن النظام الرمزي لا يعني فقط النصوص المكتوبة، بل إنه يشمل كل ما يمكن أن يوضع تحت مظلة العلامة. فالمعمار مثلا، هو لغة/علامة، وفي هذا السياق نرى أن دراسات عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر بيير بورديو للعلاقة المتبادلة بين الفضاء المعماري وبين الأنوثة من جهة وبين هذه الأخيرة وبين الهيمنة الذكورية في المجتمع الأمازيغي الجزائري من جهة أخرى مفيدة، لأنها تمكنت من الكشف عن العنف الرمزي ودور العلامة والفضاء في تفريخه. ولتوضيح هذه النقطة أكثر، لا بد من القول بأن دراسة بورديو لخصائص المنزل الأمازيغي الجزائري وللأهداف المضمرة من وراء تقسيم بنية فضائه إلى مناطق للذكور وأخرى للنساء، تؤكد بوضوح أن المعمار/ الفضاء غير منفصل عن تقسيم الزمان واللغة، وبذلك تمكَن بورديو من فهم المعمار كعنصر مؤسس للذاتية وغير محايد، بل فقد أدرك أنّ التصميم الخاص بمعمار المنزل الأمازيغي لا يمكن فصله عن قيم الذكورة التي كرسها ذلك التصميم.
أبوزيد يلاحظ أن بنية اللغة العربية لا مجال فيها لما "يسمى الأسماء المحايدة"، أي الأسماء التي ليست مذكرة أو مؤنثة، كما هو الأمر في بعض اللغات الأجنبية
وبمعنى آخر فإن دراسة بورديو لخصائص المنزل البربري الجزائري قد جعلته يلاحظ وجود تطابق بين البنية المعمارية وبنية نسق الخطاب اللغوي المكتوب، ونمط الأدوار الاجتماعية المعطاة لكل من المرأة والرجل على نحو يضمن سيادة الذكر، ويسمي بورديو هذا النمط من المعمار-العلامة بالعالم مقلوبا. وفي الوقت نفسه بيّن بورديو أن توزيع الفضاء إلى ثنائيات متضادة متطابق مع ثنائيات متضادة مثل: الرجل/الخارج – المرأة/الداخل، حيث أنه لاحظ أن هذه الثنائيات هي معادل لواقع تقسيم العمل بين المرأة والرجل أيضا.
ورغم أن نصر حامد أبوزيد يشير مرارا، في كتابه المذكور آنفا، إلى ثنائية تقسيم الفضاء إلى خارج للرجل، وإلى داخل للمرأة، لكنه لا يدرس كيف تبني العلامة الرمزية العمرانية الذاتية وعلاقات الهيمنة الذكورية، ثم إن نصر حامد أبوزيد يحلل نقديا إكراهات الحجاب باعتباره عاملا من عوامل تحجيم الفضاء النسوي محاججا بأن المنزل قد حوّل إلى حدّ لفضاء المرأة، ولكن المشكلة الأساسية في خطاب الأزمة حول المرأة تتطلب الانتباه إلى أن ثقافة الذكورة تنتج في مجتمعاتنا هذه الإكراهات وهذه الحدود ثم تصبح جزءا من الشخصية القاعدية واللاوعي الاجتماعي، أو لنقل جزءا من الرأسمال الرمزي السلبي.
ولكن لا ينبغي تجاهل حقائق أخرى، وهي أن النساء في مجتمعاتنا يُعدن إنتاجها هذه الإكراهات والحدود، وغالبا دون وعي منهنّ، وتمثل هذه المشكلة إحدى العقبات الكبرى التي تحول دون تنظيف هذا المخزون من اللاوعي الثقافي السلبي الذي يعوق تحرّر المرأة والرجل معا في فضائنا الاجتماعي.




























