"الهايكو العربي" يحيل الشعراء إلى قفص الاتهام

قدّم الشاعر والناقد العراقي عذاب الركابي، المقيم في القاهرة، تجارب شعرية ونقدية مثيرة للاهتمام والجدل، منها محاولاته الإبداعية المتكررة في نحت قصائد “الهايكو العربي”. “العرب” التقته في حوار حول خصوصية نصوصه الفنية والتنظيرية، وظواهر الكتابة المبتكرة وملامحها، وعلاقة الكتابة والأجناس الأدبية بالحرية، وغيرها من قضايا الإبداع والنقد.
يتعاطى عذاب الركابي (70 عاما) مع الكتابة منذ ديوانه الأول “تساؤلات على خارطة لا تسقط فيها الأمطار” (1979) بوصفها سؤالا إنسانيّا مستعصيا، ويرى أن النقد في هذا المحيط الشاسع هو نصّ مواز للإبداع، ومشتبك معه بالضرورة كإبداع ثان.
في قصائده، يتسلق أشجار الأحزان، لعله يعرف كيف نمت وازدهرت. وفي اجتهاداته في حقول “الهايكو” الملغومة، يسعى وسط الانفجارات والانتقادات إلى معرفة ما يقولهُ الربيع، في عالم تسكنه الفوضى.
كما يتطرق إلى ظواهر شعرية وسردية حداثية وما بعد حداثية، مختلفة ومتقاطعة، في مصر والعراق وتونس والأردن وليبيا ودول عربية أخرى، عبر أجيال متتالية من المبدعين خلال الأعوام الخمسين الأخيرة.
أزمة الهايكو
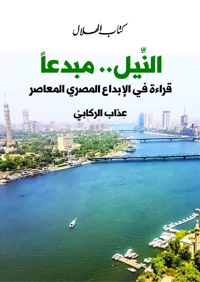
يثار جدل واسع حول ما إذا كانت ثيمات من القصائد العربية المضغوطة، أي قصيدة الومضة، قصيدة النانو، القصيدة القصيرة جدّا، الشذرة.. هي بالفعل ظلال “هايكو عربي” بمواصفات نوعية مشابهة للهايكو الياباني أو الهايكو الأميركي/ الغربي، أم أنها مجرد نصوص عربية مختزلة، بمواصفات وطبيعة أخرى، ولا تندرج بالتالي تحت تسمية “هايكو”، بما يحيل الكثيرين من الشعراء العرب إلى قفص الاتهام ودائرة استنساخ الظواهر الفنية شكليّا ولغويّا دون تفهّم جوهرها وروحها وبيئتها.
“صباحٌ ثملٌ/ طيرٌ يغردُ/ كيْ يُصحّيه”، هذا هو أحد نصوص عذاب الركابي، صاحب الدواوين الأربعة في ما جرت تسميته “هايكو عربي”. في حديثه لـ”العرب”، يقول الركابي “إن هذا الخلط المخلّ بين الهايكو وسائر أنساق النصوص المكثفة هو واحد من أعراض الأنيميا الثقافية التي يعاني منها بعض الكتّاب والشعراء في الوطن العربي من أدعياء التجديد، أولئك الذين ركبوا الموجة ظانّين أنّ كلّ قصيدة مقتصدة مقتضبة هي هايكو، وهذا خطأ كبير، بل إساءة في فهم تقنية هذا الفنّ العظيم”.
ويعود هذا الخلط، في رأيه، إلى تدليس أو إلى جهل محزن، فهؤلاء الكتّاب لم يعرفوا جوهر الهايكو، وربما لم يسمعوا أصلا بـ”الرنغا” ولا بـ”التانكا” التي انحدرت منها قصيدة الهايكو حتى استقرت على هذا الاسم بجهود مؤسسها باشو.
ويتابع “كما أنهم لم يطلعوا على مرجعيات الهايكو الياباني، متمثلة بكلاسيكياته وفلسفة “عقيدة الزن” التي هي رحمُ الهايكو وروحه، بمعنى الاستغراق في التأمل وصولا إلى الاستنارة واليقظة، وسيرة الرهبان الثلاثة باشو وبوسون وإيسا، مؤسّسي فن الهايكو، ولا على الهايكو الغربي الذي اختلف عن الياباني بمبدأ أن كلّ بيئة لها الهايكو الخاص بها، ما دامت الطبيعة هي مادته”.
ويضيف الركابي “من هنا وقع الخلط المؤذي للذاكرة العربية بين الهايكو وفنون الشعر الأخرى، التي لا علاقة لها بتقنية قصيدة الهايكو، التي لا يفهم منها هؤلاء الشعراء غير حساب عدد الأسطر والمقاطع، وكأن الأمر مجرد معادلات لفظية”.
ويؤكد أن الهراء بلغ بالبعض حد “أدلجة” القصيدة، وهي براء من الأيديولوجيا والغرام والحب والنضال، فهي الطبيعة البكر بكلّ كيميائها. موضحا أن انحيازه للكتابة الشعرية الجديدة بكل تجلياتها، وعلى رأسها “قصيدة النثر”، المُفْتَرَى عليها بإصرار، إذ يظن “الكتبة” أنها سهلة، وهروب مشروع من سجون الوزن والقافية، بينما هي حالة دهشة ولذة ومراوغة، يكمن فيها الجمال الخالص، بالرغم مما اعترى بعض نماذجها في الآونة الأخيرة من سقطات الأشكال الإبداعية بصفة عامة، ومنها المجانية والتكرار والثرثرة والابتذال واجترار تجارب الآخرين، في الخارج والداخل، وهي كلها أعراض أيضا للأنيميا الثقافية لدينا.
خطوات متعثرة
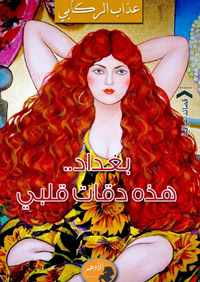
يلجأ مبدعون عرب كثيرون إلى كتابة النقد بصيغ إبداعية متحررة، انطباعية وشخصانية وارتجالية ومزاجية، سعيا إلى سد الفراغ، وأملا في مقاربة النصوص بشفافية لا تتوفر في كتابات الأكاديميين الجافة المعلبة.
لكن الكتابة بكل فنونها، لدى عذاب الركابي، هي سؤال دائم معلق، وتظل الإجابة عن هذا السؤال الإنساني الحضاري الوجودي ظامئة، متلهفة لإذابة ثلجه وإطفاء ناره معا.
هكذا، فإن الشاعر مبدع، والناقد مبدع، وهما معا يرتشفان رضاب الكلمات الصباحية، ويقودان مسيرة إبداع كوني حياتي إنساني، تبدو أحيانا بخطى متعثرة، وقد طالها الفايروس مبكرا، ودرءا لمخاطره لابدّ أن يكتب المبدعون نقدا.
النقد نصّ مواز للنصّ الإبداعي، شعرا كان أو قصة قصيرة أو رواية، والنقد الرؤيوي ما بعد الحداثي هو إبداع على إبداع، ونصّ مقابل نصّ، فقد سقطت إمبراطوريات النقد القديم الجاهز الطافح بالمصطلحات غير المفهومة.
ولم يعد النقد الأكاديمي المفلس قادرا على احتواء هذا الزحف الحضاري، والسيطرة على سيول الإبداع المتمرّد الجديد، وقد أعلن الناقد رونالد مكدونالد في كتابه القيّم “موت الناقد” منذ زمن موت النقد الأكاديمي الجاهز بقوالبه ورؤاه ومنظريه.
ويشير الركابي في حواره مع “العرب”، إلى ممارسة النقد الرؤيوي الحداثي، ومصدره الذائقة، “نكتب عن بعضنا البعض، وهي ظاهرة صحية كما تبدو لي، حيث انصرف النقاد الكبار والأكاديميون إلى الديكور الثقافي والمجاملة ولعبة تلميع الأسماء المحنطة التي تقاعدت حلما ورؤى، ولم يعُد لديها ما هو مثير ومُستفزّ”.
في هذا الإطار، انتقى الركابي “مبدعي النيل” للكتابة عنهم في أحدث كتبه النقدية حول الإبداع المصري المعاصر، وهؤلاء الذين أطلق عليهم صفة “الحالمين” هم أصدقاؤه الذين يشبهونه ويشبههم.
يقول “هذا هو أول مدخل لبوابات كتاباتهم، وأسرارهم وكنوز إبداعاتهم، وأعتبر نفسي جزءا من المشهد الثقافي المصري، حيث أقيم من سنوات، وأمارس أنشطة متعددة، وأسعى إلى المزيد من الانخراط والانصهار. ويبقى صوت الإبداع في مصر متفردا، شعرا ونثرا، حتى مع هذا التراجع الطارئ، وتأخر صدور الدوريات الثقافية المهمة”.
أسئلة الغربة والحرية
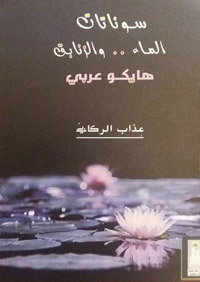
تحفل النصوص الشعرية الجديدة بالكتابة التلقائية والفضفضة، بعيدا عن الاشتغالات الجاهزة والقوالب المسبقة، وتلتقي الفيوضات الشعرية كبوح ذاتي مع السرد كفن محبوك في مناطق برزخية “عبر نوعية”، تذوب فيها الفواصل.
يؤمن عذاب الركابي بعدم وجود حدود بين الأنساق الإبداعية، ويقول في حواره مع “العرب”، “أجدني في الكتابة الشعرية رسّاما وموسيقيّا وساردا، ويحضرني حديث ميشال بوتور عن الرواية الجديدة: تزداد رغبتي أكثر فأكثر في أن أؤلف صورا وأنغاما بواسطة الكلمات. قصيدتي هي رؤية ما لا يُرى، وسماع ما لا يُسمع، بحسب تعبير رامبو”.
ويضيف “أعطي الكلمات حرية المبادرة، كما أوصى مالارميه. قراءاتي الكثيرة، حتى الإدمان، مصدر هذا اللعب الفني الغريزي بالكلمات، قصيدتي مهارة لعبة كلمات بذاكرة لا يطولها صدأ النسيان، إيقاعاتها الصاخبة تحرّض الحياة على الموت”.
ابتعد الركابي عن وطنه العراق منذ أكثر من أربعين عاما، لكنه على صلة بتفجرات الشعر العراقي الجديد، من خلال متابعاته، وعلاقاته بشعراء العراق، في الداخل وفي المهجر، ومنهم من رفقاء الاغتراب: عدنان الصائغ، هاشم شفيق، حاتم الصكر، هادي الحسيني، رياض النعماني، خلف جبر، باسم فرات، أمجد محمد سعيد، بشرى البستاني: “هؤلاء شعراء وطن غاب، وصُودرَ، فلم يعُد لنا، وأصبحنا في أجندة حكّامه ومسؤوليه مواطنين مجازا”.
وتؤكد تجربة الركابي أن اغتراب الكاتب يزيد تعلقه بالوطن واحتفاءه به في نصوصه، ويوضح قائلا “الغربة وطن مُتخيّل، كنتَ كمبدع تحلمُ به، صورة على الورق، وها أنت تشكلُ شوارعه وأناسه وبناياته ومؤسساته بالكلمات، صناعة خيال، وهو الوطن الوحيد الذي بلا جمارك، ولا حدود، ولا شرطة، ولا تأشيرات دخول وخروج. وطن علمني الكتابة بالجسد لا بالأصابع، وعلمني الحديث بقلبي لا بلساني. هو الوطن اللامكان واللازمان الذي حدوده الأفق. أنا نصّي، والوطن ذكرى مبعثرة في مفرداته، غادرني ذات ليلة باردة، وظل يسكنني، ولا أستطيع الهروب منه”.
ويشكل غياب الحرية أبرز العوائق أمام ظهور مرايا إبداعية جريئة قادرة على التعبير عن الواقع العراقي الراهن من داخله، ففي حاضر كابوسي ضاع المواطن، ولم تعد لديه أبسط حقوقه في الحياة. ومع غياب المنابر الثقافية المهمة، ارتبك النشر في العراق، ومن ثم فقد تواصل الكتّاب والمبدعون العراقيون مع الفضاء الثقافي العربي، فلجأوا إلى النشر في العواصم العربية والعالمية. ويتساءل عذاب الركابي “نحن إزاء مواطن ميت، تأخّر دفنه كثيرا، فكيف تكون هناك حرية، وكيف تكون هناك كتابة مناوئة تعكس الواقع العراقي بصدق؟”.




























