خلدون الشمعة.. ناقد عربي يفكك فكرة شيطنة الآخر

بعد كشف مكامن الاستشراق، الكثير من المفكرين العرب وحتى القراء العاديون باتوا ينظرون إلى دول الشرق ودول الأطراف على أنها في تبعية كاملة للغرب المركزي، بينما تغفل هذه الرؤى التأثير المعاكس الذي حققته ثقافات الشرق في المنظومات الفكرية والأدبية والثقافية الغربية.
خلدون الشمعة ناقد مكرّس على مدى نصف قرن أو ربما أكثر. وتعود علاقتي الثقافية والإنسانية به إلى سنوات طويلة حيث كنت أتابع نشاطه النقدي على صفحات مجلات الآداب البيروتية، والمعرفة السورية، والآداب الأجنبية وفي عام 1975، التقينا في الجزائر أثناء إلقائه لمحاضرة بقاعة الموقار بدعوة من وزارة الثقافة الجزائرية وأهدى لي كتابه المهم “الشمس والعنقاء: دراسات في المنهج والنظرية والتطبيق” الذي كتبت عنه تحليلا في ما بعد في كتابي “الحضور” الصادر عن وزارة الثقافة الجزائرية في عام 1977.
تجذبني إلى كتابات الصديق خلدون الشمعة المتضمنة في كتابيه “النقد والحرية”، و”المنهج والمصطلح” الدقّة في استخدام المصطلح والاقتصاد اللغوي الرشيق مما يجعله يبدو أنه وريث معلمين متضافرين وهما اللغة العربية المكتنزة وفكرها وآدابها، والانفتاح الواعي على الجديد والأبرز في الفكر النقدي الغربي وخاصة الإنجلو ساكسوني.
في السنوات الأخيرة أنجز خلدون الشمعة أطروحته للدكتوراه باللغة الإنجليزية حول النقدين الأدبي والثقافي، وسوف تأخذ هذه الأطروحة مكانتها الطليعية في خارطة النقد العربي المعاصر بلا أدنى شكّ.
في هذا السياق ألفت الانتباه بأنني قد لاحظت أن الناقد خلدون الشمعة معاصر تماما حيث إنه ملمّ فعلا بإحداثيات النقد المتطور ومدارسه واتجاهاته المطعمة بالفكر الفلسفي في المشهد الثقافي الغربي، ويبدو هذا جليّا أيضا في كتابه الصادر حديثا عن دار المتوسط بإيطاليا بعنوان “المختلف والمؤتلف”.
في كتابه “المختلف والمؤتلف” يناقش الناقد الشمعة عدة محاور أساسية في مشهد النقد المعاصر وأقتصر في هذه العجالة على إضاءة بعد مهمّ وهو منظور التأثير المعاكس الذي نجد مكونات تشكله في المحاور المكونة لمحتوى هذا الكتاب وهي “من الاستتباع إلى الاستحواذ” وتفريعاته، و”شعريات المثاقفة” وخاصة في مبحث “أفول التنوير” وتفريعاته، و”النموذج المرجعي” الذي يدرس فيه ثنائية الأنا والآخر عند إدوارد سعيد، وفلسفة الاختلاف عند جاك دريدا، ومحور “شيطنة الآخر” الذي يدرس فيه تمثيلات الآخر في الفكر الغربي، وبرنارد لويس واكتشاف الإسلام.
نحو منظور جديد

في إطار الكشف عن عناصر التأثير المعاكس ينتقد الناقد خلدون الشمعة في كتابه خطاب المركزية الغربية وصوره النمطية عن الشرق ويحذر من أن “هذا الخطاب المجتر والمتواطئ عن الآخر، اخترق وعي العربي مشكّلا لديه مفهوما جوهرانيا مراوغا للحداثة…”.
ومن ثم يقوم الناقد الشمعة باختراق القفص الفولاذي الذي أسر وما يزال يأسر معظم نقّاد الثقافة في العالم العربي وأغلب العاملين في إطار الأدب المقارن الذي لا يزال تقليديا في العالم العربي. أعني بالقفص الفولاذي المغلق الدوران النمطي للنقد العربي في فلك اصطياد بعض عناصر تأثير الأدب العربي والشرقي على الآداب الغربية، أو تقصي التأثير الغربي على الثقافة العربية والإسلامية إلى حد الهوس، أو اللجوء إلى تلخيص المتون النظرية والمفهومة الغربية، وخاصة المعاصرة لنا منها، والاكتفاء بشرحها حينا واستخدامها حينا آخر في عمليات مساءلة البنيات التراثية والأدبية والفكرية عندنا.
ففي كتاب “المختلف والمؤتلف” يمكن لنا أن نجمع العناصر التي تشكل الهيكل النظري لمنظور “التأثير المعاكس” الذي لم ينجزه إدوارد سعيد المشدود دائما إلى تفكيك بنيات الخطاب الكولونيالي، وغياتري سبيفاك وهومي بابا اللذين تستقطبهما بقوة نفس المسألة النمطية فضلا عن هوسهما بالتجريب المستمر لمركب نظريات التفكيك ونقد الخطاب واللاوعي الكولونيالي لتشغيلها في نقد مختلف الصور الكولونيالية. لا نجد الاهتمام بالتأثير الثقافي والفكري والفني المعاكس أيضا لدى إيمي سيزار في كتابه “خطاب حول الاستعمار”، ولدى فرانز فانون في كتبه “أقنعة بيضاء، جلود سوداء”، و”معذبو الأرض”، ولدى جان بول سارتر في كتاباته عن نقد الاستعمار الفرنسي للجزائر ولفيتنام، ولدى ألبير ممّي في كتابه “صورة المستعمِر والمستعمَر” وغيرهم.
أصطلح على هذا المنظور بكلمة “التأثير المعاكس” الذي ينظّر له كما ينبغي في مشهد النقد الثقافي أو الكولونيالي وما بعد الكولونيالي عندنا أيضا. وأعني به التاثيرات التي مارستها أشكال التعبير الثقافي والفني والفكري العربي والشرقي على الإنتاج الثقافي والأدبي والفني لدى الغرب وعلى ذهنيته.
وفي هذا الخصوص ينبغي التوضيح أن استراتيجية منظور “التأثير المعاكس” لا يلغي نقد الكولونيالية وتحليل تأثيراتها الثقافية والفنية والذهنية، بل هو الدراسة المزدوجة للتأثير الكولونيالي وللتاثير المعاكس له على نحو متزامن.
محاولات مختلفة
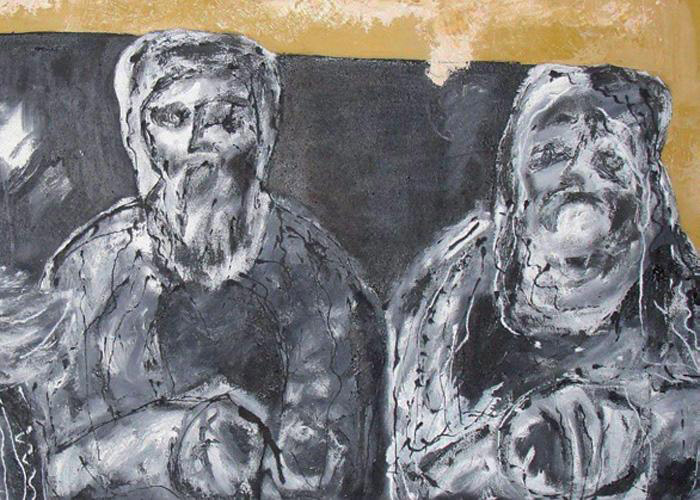
في الواقع إن هذا المنظور شبه منعدم ككيان نظري متكامل في تخصص الدراسات ما بعد الاستعمارية في الغرب وعندنا أيضا في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد نلاحظ أن الدراسات المنضوية تحت مظلة نظرية التبعية التي تختص برصد مفارقة ملفتة ومؤلمة في آن واحد، وهي غرق بلدان الأطراف في العالم الثالث في الفقر رغم أن ثرواتها هي التي تتدفق إلى الدول الغربية الكبرى وتوفر لها أسباب الغنى.
ولكن نظرية التبعية تشكو من اختزال الثروات المتدفقة من دول الأطراف الفقيرة في المصادر المادية ونادرا ما تدرس الرأسمال الثقافي الرمزي لهذه البلدان واستغلال دول المركز في الغرب لهذا الرأسمال سواء تمثل في الاستيلاء على ثروات أشكال التعبير الثقافي، أو على المثقفين الذين يرحّلون إلى أوروبا/ الغرب بواسطة الإغراءات المختلفة حيث يتم استغلال كفاءاتهم الثقافية والفكرية والتعليمية وهلمّ جرا.
ونفس النقد يوجه إلى نظرية أنظمة العالم التي تكتفي بسبر عناصر تشكل النظام العالمي المتمركز غربيا وتحددها أساسا في تقسيم العمل جهويا أو على نحو عابر للأوطان ومن خلال تصنيف “العالم إلى بلدان مركزية، وشبه طرفية، وطرفية” غير أن نظرية النظام العالمي لم يكرس روادها دراسات ميدانية ونظرية للكشف عن صراع أو حوار المضامين الثقافية بين البلدان المركزية وشبه الطرفية والطرفية.
في إطار الكشف عن التأثير المعاكس ينتقد خلدون الشمعة في كتابه خطاب المركزية الغربية وصوره النمطية عن الشرق
في هذا السياق ينبغي القول إن تخصص “دراسات التابع” باعتبارها فرعا من المنظور ما بعد الكولونيالي الكلي لا يخلو بدوره من آفة نسيان منظور “التأثير المعاكس” جراء تركيزه على منطقة آسيا والهند خاصة والاقتصار على تقصي واقع “الطبقات الاجتماعية السفلى والمجموعات الاجتماعية الأخرى المقذوف بها إلى هوامش المجتمع” وخصوصا النساء وكل المجرّدين من الفاعلية، دون إبراز تأثير مقاومات الرأسمال الثقافي والروحي لهذه الفئات والشرائح على المستعمرين وعلى الطبقات المستغلة لها في الداخل.
رغم بعض هذا القصور في دراسات التابع وفي نظرية التبعية وفي نظرية النظام العالمي، هناك استثناءات تتمثل في المحاولات الجادة التي تمت، ولو أنها لم تكن خارج إطار النسق النظري ما بعد الكولونيالي، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر محاولة جورج جيمس في كتابه الفلسفي المعنون “الموروث المسروق” حيث كشف فيه عن علاقة التناص بين الفلسفة اليونانية وبين مصر حينا، وتأثير هذه الأخيرة على تشكيل عناصر مهمة من التفكير الفلسفي الإغريقي حينا آخر.
هناك أيضا محاولة الدارس المفكر مارتن برنال في كتابه “أثينا السوداء” بجزأيه المكرسين لاستجلاء طبيعة علاقة المثاقفة بين الجذر الثقافي الأفريقي الآسيوي وبين ما يصطلح عليه بمعجزة الفكر اليوناني الذي تعده أوروبا خصوصا منطلقا لمرجعية هويتها الحضارية. ويمكن اعتبار كتاب جوليا كريستيفا “غرباء عن أنفسنا” من الإشارات الدالة على أنّ الفكرة الأثيرة في الفكر الفلسفي والتحليل النفسي المعاصرين وهي فكرة الآخر، والآخرية (Otherness)، ضمن علاقة الغرب بالآخر، قد ظهرت أعراضها المبكرة في مسرحية أسخيلوس “المتضرعات” التي تشهد أنّ أول الغرباء كنّ نساء مصريات مهاجرات ويلقبن بـ”الدانيات” اللواتي أتين طلبا للحماية ولكن الإغريق قابلوهنّ بمساءلتهن للكشف عن عرقهن الدموي المختلف عن العرق اليوناني.




























