حين تحرر الثقافةُ النت.. هل القارئ هو الرابح الأكبر
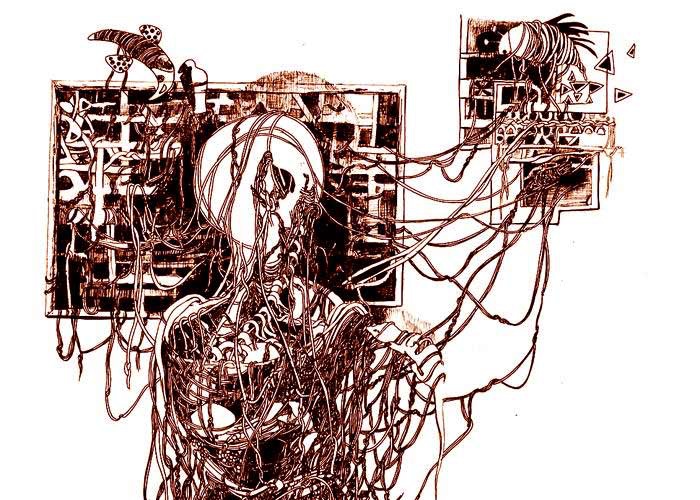
في اللحظة التي يصر الكثيرون على حصر الخسائر الناجمة عن الحرب المفترضَة بين النت وبين الوسائط الورقية قد لا يتم الانتباه إلى أن القارئ هو الرابح الأكبر في هذه المعركة التي لا وجود لها إلا في مخيلة البعض. إذ أن ما يحققه اجتياح النت يصب في نهاية المطاف لصالح مشهد القراءة. بل إن البشرية لم يسبق لها أن عاشت فيضانا على مستوى حجم المعلومات، كما تعيشه الآن، حيث تتدفق الآلاف من المعلومات في كل لحظة، مع إمكانيات البحث المتعددة التي تمنحها قواعد المعطيات البيبليوغرافية والنصية، ومواقعُ الرصد التي تمنح إمكانيات تَتبُّع المعلومات فور صدورها وتحليلها وتيسير الولوج إليها من طرف القارئ.
ولعل هذا المنطق هو ما حكم ظهور حركة “الثقافة الحرة”، التي تمتد جذورها إلى ما قبل لحظة ظهور تكنولوجيا المعلومات الجديدة، والتي ستتقوى في الوقت الراهن. وذلك باعتبارها حركة مجتمعية تدعو إلى حرية تداول الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية بشكل مجاني.
مع التطورات التي يحققها النت بشكل مستمر، سيكون من نتائج هذه الحركة ظهور ما يعرف بالأرشيفات المفتوحة المتاحة بشكل مجاني أمام الكل، بشكل يعكس دمقرطة المعرفة والحق في تشاركها من طرف الجميع. وسيصير مذهلا، انسجاما مع ذلك، أن يستطيع أي قارئ أن يحصل، بمجرد نقرة، على كتاب كامل أو على فيلم أو على مقطوعة موسيقية بشكل مجاني.
وسيكون موقع ويكيبيديا أشبه بحصان طروادة الذي راهن عليه أصحاب الحركة، حيث إن جموح هذا الموقع، الذي سيقفل قريبا العشرين من عمره، لا يتوقف. إذ وصل عدد مقالاته إلى الخمسين مليون مقال، بينما جاوز عدد زواره الثمانين مليون زائر. ولعل الضحية الأولى لهذا الجموح هي الموسوعات الورقية التي لم يعد عدد منها يصلح، مع هذا الوضع الجديد، إلا لتزيين صالونات البيوتات. وإن كان نظام ويكيبيديا، الذي صار يشكل العشَّ المفضل الذي يلجأ إليه قراصنةُ الكتابة، يظل مفتوحا على فائض من الأخطاء، بحكم فلسفته القائمة على غياب نظام للقراءة القبلية.
ولن يتوقف لهيب الدعوة إلى مجانية الولوج إلى النت هنا، بل ستصل شرارته إلى مجال الكتابة والنشر في الحقول العلمية والفكرية. ولعل ذلك يشكل ردا على الهيمنة التي تمثلها المجلات العلمية والثقافية المتاحة من خلال الاشتراكات، التي لا تتوقف عن الارتفاع، مع كل الشروط التي يضعها الناشرون والموزعون على مستوى الاستعمال. وهو ما سيكون وراء قرار عدد كبير من الجامعات الأوروبية توقيف اشتراكاتها.
وسيفتح كل ذلك الباب أمام انبثاق الآلاف من المجلات العلمية والفكرية المتاحة بشكل مجاني أمام الجميع. وكان ذلك الطريق الأفضل لمسايرة ارتفاع وتيرة الإنتاج العلمي والفكري الذي يعرفه العالم، خصوصا مع توجه الجامعات إلى ربط مسار ترقية الأساتذة الباحثين بإنتاجيتهم العلمية. وهو ما يترجمه بشكل خاص قانون “أنشر أو انقرض”. وهو القانون الذي كانت قد سنَّته، بشكل مبكر، الجامعات الأميركية، وعيا منها بكون النشر هو الذي يمنح الحياة لكل السنوات التي يُمْكن أن يقضيها الباحث وراء نتيجة أو موضوعة أو إشكالية ما، وأيضا بكونه المسلك الذي يقود نحو تبادل المعارف وتراكمها.
وسيكون هذا القانون وراء فيضان على مستوى النشر، خصوصا بالولايات المتحدة الأميركية. وذلك ما تعكسُه معطياتُ “فهرس الاقتباس العلمي” الذي أطلقته مؤسسة طومسون رويترز الكندية. إذ تشغل المقالات المنشورة بالولايات المتحدة الأميركية رُبع ما صَدر بالعالم. وإن كان هذا القانون سيُحاط، مع توالي السنين، بكثير من التساؤلات. إذ أن الربط بين الترقي المهني والنشر كان وراء الكثير من الانزلاقات، ومن بينها بشكل أساسي، تراجع القيمة العلمية لما يُنشر وتزايد ظاهرة السرقة العلمية. ولعل التحقيق الذي كانت قد أطلقته، قبل سنة، عشرون جريدة عالمية، بشكل مشترك، يكشف عن حجم وخطورة الأمر. ويقف التحقيق، الذي همَّ عشرة آلاف مجلة صادرة في مختلف بقاع العالم، عند مظاهر تزييف نتائج الأبحاث العلمية والتي تُنشر دون المرور عبر بوابة لجان القراءة، بشكل يهدد أسس المعرفة العلمية الإنسانية بكاملها.
ولعل الحالات في هذا الإطار عديدة وتهم كل الجغرافيات الثقافية والعلمية. غير أن أطرفها يتجلى في تورط دار النشر سبرينغ الألمانية الشهيرة في نشر أكثر من مئة مقال تمت كتابتها عن طريق برمجة آلية للكمبيوتر، قبل أن يتم الانتباه إلى الأمر والإعلان عن سحبها. أما الجامعات المغربية فستختار، في سياق محاربتها لاجتياح السرقات العلمية، ضمَ تهديد صريح بسحب شهادة الدكتوراه، ضمن المحاضر الخاصة بمنحها. وإن كان ذلك أمرا غير سليم، إذ أن ذلك يجعل الباحث متهما إلى أن تثبت براءته، وذلك بشكل معاكس لمنطق القانون.
وبعيدا عن السياق الغربي، يبدو أن العالم العربي قد أضاع الفرصة التي تمثلها الأرشيفات المفتوحة بما تمنحه من إمكانيات على مستوى تيسير تداول الأبحاث العلمية والفكرية. وذلك في الوقت الذي يظل النت العربي مفتوحا على المئات من المواقع الإلكترونية المواظبة على نشر الآلاف من العناوين المقرصنة، التي تختلط فيها كتب التراث بكتب الدعوة إلى الإرهاب.
في آخر دراسة تهم وضعية الأرشيفات المفتوحة على مستوى العالم العربي، يقف الباحثان التونسيان محمد بن رمضان وطارق الورفلي عند مظاهر النقص التي تطبع هذه الأرشيفات، والتي لم تكن تتجاوز بالكاد، قبل سنوات قليلة، العشرين أرشيفا على مستوى مجموع الدول العربية. وهو ما يجعل من حضورها باهتا مقارنة مع كثير من الدول، بما فيها الدول الضعيفة اقتصاديا.
والأكيد أن ذلك يخالف ما راكمه العالم العربي على مستوى تاريخ تداول المعرفة، عبر مختلف وسائطها، سواء المخطوطة منها أو الشفهية. ولعل من مظاهر ذلك تحبيس الكتب على المدارس وإنشاء المكتبات وفتحها أمام الباحثين، بما فيها مكتبات السلاطين!




























