تكييف النص السردي للمسرح وإشكالية المصطلح

ثمة تمييز في النقد المسرحي المنهجي بين مصطلح “التكييف” ومصطلحات أخرى مثل “الإعداد” و“الاقتباس” و“المسرَحَة” و“الاستلهام” و“الاستيحاء”، لكن أغلب نقاد المسرح وباحثيه في عالمنا العربي يخلطون بينه وبين هذه المصطلحات، و يستخدمونه مقابلا لها.
إن مصطلح “التكييف” (Adaptation) بالإنجليزية يشير إلى تطويع، أو تحويل نوع أدبي معيّن إلى نوع آخر، أو تغيير بنائه مثل تكييف نص سردي (ملحمي، حكائي، روائي، قصصي، سيَري) أو شعري إلى نص مسرحي أو سيناريو سينمائي أو دراما تلفزيونية. وقد شاع في العصر الحديث مع تداخل الفنون، وزوال الحدود بين الأجناس الأدبية والفنية. أما تاريخ ظهوره فإنه قديم قدم الإبداع، كما يتمثّل في تكييف كُتّاب المسرح الإغريقي ملاحم هوميروس إلى نصوص مسرحية شعرية.
ويُعدّ النص المسرحي المكيّف عن نص سردي إعادة إنتاج، حسب نظرية التناص، لأن الأول قالب آخر للنص الثاني السابق عليه أو المعاصر له، أو أنه امتصاص وتحويل وتشرّب للنص الثاني، كما تراه جوليا كرستيفا. جرى تحويله من فضائه السردي إلى فضاء حواري درامي، أو ربما إيمائي أو حركي أو راقص، عبر اشتغال دراماتورجي، يقوم على الفعل الآني المباشر للشخصيات من دون وسيط أو سارد، ويحيا حياة أخرى.
ولا شك في أن عملية تكييف النصوص السردية إلى نصوص مسرحية تحتاج إلى معرفة عميقة بفن المسرح وخصائصه واشتراطاته الأدبية والتقنية. وتكمُن أهميتها، لكلا النوعين الإبداعيين، في أنها تسهم في تقريب الفن السردي إلى شرائح اجتماعية غير معنية، أو قليلة العناية به، وتؤدي دورا في الترويج له. فضلا عمّا تشكّله العوالم السردية من مصدر إثراء للمسرح، بما تنطوي عليه من أحداث وشخصيات ورؤى وهواجس إنسانية، فردية وجمعية، شديدة الالتصاق بالواقع والحياة. لكن عملية التكييف يمكن أن تسيء إلى الفن السردي إذا تصدى لها أشخاص طارئون يفتقرون إلى الموهبة أو الكفاءة المسرحية العالية، لأنهم قد يشوّهون النصوص السردية التي يكيّفونها.
إن التكييف الناجح والماهر لأي نص سردي إلى نص مسرحي ينبغي، في رأيي، أن يُشعرنا بانقطاع حبل السرة بينهما، على مستوى البناء الفني. فلا نعود نقرأ الثاني، أو نشاهده مُخرجا على الخشبة، وذهننا منصرف إلى الأول، إن كنّا قد قرأناها، لأن ذلك يفسد جمالية التلقي.
لكن في حالة القراءة النقدية للنص المسرحي لا بدّ من إجراء مقارنة، على الصعيدين البنائي والدلالي، بين النص المكيَّف والمكيَّف عنه، أو البحث في العلاقة الحوارية الناشئة بين النصّ اللاحق والنصّ السابق.
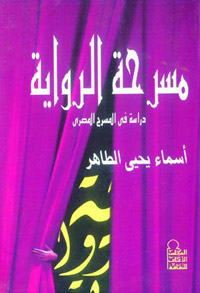
ومن بين الباحثين العرب الذين استخدموا مصطلحي “الإعداد” و“المسرَحة” بوصفهما مرادفين لمصطلح “التكييف” نشير إلى ثلاثة باحثين، تمثيلا لا حصرا، هم المغربي عبدالمجيد شكير والمصرية أسماء يحيى الطاهر والجزائرية سارة طمين.
درس الأول في بحثه “جمالية الكتابة الدرامية في المسرح المغربي”، ثلاث طرائق لممارسة الإعداد عن نصوص مسرحية عالمية وعربية ومغربية، ولم يتطرق إلى الإعداد عن نص سردي. كما استخدم مصطلح “المسرَحَة” معرّفا إياها بأنها “كتابة درامية تنطلق من الاشتغال على نصوص غير مكتوبة للمسرح في الأصل. إنها كتابة تشتغل على النص الشعري والسردي بشكليه القصصي والروائي، وتحوّله إلى نص مُمَسرح قابل لأن يُعرض فوق الخشبة”.
واستخدمت أسماء يحيى الطاهر مصطلح “المسرَحَة” في كتابها “مسرَحَة الرواية: دراسة في المسرح المصري”، الذي تناولت فيه ظاهرة ما تسميه “مسرَحَة الروايات في المسرح المصري” من خلال النصوص المسرحية، وليس تجارب عرضها على المسرح.
أما سارة طمين فقد استخدمت مصطلح “المسرَحَة”، أيضا، في بحثها “مسرَحَة الرواية في الجزائر: من رواية “أنثى السراب” لواسيني الأعرج إلى مسرحية “امرأة من ورق” لمراد سنوسي. وقد خصصّت فصلين نظريين لـ“مسرَحَة الرواية” من حيث مفهومها، وشروط الرواية الممسرَحَة، وآليات المسرَحَة، والمراحل الإجرائية اللازم تتبّعها من أجل “مسرَحَة” رواية. وفي الفصل التطبيقي أخذت “مسرَحَة” رواية واسيني الأعرج نموذجا، من خلال منهج موازن.
لقد استخدم هؤلاء الباحثون الثلاثة وغيرهم مصطلح “المسرحة”، الذي هو ترجمة لمصطلح (theatricality) في الإنجليزية، على الرغم من أنه مصطلح عصيّ على التعريف، ولا يزال حتى اليوم يثير التباسا، كما يقول باتريس بافيس. لأنه يتحمّل توصيفات متعددة من خلال أشكال تمظهره في العروض المسرحية اليوم. وكل من حاول البحث في موضوع المسرَحَة وتعريفها وصل إلى نتيجة مفادها أنها مرتبطة بما هو مشهدي ولا علاقة لها بالنص.
واستخدم باحثون وكتّاب ونقاد عرب كثيرون مصطلح “الاقتباس” ليشيروا به إلى عملية “التكييف”، قائلين، مثلا، إن المسرحية الفلانية مقتبسة عن الرواية الفلانية، كما في حالة مسرحية “الحرب الصامتة” (تكييف الكاتب الفلسطيني طالب الدوس)، التي قيل إنها مقتبسة عن رواية “مملكة الفراشة” لواسيني الأعرج. ومسرحية “كل شيء عن أبي” (تكييف الكاتب والمخرج المغربي بوسلهام الضعيف) التي أُشير إليها في أكثر من مقال نقدي على أساس أنها مقتبسة عن رواية “بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات” للروائي والناقد محمد برادة.
كما أقيمت لموضوعة “الاقتباس” ندوات عديدة في أكثر من بلد عربي، أكتفي بالإشارة إلى ندوة واحدة، على سبيل التمثيل، وهي الندوة التي استضافها نادي أمحمد بن قطاف في المسرح الوطني الجزائري سنة 2017، بعنوان “الرواية الجزائرية والركح”.
وقد ناقش فيها عدد من المسرحيين الجزائريين قضية الاقتباس وغياب الرواية الجزائرية في المسرح الجزائري، واتفقوا على ضرورة اقتباس الرواية الجزائرية دون التوقف عن الكتابة للمسرح. وذهب أغلب المتدخلين إلى أن الاقتباس عملية مفتوحة على الأجناس الأدبية والفنية كلها، لكن باكتساب المقتبس لأدوات المسرح وفهمه لخصوصية الركح وما يتطلبه.
وأرى أن استخدام مصطلح “الاقتباس” في هذا السياق قاصر، إلى حد ما، لأنه لا يدل على تكييف الرواية أو تحويلها من نص سردي إلى نص مسرحي، بل قد يُراد به أن الفكرة الرئيسة للنص المسرحي مأخوذة عن الرواية أو مستوحاة منها.




























