بعد قرن من ولادتها الرواية العربية لم تتغير كثيرا
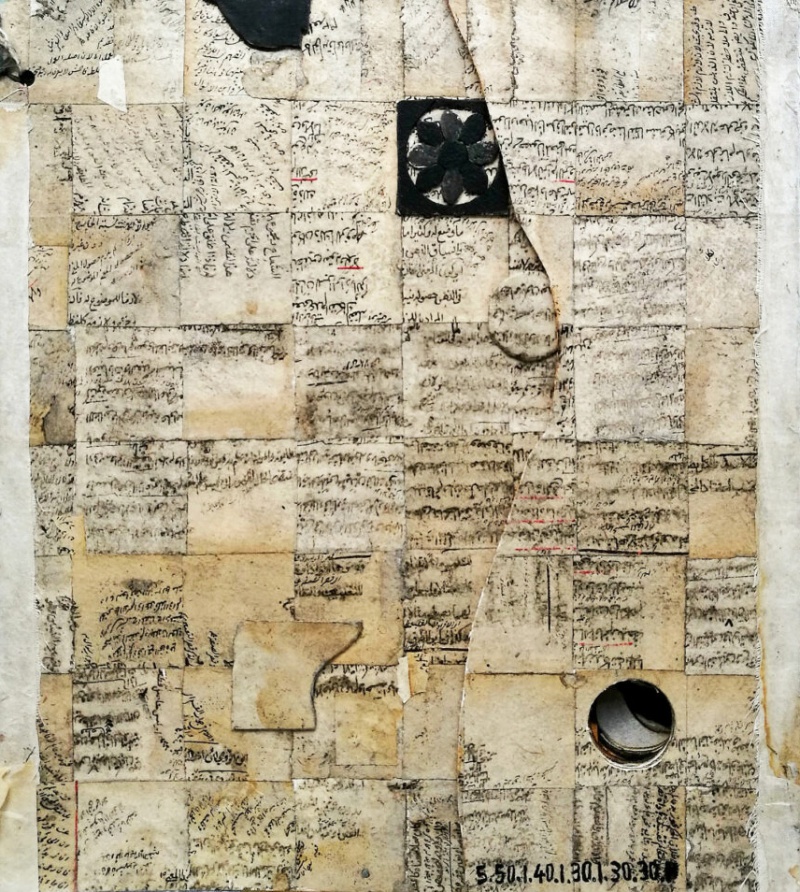
التأثير الغربي على النقد العربي بالغ وعميق حتى أن الكثير من النقاد العرب يستقدمون أفكارا ونظريات نقدية غربية ويبدأون في إقحام النصوص عنوة فيها، ما ينتج خللا فادحا في الخطاب النقدي والأدبي على حد سواء. حيث ليست غاية النقد هي ترسيخ أسلوب ما أو تثبيت أفكاره كما يعتقد هؤلاء، بل غايته التجريب وفتح آفاق جديدة للأدب.
يختبر الناقد الدكتور رامي أبوشهاب، في كتابه الجديد “خطاب الوعي المؤسلب في الرواية العربية” ظاهرة الوعي في الرواية العربية بوصفها صيغة من صيغ رؤية العالم، ولاسيما تأمل الذات التي تختبر منعطفاتها في إدراك الكينونة، وتموضعها في العالم.
ويسعى الناقد، ضمن مشروعه، المختص بخطاب ما بعد الكولونيالية والدراسات الثقافية، إلى تبني قراءة موسعة في نماذج من السرد العربي لعدد من الروائيين والروائيات العرب من منطلق أن الرواية العربية كانت حاضرة في تمثلاتها للواقع والتاريخ والأنا والهوية والاستعمار والنسوية، ومعضلة الحداثة إضافة إلى السياقات الطارئة على المستويين السياسي والاجتماعي.
تبصرات نقدية
يحمل الكتاب، الصادر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، عنوانا فرعيا هو “مقاربات في النقد الثقافي: ما بعد الكولونيالية، النقد النسوي، والتاريخانية الجديدة”، ويتضمن قراءات لأهم الروايات العربية نذكر منها “عصفور من الشرق” لتوفيق الحكيم، “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح، “الأشجار واغتيال مرزوق” لعبدالرحمن منيف، “عائد إلى حيفا” لغسان كنفاني، “أعناب مركب العذاب” للطاهر بن جلون، “حرب الكلب الثانية” و”زمن الخيول البيضاء” لإبراهيم نصرالله، “بوابة الذكريات” لآسيا جبار، “القرصان” لعبدالعزيز آل محمود، “الديوان الإسبارطي” لعبدالرحمن عيساوي “موت صغير” لمحمد حسن علوان وغيرها.
ويبين أبوشهاب أن اختيار هذه الأعمال قد خضع إلى رغبة في اختبار المنظورات النقدية ضمن سياق ما بعد البنيوية بهدف إعادة قراءة الرواية العربية، بدءا من منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا، ولاسيما صيغة الوعي التي تتصل برؤية العالم، وتمظهرها خطابيا.
التلقي العربي للتيارات النقدية الغربية لم ينتج أفكارا لأنه تعامل معها بصورتها السكونية لا الديناميكية الحية
ويرى الناقد أن هذه المقاربات للعديد من المتون السردية، التي تنتمي إلى قطاعات جغرافية مختلفة من العالم العربي، وبخاصة تمثل الوعي الكامن في هذه المتون، إذ تحضر فيها مقولات الأيديولوجيا والتاريخ والمتخيل والنسوية التي تبدو متعددة من حيث الاختيار، غير أنها تترصد في تعددها وتنوعها القبض على مقاصد الوعي الممتد إلى عقود طويلة من الكتابة السردية العربية.
يندفع المؤلف إلى قراءة جزء من المشهد السردي العربي ضمن مقاربة أشبه بتبصرات نقدية تقترب من وضعية منهجية أحيانا، وفي بعض الأحيان تفارقها عن وعي، أو قصد؛ رغبة في التخفف من النموذج الأداتي نحو نموذج أشد التصاقا بالنص وروحه في حدود المتعالية المنهجية، ولكن دون استلاب لنبض النص، وفيضه الدلالي، فالنص يحتفي بمقصدية يوليها الكتاب الأهمية الكبرى في حدود الممارسة الفنية.
يهدف الناقد إلى أن يُبقي على فاعلية النص، مع الحرص على ألا تطغى عليه الاقتحامات المنهجية، وتسلبه كينونته التي ربما تتوارى خلف الرغبات الأكاديمية التي تجعل من النص الأدبي مجالا للتدليل على الفاعلية الأداتية، مما يدفع إلى طمس مقصديته التي تتعالق مع العالم بوصفها رؤية له.
ويرصد أبوشهاب تمثلات الوعي العربي ضمن مستويات نقدية تحتفي بعناوين ترسم ملـمح التوجه النقدي، الذي يتصل بإعادة تركيب المتون السردية، في إطار تمثل نموذج الرؤية الناتجة عن تشكل الوعي المؤسلب (نقديا)، مؤكدا أن معظم التيارات النقدية التي شاعت في الغرب كانت تنطلق من فهم للظواهر الاجتماعية في تقاطعها مع السياقات، أي أنها لم تكن غايات بحد ذاتها.
ويشدد الناقد على أن المقاربة اللغوية التي شاعت في الغرب بحثا عن تحقيق أدبية الأدب، أو الوصول إلى علم الأدب- على سبيل المثال – كانت تنطلق من الرغبة بنبذ الأيدولوجيات بعد حربين عالميتين، والبحث عن صيغة يقينية لفهم الأدب بوصفها فعلا نسقيا لا يتعرض لعوامل خارجية، وعليه فإنه يمكن أن نتمثله في ظل صراعات تطال النزعات الفردية والنزعات المجتمعية الناقدة ممثلة بتيارات ماركسية، وتاريخية، ومدرسة فرانكفورت، وغيرها، أي أنها بالمحصلة تفسيرات ورؤى تشتبك مع مكون فكري عميق، لا غايات بذاتها.
التلقي العربي

التلقي العربي للتيارات النقدية، لم ينتج أفكارا؛ لأنه تعامل معها بصورتها السكونية، لا الدينامية، بل إنها في معظم الأحيان قد غرقت في التّصور اللغوي الذي بدا لها نموذجا أو خروجا عن الاشتغال بالأفكار، فهذه المقاربة على الرغم من أنها كانت موقفا فكريا إلا أنها في النقد العربي بدت حلا للتحرر من الأفكار والانهماك بدراسات وأبحاث لم تحدث وعيا في العقل العربي الذي بدا في تبنيه للنموذج اللغوي، أقرب إلى ممارسة هوس كامن في الماضي، فمن السهولة بمكان أن تتبع البنى والأنساق والتقابلات والتكرار، وغير ذلك بعيدا عن أي “إرهاص فكري”.
ويذهب الناقد إلى أننا لا نكاد نرى تحولا بارز الانعطاف أو العمق نحو صيغ سردية جديدة على المستوى الفني، ولاسيما على مستوى التشكيلات التي تتخفف من أنماط السرد التقليدي (الآمن) إلى حد ما، في حين أن مستويات الرؤية بدت قلقة حيث ما زالت الشخصية العربية تعاني إشكاليات تبدو تاريخية؛ على الرغم من مضي قرن على انطلاق أول رواية عربية، فالهوية النسوية ما زالت معرضة للاستلاب، فضلا عن مواجهة صيغ العنف الذي يطال التكوين الداخلي كما الجسد، في حين أن الاستعمار ما زال يصوغ هويتنا التي تآكلت بفعل التفوق الحضاري للآخر، والذاكرة ما زالت تستعاد سرديا، ولاسيما العلاقة التي حكمت الشخصية العربية عبر نتاج التجربة الاستعمارية.
ومن ناحية أخرى يرى أبوشهاب أن المنعطفات التاريخية كالنكبة أو النكسة ما انفكت تحضر في تشكيل الوعي العربي عامة، والفلسطيني خاصة، في حين يرصد الكتاب بعض الانبعاثات لقضايا تتعلق باضطراب الوعي العربي نتيجة الأزمات التي نتجت بفعل الإرهاب، وتداعيات هذا على مشهدية الثقافة العربية بصيغتها الجديدة.
ويمضي الناقد مبينا أن مفهوم الوعي في المتخيل الأدبي يتعلق بقدرته على أن ينظر إلى النص بوصفه يحتمل مستويين من الوعي، وهو لا يريد أن ينساق إلى التوصيف الأفلاطوني حول ظاهرة الأشياء وحقيقتها، ولكنه معني بالنص بوصفه تشكيلا خطابيا يمتد إلى نموذج مرجعي يُعنى بتكوين العالم.
في النص يتخذ هذا العالم وعي النص المُتخيل كما يحتشد بالدلالات، ومن هنا، يجد نفسه أمام وعيين، وعي التأويل للعالم وإدراكه، في حين يأتي الوعي الآخر لفهم الصيغة الناشئة من لدن القارئ الذي يمارس التأويل في مرحلة ثانية، كما يسعى في الآن ذاته إلى التوصل إلى حقيقة هذا العالم المعاين من قبل الروائي أو الكاتب، أو المبدع عامة، وكلاهما من منطلق التجربة.
يُذكر أن المؤلف مولود في مدينة الزرقاء بالأردن، ويحمل شهادة الدكتوراه في النّقد الأدبي الحديث “الخطاب والنّظرية النقدية” من معهد البحوث والدّراسات العربية في القاهرة، وحاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2014 عن كتابه “الرّسيس والمخاتلة: خطاب ما بعد الكولونيالية في النّقد العربي المعاصر”. من مؤلفاته “بناء الشّخصية الرّمزية في الرواية العربية في الأردن”، ومجموعة شعرية بعنوان “عدت يا سادتي بعد موت قصير”.




























