"الجديد" تحتفي بيوم الشعر العالمي
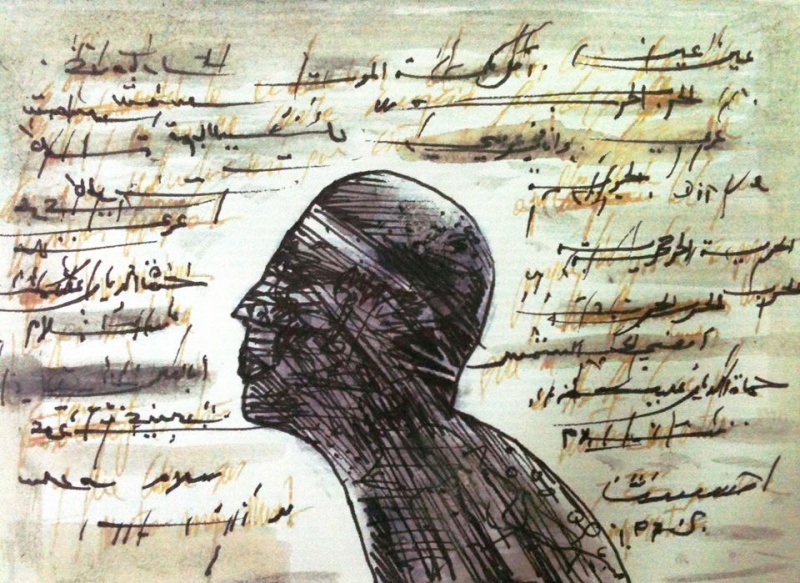
رغم ما يحاط به الشعر من أحكام فضفاضة وسطحية من قبل الكثير من المتدخلين في القطاع الثقافي والأدبي، ورغم التهم الجاهزة له بأنه في تراجع وبلا قراء وغيرها، فإنه يثبت في كل مرة قدرته الكبيرة على تجاوز السطحية والنفعية التي تحكم بعضهم، ويقدم في كل مرة تجارب ورؤى تضيء مسيرة الإنسان، وهو ما تؤكده مجلة “الجديد” في ملفها الأخير.
احتفاء باليوم العالمي للشعر، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس كل سنة، بادرت مجلة “الجديد” الثقافية اللندنية إلى نشر ملف كبير عن الشعر في موقعها الإلكتروني مرفق بعددها الـ74 الصادر في مارس الحالي.
وتضمن الملف ثلاث مواد بداية بترجمة جديدة لملحمة إليوت الشهيرة “الأرض اليباب” أنجزها الشاعر العراقي فاضل السلطاني، والتي ستصدر في كتاب عن دار المدى موفى هذا الشهر، وقد زودها بمقدمة عامة ودراسة مقارنة لست ترجمات سبق أن وضعت للقصيدة بالعربية، مع مقدمة عن الترجمة الجديدة كتبها الناقد السوري خلدون الشمعة بعنوان “الأرض اليباب على محك الداروينية”.
ثاني مواد الملف ترجمة لمجموعة قصائد مختارة للشاعر الإسباني أغوستين بوراس أنجزها الشاعر المصري أحمد يماني، مع دراسة في شعر الشاعر بقلم الشاعر والناقد الإسباني مانويل مارتينيث فوريجا بعنوان “أغوستين بوراس.. الشعر ينتصر دائما” كتبها خصيصا من أجل الترجمة العربية.
وثالث الملفات ترجمة لباقة أشعار آخر شعراء البيت الأميركي الذي رحل مؤخرا تحت عنوان “لورنس فيرلينغيتي.. الشعر، فن الفتنة الكبرى” للشاعر المغربي حسن نجمي مصحوبة بمقدمة عن شعر فيرلينغيتي وتتضمن ترجمة لبياناته الشعرية.
الترجمة حياكة
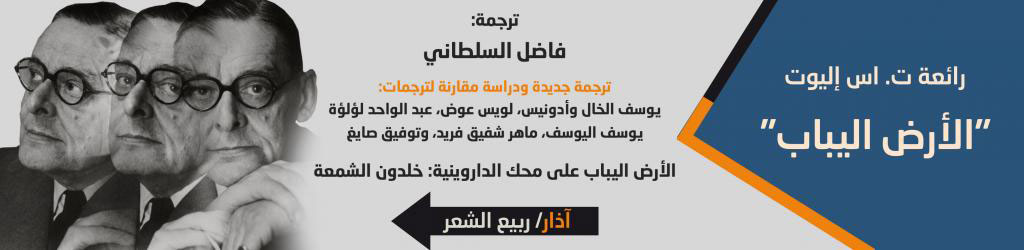
يتساءل فاضل السلطاني في تقديمه لترجمة “الأرض اليباب” قائلا “لماذا هذه الترجمة لقصيدة ‘الأرض اليباب؟‘ سؤال لا بد أن يخطر في ذهن أي قارئ حين يقرأ ترجمة جديدة لعمل ما. وقبل القارئ، هو سؤال يقلق المترجم نفسه، وقد يدفعه إلى ترك المحاولة برمتها، ويريح رأسه ورأس القارئ أيضا، الذي قد لا يكلف نفسه قراءة عمل مترجم سابقا تعرف عليه وألفه مهما كان مستوى الترجمة التي اطلع عليها”.
ويقر أن الأمر يزداد تعقيدا إذا كان العمل قد ترجم عدة مرات من قبل، وليس مرة واحدة، على أيدي كتّاب ونقاد وشعراء معروفين، قد تكفي أسماؤهم لتزكّي عند القارئ ما يفعلون وما ينتجون. لكن السلطاني يجد “أن الأعمال العظيمة قد شكلت على مر العصور موضوع ترجمات عديدة”، كما قال الناقد بول ريكور مرة. وعبر التاريخ الأدبي، ثمة أمثلة كثيرة على ذلك (ترجمات ملاحم “الأوديسة” و”الإلياذة” لهوميروس و”إنيادة” فيرجيل وملحمة كلكامش).
وإذ يذكر السلطاني الملاحم هنا دون غيرها، لأنه يعتبر، مثل كثيرين، عربا وأجانب، “الأرض اليباب” ملحمة القرن الماضي فعلا، وربما تكون الملحمة الوحيدة في ذلك القرن الشقي، إضافة إلى الأعمال الأدبية التي ترجمت أكثر من مرة إلى هذه اللغة أو تلك والتي لا يمكن حصرها.

المجلة تدعو الشعراء العرب والنقاد والمتابعين إلى الاحتفاء بالشعر بوصفه صوت الوجدان الإنساني والبؤرة المركزية للجمال
ولكن، مع ذلك، ليس هذا هو الدافع الأساسي لترجمة السلطاني الجديدة لـ”الأرض اليباب”، بل لأنه وجد أن الترجمات العربية المختلفة لها منذ الستينات تحتوي على أخطاء كثيرة في فهم النص الأصلي، وفي مواضع مهمة إلى الدرجة التي تعكس المعنى إلى نقيضه. إلا أنه، كما يشير، لا يقصد من ذلك التقليل من شأن هذه الترجمات، ولا من الجهد الكبير الذي بذله المترجمون الذين يناقش ترجماتهم هنا، وهم يوسف الخال، أدونيس، لويس عوض، عبدالواحد لؤلؤة، يوسف اليوسف، ماهر شفيق فريد وتوفيق صايغ.
فقد قدم هؤلاء جميعا خدمة كبيرة للثقافة العربية، وللشعر تحديدا، حين ترجموا منذ وقت مبكر “الأرض اليباب”، مساهمين بذلك في إغناء تجربة الشعر الحديث التي شكلت هذه القصيدة بشكل خاص عنصرا أساسيا في تشكله وتطوره اللاحقين، كما حصل مع التجارب الشعرية الجديدة في أجزاء كثيرة من العالم.
ويرى الناقد خلدون الشمعة، في دراسته، أن الترجمة إلى العربية تحيلنا في تعدديتها وتباين نتائجها إلى بيولوجيا دارون ونظرية النشوء والارتقاء، فهي، أي الترجمة، تصبح كما يفترض المرء نتيجة للتكرار داروينية في حرصها على الكمال والاكتمال.
التكرار، كما يرى الشمعة، تمثله تعددية ترجمة عمل أدبي مهم كالأرض اليباب، يظل، شئنا أم أبينا، فعلا دارويني المنزع. وهذه الأدائية يبرهن على فاعليتها الشاعر والناقد فاضل السلطاني في كتابه البديع الذي يستعرض كمال واكتمال ست ترجمات عربية لرائعة إليوت، من خلال التحديق مجددا، تحديقا مقارنيا في نصوصها: تصويب هناتها الهينات حينا، أو تعديل أو تصحيح كلماتها حينا آخر، أو ربما اقتراح قراءة مدققة مستجدة في ضوء احتكام موضوعي للأصل الإليوتي.
ويشبّه الشمعة الترجمة بالحياكة بسبب تماهي وتطابق عمل النساج وعمل المترجم عن عمد، وليشير إلى ما تنطوي عليه ترجمة فاضل السلطاني هذه من قابلية، وربما فاعلية، لتحقيق ضرب من الطباق اللغوي والشعوري بين نص بالإنجليزية وآخر بعربية مسلحة بالدقة والرونق، أي تحقيق قدر معقول من المماهاة بين الأصل والصورة.
وهذا النموذج يقف على النقيض من نموذج آخر ألفناه في أدبنا العربي خلال العقود الخمسة الأخيرة وهو الترجمة من لغات أجنبية، وبخاصة الإنجليزية والفرنسية، ترجمة ربما يمكن القول إنها تفتقر إلى قدر من المراوغة، ترجمة حرة ذات مرجعية حداثية، مطلقة العنان وتتحرك فيها النصوص الشعرية بين اللغتين بلا عوائق ثقافية تتعدى اللغة وحمولاتها التعبيرية.
الشعر ينتصر
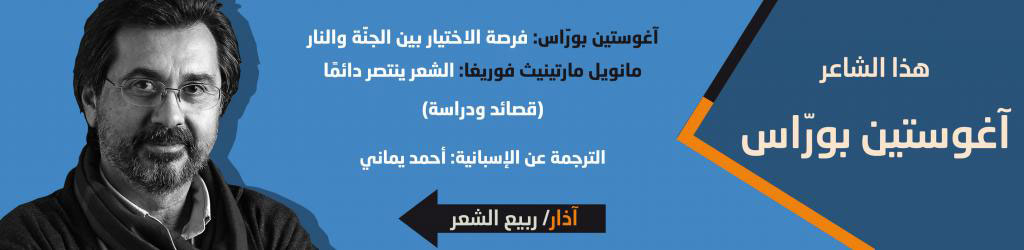
يكشف مانويل مارتينيث فوريجا، في دراسته، أن الشاعر أغوستين بورّاس المولود في مالقة بإسبانيا عام 1957، ينتمي إلى جيل “ما بعد بالغي الجِدّة”، الذي يضم شعراء ولدوا بين عامي 1956 و1966، ذلك الجيل اللاحق على جيل “بالغي الجدة”، ومعاصر لـ”جيل اللغة” الذي ينتمي إليه مؤلفون ولدوا بين عامي 1945 و1955.
ويشارك بورّاس في التيار الذي يدعو إلى العودة إلى غلبة التزام الشاعر بالواقع، والذاكرة كمصدر رئيسي للإلهام، وتضمين الذات المنهَكة كدليل على تجربتها الغنائية. ومن الناحية الأسلوبية، يعبر الشاعر عن نفسه في لغة دارجة؛ تلجأ من جديد إلى توليف شكل الحكمة المأثور أو، على العكس من ذلك، إلى المسارات الطويلة لشعر النثر التي تخلّت بالفعل عن مفهوم النثر الإيقاعي وارتبطت بالشعر الحر، مما أدى إلى تهجين شكلي يمتد إلى اليوم في الشعر الإسباني.
وعن فيرلينغيتي، الشاعر والكاتب المسرحي والناشر والرسام والنشيط الاجتماعي والسياسي، يقول حسن نجمي “هو، بالتأكيد، أحد أهم أركان حركة جماعة شعراء سان فرانسيسكو (بيتْ جينرايشون)، إِلى جانب غينسبيرغ وكيرواك وغريغوري كورصو وآخرين. لكن على أهميته الشعرية والاجتماعية والثقافية في المشهد الشعري والأدبي الكوني، لم تُترجم بعض كتبه إلا إلى تسع لغات”.
فيرلينغيتي عرَف عنه شغفه اللانهائي بشعر بودلير ونزوعه الروحاني والأخلاقي البوذي الذي تلوح ملامحه في شعره وبياناته الشعرية النارية
ويضيف “يمكن أن نلاحظ أن معظم الذين اهتموا به في العالم أثارهم أساسا شغبه وخطابه الراديكالي المتحمس، والمندفع في مواجهة النظام السياسي لبلاده، وانخراطه في معظم الحركات والتظاهرات الاحتجاجية التي واجهت التوجهات الأَمييكية الرسمية، والنزوع الحربي لبعض القادة الأميركان. وكان الاهتمام بمواقفه وتصريحاته وبياناته غالبا على حساب الاهتمام بنصّه الشعري، وإن بدأنا نلمس مؤخرا بعض الأصوات الشعرية العربية الشابة تتمثل شعريته بل وتستنسخها في بعضِ ما نقرأه لها من قصائد”.
ويتابع نجمي أن فيرلينغيتي عرَف عنه شغفه اللانهائي بشعر بودلير ونزوعه الروحاني والأخلاقي البوذي الذي تلوح ملامحه في شعره وبياناته الشعرية النارية. وهو في أيامه الأخيرة قبل رحيله، قضى معظم وقته في ضيعته على ساحل “البِيغْ سور” معترفا، أخيرا، بأن الإنسانية لم تكن، ولا تزال حتى الآن، غير جاهزة لتقبل بالأفكار “الفوضوية” (الأَنَارْشيا) التي كرَّس لها سنوات وافرة من حياته.
ومع ذلك ليس بإمكان أحد من المهتمين بالحركة الشعرية الأميركية والكونية المعاصرة أن ينكر الدور الهام لهذا الشاعر الكبير (شعرا وسنّا وخبرة جمالية وفكرية) في تحريك سواكن الكتابة الشعرية الإنسانية. ولا تخفى إضافاته النوعية، هو وغينسبيرغ وكيرواك وكورْصو، وحُلفاء آخرون مثل شارل بوكوفسكي، في تثوير اللغة الأدبية وتغيير قاموسها التقليدي الجامد، وفتح الشعر على هوامش الواقع الاجتماعي، والتحولات البنيوية العميقة في الثقافة والفكر والسياسة، واستيعاب معاجم المُهمَّشين البذيئة والوقحة وتوظيف المرجعيات الروحانية الشرقية والمثلية ولغات المدمنين والسكارى، وإيلاء الاعتبار للثقافة السياسية للحركة “الفوضوية” و”خرابها الجميل”.
بهذه الملفات الثلاثة عن الشعر، إلى جانب القصائد الجديدة التي نشرتها “الجديد” للشاعر نوري الجراح تحت عنوان “ندم سقراط”، تفتتح المجلة شهر مارس ليكون شهرا كاملا لربيع الشعر، وتدعو الشعراء العرب والنقاد ومحبي الشعر إلى اعتبار هذا الشهر من كل عام شهرا استثنائيا للاحتفاء بالشعر بوصفه صوت الوجدان الإنساني والبؤرة المركزية للجمال في اللغة العربية وسائر اللغات.
- اقرأ الملف كاملا في العدد الأخير من مجلة "الجديد" الثقافية اللندنية




























