من ينشر الشعر
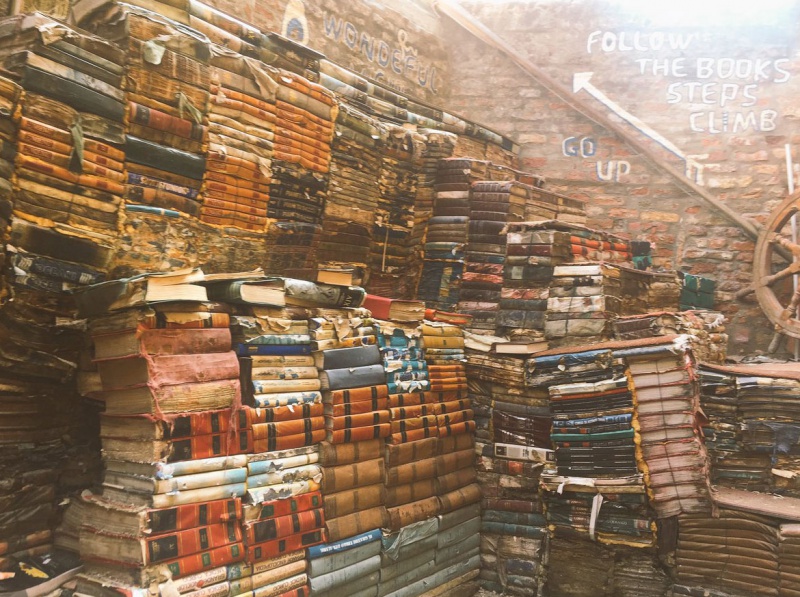
لم يكن غريبا أن تثبت آخر دراسة كنت قد أنجزتها عن وضعية الكتاب بالمغرب كثيرا من المفارقات التي تطبع، بشكل خاص، مجال إنتاج الكتابة الشعرية ونشرها وتداولها. فأي قارئ عادي قد يحس، على الأقل من باب الانطباع، بأن شيئا ما يكدر مشهد الكتابة، وبشكل خاص حضورها وتداولها المحدود ضدا على سيلان الإصدارات الذي لا ينتهي. وقد يكون ذلك جزءا من طبيعة الكتابة الشعرية التي تراهن بشكل أكبر على جانبها الرمزي. وهو الوضع الذي يجعل من المستحيل في كثير من الأحيان أن
نجد أسماء الشعراء ضمن قوائم الأسماء التي جرت العادة أن تعلن عنها وسائل الإعلام على رأس كل سنة، أو أن نجد أعمالا شعرية ضمن لوائح الكتب الأكثر مبيعا المعلَن عنها بشكل منتظم. إنه نفس الوضع الذي يقتضي من الشاعر نفسا طويلا لكي يستطيع تكريس وضعه الاعتباري، وإن كان يندر أن يستطيع الشاعر أن يحقق حوله التوافق عليه من طرف كل النقاد، وخصوصا من طرف الشعراء الذين يبدون في الكثير من الأحيان أكثر تحاملا وقساوة من النقاد.
ولعل أهم المفارقات أن نجد أن أكثر من سبعين في المئة مما يصدر على مستوى الأعمال الشعرية بالمغرب، على سبيل المثال، يتم في إطار النشر على نفقة المؤلف. وهو الوضع الذي يخلّ بحلقات صناعة الكتاب، إذ يتحول الشاعر، الذي من المفروض أن تنتهي وظيفته عند صدور الكتاب، إلى مُدَبر لمبيعاته ومرجوعاته. أما أغلب الشعراء الذين يلجؤون إلى النشر على نفقتهم، فأسبابهم عديدة. فمنهم الشاعر الذي أُغلقت أمامه دور النشر ومنهم من يستعجل الوصول إلى مجد مفترض. ومنهم من يكتفي بطبع بضع نسخ ليحمل لقب شاعر.
أما الأمر المفارق فهو أن الشعراء لا يتعبهم الاستمرار في إصدار أعمال قد تُقرأ أو لا تُقرأ. ولعل ذلك ما تعكسه على سبيل المثال المكتبة الشعرية المغربية. إذ ظلت الأعمال الشعرية تتربع، على الأقل من حيث العدد، قائمة ما صدر بالمغرب على مستوى الأدب خلال القرن العشرين، محتلّة نصف ما صدر، بينما لم تتجاوز نسبة الأعمال الروائية العشرين في المئة.
ولا تتوقف هذه الهيمنة هنا، حيث تكشف آخر ببليوغرافيا تخص الشعر المعاصر المغربي، وهي التي أنجزها الباحث محمد القاسمي عن استمرار الشعر المغربي في تحقيق تراكم كمّي مدهش. إذ تشغل إصداراته خلال السنوات الست الأخيرة أكثرَ من ثلث ما نُشر بالمغرب خلال التسعين سنة السابقة.
وقد تجد هذه السيادة الكمية للأعمال الشعرية تفسيرها في عاملين أساسين. يرتبط الأول بوضع الكتابة الشعرية نفسها، باعتبارها جنسا أدبيا يستند على تاريخٍ عريقٍ، حققَ الشعرُ في إطاره تراكما خاصا. وارتبط هذا الحضورُ بوظيفة الشعر النضالية، والترفيهية أحيانا، والتي حكمت وضعَه داخل البنية الاجتماعية التقليدية. وشكلت لحظةُ الحماية، كإطار عام لبداية ظهور نشر الأعمال الشعرية، مجالا لتكريس هذه الوظيفة، حيث مثل الشعر، في إطارها، مجالاً لتكريس الالتحام بين الوعي الوطني والوعي الثقافي، في إطار مواجهة الاستعمار.
بينما يرتبط العامل الثاني بتأخر ظهور الأجناس الأدبية الأخرى، حيث سينتظر المغرب سنوات الأربعينات من القرن الماضي ليرى أعماله الروائية والقصصية والمسرحية الأولى. وهو تأخر ارتبط بمستوى تطور الوعي بالأجناس الأدبية الجديدة، وبسيادة البنية الثقافية المحافظة، والقائمة على تكريس التراث التعبيري التقليدي باعتباره جزءا من هويتها الثقافية.
غير أنه بالرغم من أهمية هذه الأرقام التي تحققها الإصدارات الشعرية، فإنها قد تُخفي وراءها حقيقة قد تبدو صادمة؛ إذ أن أغلب ما يُنشر ينتهي عند عتبة المطابع. وذلك إما بسبب انسحاب أغلب الناشرين من مجال نشر الشعر، وإما لإحجام الموزعين عن ضمان تداول الأعمال الشعرية.
ولعل هذا الوضع لا يهم المغرب فقط، بل يشمل أيضا أغلب الدول العربية وكثيرا من الجغرافيات الثقافية الأجنبية. وإذا كان الحكم على الحالة العربية لا يمكن أن يتم إلا من باب الانطباع لغياب منظومة إحصائية تمكن من حصر مؤشرات الإنتاج الأدبي ومتغيراته، فإن الجغرافيا الأجنبية تمنح صورة أوضح عن هذا الوضع. ولعل فرنسا، على سبيل المثال، تمثّل النموذج الأفضل في هذا السياق. ويكشف تقرير النقابة الوطنية للناشرين الخاص بوضعية الكتاب بفرنسا، خلال السنتين الأخيرتين، عن كثير من المعطيات الصادمة الخاصة بوضعية نشر الشعر ببلد يحتفي بالقصيدة عبر حياته اليومية وأمكنته وفضاءاته. إذ تصل نسبة كل من المبيعات وأرقام المعاملات التي تحققها الإصدارات الشعرية بالكاد إلى أقل من واحد في المئة من مجمل أرقام الكتاب. وإن كان يبدو مدهشا أن تظل أرقام معاملات الأعمال الأدبية بمختلف أجناسها على رأس صناعة الكتابة، متجاوزة الكتاب المدرسي والإنتاج في مجالات
العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها. ويبدو وضع نشر الشعر بفرنسا في الوقت الراهن مفارقا للتراكم الذي حققه البلد، خصوصا على مستوى بنيات النشر الكبرى التي كانت مواكِبة، خلال عقود، للحركية الشعرية بالبلد. إذ ظلت السلاسل الشعرية حاضرة بقوة ضمن كاتالوجات دور النشر الكبرى. ولعل من أهمها دار أكت سود وميركو دي فرانس. وذلك بالإضافة إلى دار غاليمار المعروفة بسلسلتها الشعرية التي أقفلت نصف قرن من عمرها، محققة نجاحات مذهلة، خصوصا عبر مبيعاتها التي تقارب العشرين مليون نسخة. وسيكون نجاح السلسلة وراء إطلاق شقيقتها، فوليو، الخاصة بالشبان، ابتداء من سبعينات القرن الماضي، والتي تحرص بشكل أساس على تقريب كلاسيكيات الشعر الفرنسي من قراء استثنائيين في سن المراهقة.
مع حلول النت، ستختلط كثير من الأوراق. وإذا كان هذا الوافد الجديد سيفتح إمكانيات مذهلة للتواصل بين الجميع، فإنه في نفس الوقت سيغرق العالم بكائنات افتراضية تنظر إلى نجاح القصيدة من باب عدد اللايكات المجمّعة. دون أن ينفي كل ذلك وجود أصوات حقيقية ما زالت تقاوم من أجل قصيدة رفيعة تليق بلحظتنا الإنسانية غير الرفيعة!




























