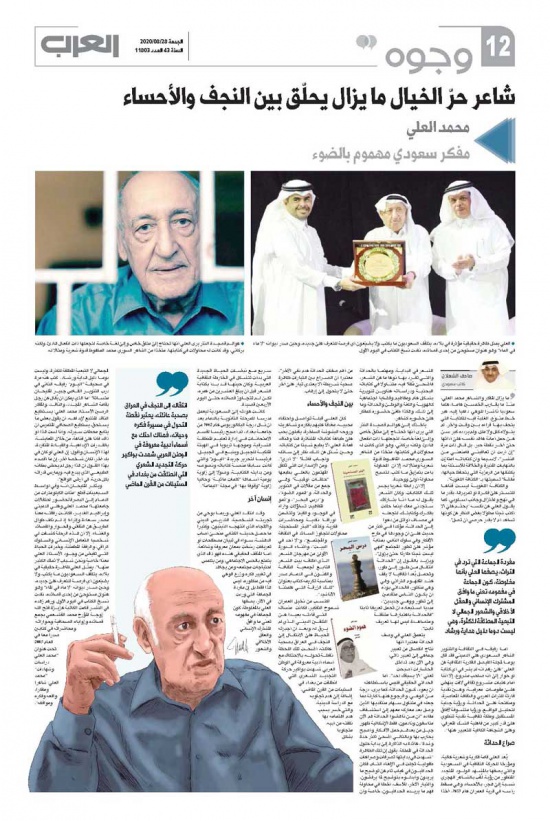مسرحية أردنية تعيد جمهورها إلى الرحم الأول للتخلص من السجن

منذ أن يولد الإنسان وهو محاصر بسجون كثيرة مرئية وغير مرئية من عادات وتقاليد وخرافات وأفكار مسبقة أو متوارثة وغيرها، لكن المعرفة هي الطريق للتحرر من هذه السجون. المعرفة هي الحل للتحرر، لكن لا سبيل لمعرفة لا تبدأ من الجسد، الجسد الذي تلتقي فيه وتبدأ منه أغلب السجون، وهذا ما يفككه العرض الأردني “سجون”.
ضمن العروض المسرحية المتميزة في ذاكرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 27 أونلاين، الذي سيُنظم من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ستُعرض مسرحية “سجون” الأردنية، تأليف مفلح العدوان وإخراج الدكتورة مجد القصص، إلى جانب ثمانية عروض من مصر وروسيا والعراق وإيطاليا وأوكرانيا والنمسا وأذربيجان، سبق أن قُدّمت في الدورتين 20 و22 من المهرجان. وسيكون بإمكان الجمهور مشاهدة هذه العروض على موقع المهرجان و”يوتيوب”.
ويتألف عرض “سجون”، الذي يأتي في وقت عصيب تقبع خلاله البشرية في سجن الوباء الكوني، من لوحات عديدة تمثّل: الميلاد، التكوين، المدرسة والعائلة، اعترافات المجتمع، البراءة والأمل، الأوامر والنواهي، المعرفة التكنولوجية، السجون السياسية، عذابات القبر والنهاية.
فيزيائية الجسد
يجسد العرض، الذي يستثمر “فيزيائية الجسد”، ويرتكز على سيناريو محكم يتصاعد بوعي ورشاقة، عبر هذه اللوحات السجن الذي يرافق الإنسان منذ وجوده داخل الرحم إلى أن يفارق الحياة إلى مثواه أو سجنه الأخير، فهو سجين نشأته وأفكاره وتجاربه ومواهبه وقدراته النوعية، وظروف الحياة الخارجة عن إرادته، وعجز اختياراته الظاهرية، التي تحكم باطنها فروض إجبارية.
تتوالى اللوحات المشهدية، التي يؤديها ثمانية ممثلين وممثلات (أحمد الصمادي، أريج الجبور، سارة الحاج، عبير عواد، لارا صوالحة، محمد عوض، موسى السطري ونبيل سمور)، وتتوالى معها السجون، بالإيقاع نفسه: سجن السياسة، وسجن الاحتلال الذي يمارس سطوته فيقهر الشعوب الضعيفة ويسحق أحلامها، سجن الأسرة والعلاقة المرتبكة بين أفرادها، سجن المدرسة والقمع الذي يمارسه الأستاذ على الطالب، سجن الأنوثة الذي تشيده السلطة الذكورية. ثم يبدأ السجان (أديب درهلي) رواية تفاصيل سجنه، كاشفا أنه الوحيد الذي يملك المفاتيح التي تحرر الآخرين من سجونهم، ومحرّضا الجميع على البوح الذي هو الطريق الوحيدة للخلاص، وكسر جدران الصمت.

وفي تلك اللحظات، يتململ الجميع ويحاول كل منهم العثور على مفتاحه بالحديث عن معاناته، وتقديم اعترافاته، فيلتقي الطفل والشاب والشيخ، ساعين إلى شق الجدار وتمزيق الأغلال، كي يجد النور طريقه إليهم.
تمتد اللوحات الوجودية، وينكمش الحوار، الذي عملت المخرجة على تشظيته وتوزيعه على الشخصيات الثماني، إلى أقصى درجة لتحل محله مشاهد بصرية شديدة الإبهار، يتضافر فيها الرقص الحديث مع التعبير الجسدي، أو الكوريغرافي (تصميم دينا أبوحمدان)، والموسيقى، ومؤثرات الصوت والغناء (للمؤلف الموسيقي وسام قطاونة)، في مزج متقن، يخاطب العقل والقلب، وتبعث التكوينات الخلابة فيضا من التساؤلات حول الحس الفني الثري، والإدراك العميق لمفهوم المسرح، كفكر وفن ومتعة.
ويأخذنا التشكيل السينوغرافي (تصميم جميلة علاءالدين) في العمق إلى واقع رمادي غائم يوحي بالبرودة والغياب، فالقضبان تشاغب مفاهيم القيد، والجدران والحوائط والمرايا كلها سجون، وعناق الضوء مع الصوت يأخذنا إلى الأجساد المعذبة بصراعات الميلاد والحياة، وتظل وجوه الممثلين، التي تحولت إلى ماسكات متحركة، تكشف عن اشتباك الجنس بالغرائز والرغبات الوحشية، وحين تتسع الأغلفة وينتصر الإنسان على قيده الأول ويخرج من سجن العدم، نعايش إيقاعات الوجود ويتحول فضاء العرض إلى مجال يموج بالضوء والحركة والبحث والعذاب، ونرى الشخصيات وهي مكبلة بالسلاسل، حيث عذابات الواقع والكلمات والأسرار والدم المسفوح وانهيارات القيم، وتمتد مؤثرات الصوت لترتبط بإيقاعات الحركة الحديثة، وتكشف الحوارات القصيرة الساخنة عن الإنسان عندما يصنع تابوهاته.
عناق الضوء مع الصوت يأخذنا إلى الأجساد المعذبة بصراعات الميلاد والحياة بينما وجوه الممثلين ماسكات متحركة
وبهدف وضع المتلقي في أجواء السجن، استخدمت المخرجة مجد القصص مفردة الإيقاع (محمد طه)، التي هي “لغة التخاطب في السجون، فالطرقة الواحدة مثلا تعني حرف الألف، والطرقتان حرف الباء..”، كما استخدمت المرآة التي سببت للحضور انزعاجا غير خاف، لكن عن قصد، لتجعل المتلقي يعيش، ولو للحظات، معاناة السجناء وهم يتعرضون لضوء الكشافات الباهر الذي يُفقدهم القدرة على الإبصار.
حضور نسوي
في جانب من العرض يلحظ المتلقي حضورا نسويا واضحا في صياغة رؤيته ومشاهده، يمكن أن يأخذنا، كما يرى الناقد نزيه أبونضال، إلى عالم الرحم حيث الجسد أسير بحبل السرّة في سجنه الأول، فتبدأ الرغبة الإنسانية بمحاولات الانعتاق، ويعلو الصراخ بالضغط على الجدران والأغلفة بحثا عن كوة عبور نحو الحرية والحياة.
لكن الشخصيات تظل في النهاية على الأرض أسيرة سجونها تجرجر قيود عبوديتها، فحبل السرّة لم يقطع، بل كان ذلك وهما، إلا إذا تمردت على الراوي والسجان “لا بد أن يكون هناك خيار آخر، لم تنته الأسئلة ومازالت الأجوبة. ذلك الثقب الذي فتحناه في الجدار أصبح كوة ثم أصبح هوة. بدأنا بقصيدة لدرويش ‘آه ما أقسى الجدار/ عندما ينهض في وجه الشروق/ ربما ننفق كل العمر كي تثقب ثغرة/ كي يمر النور للأجيال مرة'”، رغم أن الراوي لا يحتكر الحقيقة، بل يتيح للجميع أن يتقاسموها، لذا تتوزع الحوارات بين الممثلين، شهودا وضحايا، ويرسم كل منهم صورة لعلاقته بالسجون. أما المرأة المولودة والموؤودة سلفا فعليها أن تتمرد بشروط أقسى ضد السلطة البطرياركية للذكر.