المهمّشون فاكهة متون السّرد العربي

تتنوع مجالات الرواية العربية وتياراتها وأساليبها التعبيرية منذ نشوئها بشكلها الفني الحديث قبل أكثر من مئة عام حتى يومنا هذا، لكنها دائمًا على اختلاف مذاهبها مشغولة بشكل أو بآخر بالإنسان المنغمس حتى النخاع في صراعاته المتعددة داخل مجتمع مليء بالتناقضات، وهو ما جعل المهمشين فاكهة للكتابة.
في نظرتها الشاملة إلى ما يجري في معترك الحياة، تلتفت الرواية العربية أكثر ما تلتفت في نماذجها المهمة عبر الأجيال إلى طبقات المنسيّين والمهمّشين والفقراء والمقهورين، فهؤلاء هم ملح الأرض والسرد معًا.
الأبطال العاديون والبسطاء والمأزومون، هم الأجدر إبداعيًّا بالتشخيص، والأقدر على تمثيل التاريخ الحقيقي والواقع البشري المعيش من وجهة نظر المؤلفين، الذين يخالفون في هذه المسألة المؤرّخين المُعتَمَدين، المعنيين عادة بالأحداث الكبرى وما تُمليه إرادة القادة والزعماء وذوي النفوذ والوجاهة والمال وجوقة المنتصرين والمنتفعين.
فاكهة الكتابة
لم تكن الرواية لتبلغ هذه المنزلة المتفوقة والتأثير الملموس بين الآداب والفنون الحديثة لولا عنايتها المحورية بالصراع، وقد اعتبر البعض مثل جورج لوكاتش أنها اللون الأدبي الأكثر نموذجية في المجتمعات البرجوازية بسبب قدرتها على تقصّي التناقضات الاجتماعية والطبقية وتعريتها بجسارة، وذهب هيغل إلى أفضلية الرواية عن الشعر في تعيين الوقائع اليومية وتطورات الحياة الجديدة بكل ما فيها من تشابكات.
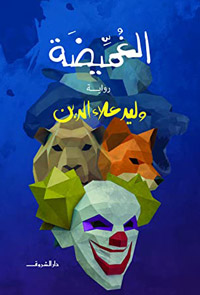
ومهما تعددت أشكال الرواية بين واقعية وتاريخية وبوليسية وسياسية وفانتازية وغيرها، ومهما بلغت الرواية الحديثة من التجريب في خلطاتها النفسية والسحرية المثيرة، فإنها إن أعادت النظر إلى بعض عناصرها ومقوّماتها الأساسية مثل الشخصيات المتعددة والزمان والمكان والحكاية والأحداث المتصاعدة والحبكة وغيرها، يصعب أن تتخلى عن الصراع، على أي مستوى من المستويات، حتى بين الفرد وذاته في أبعاده المركّبة. وفي مرايا هذا الصراع الدائر تحضر عادة توتراتُ الخلخلة المجتمعية، التي لا ينفصل عنها الفرد أبدًا حتى في عزلته.
وسط هذه التناقضات والانقسامات والصراعات التي وجدت الرواية العربية فيها ضالتها لنسج قماشتها الثرية، يحتلّ المهمّشون والحرافيش والفقراء والمقهورون والمنفيّون خارج الحياة أدوارًا محورية بين فئات المجتمع في أعمال المبدعين النابهين حتى يومنا هذا.
هكذا هي الرواية منذ الكلاسيكيات الواقعية لنجيب محفوظ، مرورًا بالتجارب التالية مثل حنا مينة ويوسف إدريس وإميل حبيبي، وجيل الوسط مثل خيري شلبي وجمال الغيطاني ومحمد البساطي وإبراهيم أصلان ويحيى الطاهر عبدالله، وصولًا إلى الأجيال الراهنة، مثل إبراهيم عبدالمجيد وصنع الله إبراهيم ومحمد المخزنجي وإبراهيم نصرالله، وكتابات الأجيال الأحدث والمبدعين الشباب.
إن البسطاء هم فاكهة الأجيال الروائية المتتالية بلا منازع، وهم ليسوا مجرد طبقة أو فئة تتصارع مع الفئات والطبقات الاجتماعية الأخرى، وإنما اتخذهم الروائيون نافذة لرسم صورة المجتمعات العربية ككل، من خلال علاقات هؤلاء المهمّشين ببعضهم البعض، وعلاقات الآخرين بهم.
ويعد نجيب محفوظ أبرز الروائيين الذين رسموا خرائط للمجتمع المصري من خلال المهمّشين وتفاعلاتهم الدالّة الرامزة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في أعمال من قبيل “الحرافيش”، “اللص والكلاب”، “زقاق المدق”، “الثلاثية”، وغيرها.
واقترنت أسماء روائيين بـ”الصعاليك” بشكل مباشر، وعلى رأسهم خيري شلبي الملقّب بنصير المهمّشين والفقراء، حيث تناول باستفاضة تشريح المجتمع المصري في المدينة والقرية من خلال تقصّي حياة المهمشين والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت عبر الزمن، كما في أعماله “وكالة عطية” و”منامات عم أحمد السماك” و”الأوباش”، وغيرها.
منهم كذلك جمال الغيطاني في بعض أعماله مثل “الزيني بركات”، التي صاغت التاريخ من “الهامش الشعبي” وعالم البصاصين، وليس من التدوين الرسمي للأحداث، فالتاريخ هو ما يتناقله الناس ويحفظونه في قلوبهم، وليس بالضرورة أن يتضمن الأحداث الرسمية العريضة التي تُرضي السلاطين والحكّام.
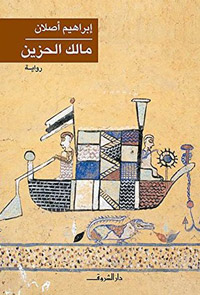
والتقط محمد البساطي في أعماله مثل “صخب البحيرة” تفاصيل حياة البسطاء والمهّمشين، ومنهم الصيّادون على القوارب الفقيرة، متخذًا من هذه العوالم معبرًا إلى الجوهر الإنساني الصادق النبيل، في صراعه مع الإفرازات المادية للعصر الاستهلاكي، بحس شعري استشفافي.
وإلى هؤلاء انحاز إبراهيم أصلان في مجمل أعماله، وأشهرها “مالك الحزين”، وهي سرديات لخّصت أحوال المجتمع بكل ما يكابده من تمزق وعبثية وتكريس للطبقية بما تعنيه للكثيرين من فقر وانهزامية وانسحاق.
ولم تتخلّ التجارب الروائية المعاصرة والراهنة والشابّة عن إبراز فئات المهمّشين والمنسيين للقبض على الحالة المجتمعية ككل في تناقضاتها وصراعاتها وتوتراتها، وتتعدد الرؤى وطرائق التعبير بتنوع الاتجاهات الروائية وتطور تقنياتها عبر الزمن.
تحت مظلة الفانتازيا، يقدم إبراهيم عبدالمجيد في رواية “السايكلوب” فئات المهمّشين وقد ابتلعها القهر والبؤس والعجز والكبت وسائر الأزمات التي رمز لها بـ”السايكلوب” أو الوحش الأسطوري المفترس، وفق الميثولوجيا الإغريقية، ثم يتصاعد الخطر ليفتك بكل الطوائف في مجتمع لم يعد هناك أمل في إصلاحه وانتشاله من غرقه.
ويستعيد صنع الله إبراهيم في روايته “1970” شخصية جمال عبدالناصر والمحيطين به، روائيًّا وإنسانيًّا، وينجو السارد من التاريخي والسياسي المعروف ليصوّر خلجات البسطاء والعاديين الذين تعلقت آمالهم في ذلك الوقت بالزعيم المصري الراحل.
ويستخدم وليد علاءالدين في روايته “الغمّيضة” لعبة الاستغماية الطفولية للخوض في أجواء عجائبية يتقصى خلالها فئات من المهمّشين مثل المهرّجين ولاعبي السيرك وغيرهم ممن يعيشون على هامش الحياة الطبيعية، ويتضح أنهم قد يكونون أكثر تفهمًا لحقيقة الحياة شرط تخليهم عن أقنعتهم ومساحيق وجوههم.
من خلال لعبة السينما، والخلط بين الحقيقي والمتخيل، تمضي منال السيد في روايتها “غنا المجاذيب” نحو تشخيص أحوال الفقراء المنغمسين بأرواحهم وأجسادهم في التراب القاهري الخانق للأحلام والطموحات. ومن الهامش أيضًا، تستحضر سعاد سليمان في روايتها “هبات ساخنة” ثوّار الظل الذين شاركوا في ثورة يناير 2011، لكنهم لم يتمكنوا من تنسّم هواء الحرية في واقع يحكمه ميراث شديد القسوة والعنف.
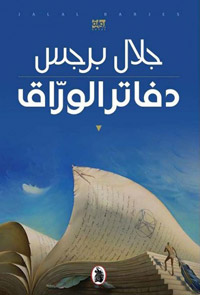
ويمضي الأردني صبحي فحماوي إلى “قاع البلد” في روايته التي تحمل هذا العنوان، مصوّرًا حياة “القاع” بالمعنى الحقيقي والرمزي في مدينة عمّان وما حولها بعد نكسة 1967، بأسلوب دراماتيكي جاذب.
ويتقصى الأردني جلال برجس في “دفاتر الورق” الهزائم والإحباطات المتتالية للمهمّشين في عصر بات يلفظهم تمامًا، بالقدر الذي يتبرأ فيه أيضًا من الثقافة والكتب، ما يعني فقدان البوصلة وغياب الخارطة وانحدار الوطن إلى الهاوية.
نحو تهميش آخر يعني الأقليات المضطهدة، تقصّ العراقية دنيا ميخائيل مآسي الهاربين من جحيم تنظيم داعش الإرهابي في روايتها “وشم الطائر”، التي تترصد فيها معاناة الإيزيديين ذوي الأصول الكردية من ممارسات داعش إزاء المدن والقرى العراقية. وهنا، يصير استحضار الهامش بمثابة إعادة كتابة لمتن التاريخ وفق رؤية فنية وواقعية في آن.
الوجه الآخر
حسب الناقد والكاتب مصطفى عطية جمعة، فإن السارد العربي قد نجح في تقديم المجتمع بكافة فئاته وشرائحه الاجتماعية من خلال تعاطف الرواية مع المهمّشين، وما أكثرهم، في المجتمعات العربية، فهم القانعون بحياتهم، الراضون بما قسمه الله لهم، الفرحون بأي عطاء، المتعطشون لأي بشارة.
ويوضح عطية لـ”العرب” أنه عند قراءة تاريخ الرواية العربية في ضوء تمثيل فئات المهمشين فيها، فإننا سنجد أنها حضرت في كافة مراحل الرواية منذ نشوئها، ثم استوائها، انتهاء بنضجها وتميزها، لأن المهمشين هم الوجه الآخر للمجتمع، سواء كان مجتمع النخبة أو الجماهير، مجتمع المثقفين أو العامة، مجتمع السلطة أو الأتباع، فهم دائمًا يحضرون على هامش المجتمع.
نرى هؤلاء جميعًا خدمًا أو فقراء متسولين، أو أطفالًا مشردين، كما صوّرهم نجيب محفوظ في رواياته؛ أو فتيات ليل وخادمات ذليلات ونسوة عانين شظف العيش وتحملن قسوة الحياة ومهانتها من أجل أطفالهن كما نقرأ في سرديات يوسف إدريس وضياء الشرقاوي ويحيي الطاهر عبدالله، أو نجد أسرًا تعيش في أحزمة الفقر حول المدن العربية كما في روايات إميل حبيبي وحنا مينة وإبراهيم نصرالله، أو فهم يعانون من تسلط الأغنياء ملّاك الأراضي في القرى العربية كما في رواية “الأرض” للكاتب عبدالرحمن الشرقاوي وأعمال يوسف القعيد.
عند قراءة تاريخ الرواية العربية سنجد أن المهمشين حضروا في كافة مراحلها منذ نشوئها واستوائها انتهاء بنضجها
كذلك، فهم أبناء الصحراء الذين لم ترحمهم قفار البيئة وجفافها، فتنقلوا في جنباتها، بأحلام بسيطة تتمثل في آبار تتدفق بالماء، ونخيل يلقي بالتمر، وخيام تحميهم من الرياح الحادة المحملة بالرمال الساخنة، كما نرى في روايات إبراهيم الكوني وعبدالرحمن منيف وصبري موسى.
ويؤكد عطية أنها كلها تمثيلات سردية تكاد تنحصر في البعد الاجتماعي والمعيشي، وإن تطورت بعد ذلك، لتتسع دائرة المهمشين وتكتسب دلالات جديدة، فهي الفئات التي تعرضت للقمع والتهميش السياسي، أو لكون هؤلاء أقليات تخالف توجهات الدولة القومية مثل الأكراد في سوريا والعراق، والأمازيغ في المغرب العربي، والمهجرين في الصومال والسودان وموريتانيا، ليختلط الهمّ السياسي مع تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، فمن المهم دراسة مفهوم المهمشين برؤية أكثر رحابة، قوامها كل فئة أو جماعة أو شخص افتقد حقوقه في الحياة والإنسانية بكافة استحقاقاتها.




























