السورية لينا شدود: أدب هذه المرحلة سيكون مهزوزا

بعيدا عن التقسيم الجنسي بين امرأة ورجل، يلغي الشعر المعاصر الحدود الوهمية، كما يغيّر موقع الشاعر من الممتلك لكل خيوط النص، إلى مساهم فيه، حيث ابتعدنا شيئا فشيئا عن الغنائية والإفراط في الذاتية المغلقة. في حديث حول الشعراء والشعر وترجماتهم، كان لـ”العرب” هذا الحوار مع الشاعرة والمترجمة السورية لينا شدود.
اختارت الشاعرة والمترجمة السورية لينا شدود، أن تمكث في الضدّ، وتشاكس المشهد القائم بكتابات حداثية وطّدت اسمها في حركة قصيدة النثر، وترجمات مختارة بعناية نقلت بها إلى المشرق تجارب الهايكو في الشعر الغربي لدى الأميركي جاك كيرواك وغيره. وتصدر لها قريبًا ترجمة جديدة لقطوف من الشعر العالمي بعنوان “أَرني وجهك”.
تنحاز شدود لقدرة الشعر على جمع المتناقضات، والمواءمة بين العقل والحدس، ففي الشعر نمشي ببطء ونحن نرقب العالم من حولنا، فيُبقينا يقظين، ويقينا من التلوث، حاثًّا إيّانا على البقاء، وربما في عصور سابقة، كان هذا الشعر يحمينا من أي شكل من أشكال الاستعباد، ويبارك ولاداتنا المُتكررة كي نزداد إنسانية.
وإذا كان ما يجري من حولنا مؤلمًا وغير قابل للتوصيف، فقد سعت صاحبة المجموعات الشعرية المهمة “لما استقبلني الماء”، “لستُ أنا.. هذا شبحي”، “من قلب العالم.. من عالم بلا قلب”، وغيرها، إلى استعادة أطياف كائن الشعر قبل انقراضه، وفي دواوينها تؤمن القصيدة بأن طوفانًا قريبًا سيجرف كل هذا السواد، وعلى الأرجح كائنات استثنائية فقط ستنجو، لتبدأ من جديد، وهذه الأرض تستحق.
تردّي الأوضاع
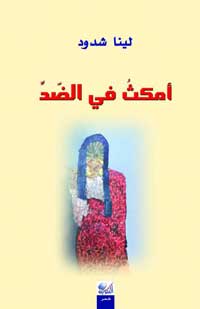
كغيرها من الشعراء والمبدعين والنقّاد، كانت لينا شدود متحمسة لإطلاق التسميات والتعريفات المختلفة للشعر، والاطلاع على ما أورده الأوائل من آراء وتوصيفات، وكانت تظن أنها قد وجدته وحددت ماهيته، وبدأتْ تعتقد أنها قادرة على وضع نظريات ترفد ما سبق.
وتشير شدود في حوارها مع “العرب”، إلى أنها بعد إنجاز خمس مجموعات شعرية، تجد الأمور قد تغيرت إلى حدّ بعيد، فلم تعد مشغولة بأي تعريف، حتى أنها لم تعد تقرأ ما يدبجه الشعراء عن تجاربهم، ولا تعيد التنقيب في كتاباتها السابقة بغرض التنقيح.
ترك تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية آثاره الدرامية على الجميع، كأن المستجدات الراهنة هي من يضع للشعر خططه وشروط استمراريته، والأكيد أن الشعر الآن عاجز عن مقاومة كل التحديّات المستجدة، طالما هو ابن بيئته، وليس بمقدوره العوم وحيدًا في مياه لم تعد تخصّه، وإن كانت الأنهار لا تزال تتمنى إطفاء قسوة الوجود.
إن هشاشة الحاضر وقتامته أفرزتا حالات لا يستهان بها من الشرود والإحباط، بالإضافة إلى بروز أزمة فايروس كورونا، التي لا تدرك الشاعرة أننا ضحايا ما يُخطط لهذا الكوكب، وما سيلحق به من أزمات صحية وسياسية واقتصادية، وبالتالي كل ما يُكتب من شعر وغيره من صنوف الأدب لن يكون بخير، لأننا نحن لسنا بخير.
بمقدور الإنسان أن يحتمل ما يجري في دائرته الضيقة، أو حتى بلده، من أخبار موت الأصدقاء والغرباء والكوارث المحلية، لكن أن يطلع على خراب هذا العالم بأكمله، فهذا فوق طاقة الإنسان العادي.
لقد زادت سيطرة التكنولوجيا من غربة الإنسان، وقنّنت من ظهوره الواقعي، وعليه فإن النتاج الإنساني من آداب وفنون تغلب عليه حالات من عدم الصدق والانسجام وكما تقول شدود: “أيتها النوافذ/ أيتها الأبواب/ ما أجمل الخروج منكِ/ ما أجمل الخروج عليكِ/ لن أفسّر لهم.. لن أفسر لكَ.. ارتطام النيازك لصالح النبوءة القديمة/ الرهان على قارّة نادرة/ يشبه طمع الغابة بخضرة أكثر حنكة/ أنا وأنتَ تأخّرنا في الخروج من الجلد/ لن نعرف كيف نعود”.
قيود النساء والمجتمع
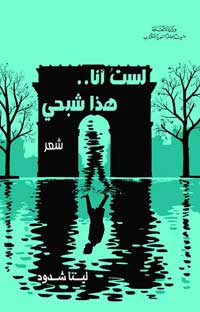
تعتقد لينا شدود أن ما منحه لنا العصر الرقمي من امتيازات ودعم واطلاع وانتشار، أخذ مقابله ما لا طاقة للإنسان على تعويضه من هدر للوقت، بأسرنا وتقييدنا إلى شبكة عنكبوتية لا ترحم بما تطرحه لنا، وبشروطها، التي ما فتئت تخلق المزيد والمزيد من الحواجز.
وتتساءل “من سيداوينا من الأذيات النفسية التي ألمّت بالغالبية، حتى أنك تكاد تشعر بأن البعض ممن رحلوا عن عالمنا قد كانوا على الشبكة ينقلون آلامهم وكل ما ينغصّهم في بث حي ومباشر”.
ولا يلغي تطور المجتمعات الظاهري وجود المعوقات التي تضغط على كل مفاصل الحياة، ولا تسمح حتى للإنجازات الحقيقية الفاعلة بالعمل من أجل التغيير.
وتقول الشاعرة السورية في حوارها مع “العرب”: “مجتمعاتنا ضعيفة، ونساؤنا محبطات ومقيّدات، والأقلام الفاعلة نادرة أو مُغيّبة، والأطفال يعانون من سوء التغدية والمستوى التعليمي بشكل عام مربك وعاجز”.
إن وجود نساء قويات وشاعرات ناجحات هنا وهناك غير كافٍ لإحداث التغيير الحقيقي المنشود، فكل ما يتم إنجازه من أعمال عظيمة أو عادية مساهمات خجولة وضعيفة، ويترتّب علينا إبراز الأمور كما هي وعدم المبالغة بذكر الإنجازات الوهمية لنكون على بيّنة من كمّ الجهد والوقت الذي نحتاجه للوصول إلى ما نبتغيه.
ولا تعترف شدود بدلالة الكتابة النسوية، ولا تظن أن الشعر يتحمل ثنائية الذكوري والأنثوي، فالإبداع هو حساسية الإنسان الخاصة ورؤاه وأفكاره وما يحدس به.
وتؤكد صاحبة “أمكث في الضد” أن الحاضر السوري كغيره على امتداد البلدان العربية، مثقل بالضغوط والعوائق والإحباطات اللامتناهية، حتى أن مفردات كالأمل والعزيمة والمقدرة باتت مُفرغة من معانيها، حيث إن قتامة ما يجري ذهبت بالجميع إلى مكان اللاعودة، وفقدان واضح للأمل على المدى المنظور.
يدور نتاج لينا شدود في فلك التوتر والتشكّك، والانشغال بأحوال المنسيين والمهمّشين الواقفين على حدود عالم لم ولن ينصفهم، وهنا يأتي الشعر ذاته عاجزًا ومرتبكًا ولا حلول لديه “لا شك في أن الشاعر حالم كبير، لكن ماذا لو فقد قدرته على الحلم والرجوع إلى أحلام يقظته الحافلة بطفولات أسطورية ليستقي منها مادته الخام الشعرية”.
وتسأل الشاعرة السورية التي شهدت بلادها انتفاضات وحروبًا وانقسامات وأحداثًا لاهبة “كيف لحالة الحجر المجتمعي الذي عايشناه أن تثمر أدبًا مميزًا، بل على العكس، أدب هذه المرحلة سيكون مهزوزًا، خائفًا، وغير ملهم، بما أن مجمله قد كُتب ما بين جدران تغذي مخاوفنا، وتضنّ بالأوكسجين الضروري للإبداع”.
وترجّح لينا شدود اختلاف ما تنتوي كتابته مستقبلًا، بمعنى أنها لن تكون رقيبًا قاسيًا، بل ستجرّب منح كلماتها مساحات كافية من الحرية والعفوية، إذ لم تعد مشغولة بتحقيق شروط النص المدهش والغنيّ، فما أنجزته من قبل كان نتاج فترة زمنية لا تشبه ما نعيشه الآن، ولا يمكن استحضارها.
نافذة الترجمة
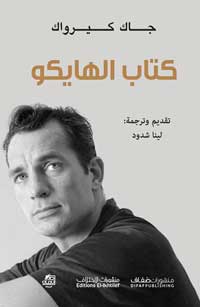
في الترجمة، الأمر مختلف تمامًا، مثلما تتصور شدود، فأنت “تختار النص الأقرب إليك، ومن ثم تحاول أن تمنحه ما يستحق من جهد. هو ليس نصّك، ولكنك بطريقة ما تشعر بأنك مرتبط به بل ويعنيك. الترجمة تجعلك شريكًا لكاتب لا يعرفك، لكن يكفي أنك أنت تعلم بوجوده في هذا العالم، ونصّه منحك الفرصة للوصول إلى عوالمه الخاصة به. الترجمة نافذة سحرية لشراكة مع مؤلفين باتساع العالم”.
ويبقى الانتقاء الدقيق مفتاحًا وكلمة سر لنجاح المترجم، فما الذي يُغري المترجم بقراءة شاعر ما، ونقله إلى العربية، هل هي رؤيته المغايرة التي تزيد من ثراء تجربته وفرادتها بما تحمله من إشارات فلسفية وفكرية وجمالية، أم دأبه على كتابة شعر مسكون بهواجس الاكتشاف ومشاكسة الواقع المحسوس واللامحسوس، ونبذه للوصايا التي هي ضد الوعي.
كل ما تقدّم، برأي لينا شدود، يقود الشاعر إلى انتقاء المفردات النافرة، التي تنجح في تبديل لون الجلد وربما الأرض أيضًا، بعمليات تحاكي إلى حدٍّ بعيد ظاهرتي الحت والتعرية.
وهكذا، لم يعد أمامك أيها القارئ سوى التحديق في عين الشاعر المُبْهَمة والمُتهِمة أو المُنْصفة للشعر سواء في انكساراته أو انتصاراته، والاحتفاء معه حتى لا يضيق صدر العالم في حال خفت صوت الشعر يومًا.

وحين يختار الشاعر خط الأفق لإطلاق صرخته المدويّة أو الخافتة في وجه العالم، حتمًا ستأتي قصيدته كقدر لا مفرّ منه، وسيتجلّى ما يقترحه لنا كلمعة برق قادرة على إيقاظ أرواحنا، فنأخذ كل ما يقوله لنا على محمل الجدّ، حتى أننا نكاد نحدس بما يحدس به كنوع من التماهي فننتصر له كما ينتصر بنا، وكلّما تمكّن الشاعر من تبديد عجزنا نغدو كمعجزاته المتنقلة هنا وهناك.
ولن ترضي القارئ الحصيف المطلع على التجارب المحلية والعالمية، قراءة شعر حالم ومستكين لكل ما حوله، ثمة أمور أخرى صار يبحث عنها القارئ في الشعر، كالحداثة والندرة والتمرد على الذات والأسلاف معًا، بعيدًا عن السذاحة المنفّرة المهيمنة على غالبية ما يُنشر حاليًا من أعمال.
وتقول شدود “لسنا مضطرين للاعتراف بالمقدسات الشعرية المطروحة على الساحة، سواء كانت قصيدة نثر أو غيرها من الأشكال الشعرية المتداولة، ما تبقى هو ما لا أحد ينكره من تبجيل وعرفان لأعمال أحببناها ولها ذلك المكان الحميم في الذاكرة، لكن بعيدًا عن متاهات التقديس والخلود”.
وتختتم لينا شدود حوارها مع “العرب” مؤكدة أن هناك فروقًا كثيرة بين رؤية إنسان وآخر لقضية ما، وفي حال الكتابة، يعوّل الكاتب على ذاكرته المكتظّة بأحداث وأخيلة، حيث يجهد في إعادة سردها مرات عدة دون الانزلاق إلى فخّ التكرار والنمطية، فهذا الفخ هو الموت الذي يسعى الشعر إلى الخلاص من عدميته، ربما بموت أرحم.




























