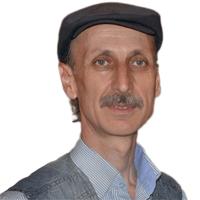فيلم تجريبي سوري يُقحم حياة النحل في مصائر البشر

يقدّم بعض السينمائيين مشاريع سينمائية تحتوي على مفاهيم تجريبية، يخوضون بها تجارب حياتية غريبة قد لا تحقّق جماهيرية كبيرة، لكنها بالتأكيد تستعرض وجبة سينمائية فكرية ذات قيمة تهتم بها شرائح فنية وتنظم لها العديد من المهرجانات والفعاليات. من هذه الأفلام تجربة قدّمها السينمائي السوري سوار زركلي بحث من خلالها موضوعات إنسانية هامة أقام فيها تقاطعا بين حياة الناس وحياة النحل.
دمشق - كما في الموسيقى، حيث يقدّم العازفون ارتجالات بعيدة عن إيقاع محدّد أو جملة مؤلفة واضحة المعالم والمقامات، ينزع فيلم “هناك قصص كثيرة عن النحل” الذي قدّمه المخرج السوري سوار زركلي في ثاني أفلامه الروائية القصيرة الذي تنتجها له المؤسسة العامة للسينما، نحو هذا التمشي، وهو الفيلم الثاني له بعد فيلم “خبرني يا طير” عام 2008 من بطولة جهاد سعد الذي نال عنه جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة السادسة عشرة في مهرجان دمشق السينمائي وجائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان ترايبيكا السينمائي في الدوحة عام 2010.
وفي فيلمه الجديد الذي كتبه فراس محمد يقدّم زركلي عالما سرياليا غريبا يظهر فيه خطان رئيسيان عن شخصين. أحدهما نحال (فراس محمد) يلبس الأبيض ويمسك بيده المدخنة التي تنفث الدخان على النحل في خلاياه عندما يريد التعامل معها، بينما يظهر شخص آخر يلبس الأسود (حازم زيدان) ويمسك بكاميرا يدوية كما المدخنة تماما ليدور بها في الشوارع سائلا الناس بعض الأسئلة عن الحياة والنحل والزواج.
سؤال إشكالي
الفيلم يحمل في عمقه ثيمة الصراع بين الخير والشر والحياة والموت في جدلية فكرية تربط بين عالمي النحل والإنسان
يحمل الفيلم في عمقه ثيمة الصراع بين الخير والشر والحياة والموت في جدلية فكرية فريدة من خلال تجربة شديدة الذاتية، يقدّم فيها زركلي جملة من المتناقضات الحياتية التي توجد لها مساحات دلالية في فيلمه. فالنحال عادة ما يلبس اللون الأبيض لكي لا يستثير النحل ويكون شرسا في التعامل معه ممّا يعرّضه لخطر لسعاته، فاللون الأبيض حيادي ومسالم بالنسبة إلى النحل.
لكن الفيلم يبدأ من نقطة استفزازية حيث يوجّه سؤالا للآخرين مفاده “هل تستطيع أن تلبس الأسود وتدخل على النحل؟”، دافعا بالمتلقي إلى مسار مغامرة فنية غير معروفة النتائج من خلال طرح موضوع حياتي صميم بطريقة إشكالية. تظهر في الفيلم لقطات لخلايا النحل وهي منهمكة بالعمل، بينما يظهر النحال ممسكا بالمدخنة والمصوّر بالكاميرا وهو يتابع الناس في الشوارع، في تقاطع مونتاجي يُظهر خلايا النحل مع مشاهد الناس في الشوارع والأبنية السكنية الضخمة التي يقيمون فيها.
اعتمد زركلي في فيلمه على معلومة في عالم النحل تقول بأن خلية النحل تحتوي على الآلاف من العاملات والآلاف من الذكور والقليل من الملكات، واحد من الذكور سوف يكون زوجا للملكة، بينما الآخرون لا عمل لهم. وهذا ما يدفع العاملات لطرد هؤلاء الذكور لأنهم عبء على حياة الخلية فهم مستهلكون وغير منتجين، وعادة ما يموتون من الجوع أو البرد، حيث لا مكان لهم في مجتمع نشط كمجتمع النحل.
شعبيا يروج مثل محلي في برّ الشام يقول عن الشخص الذي لا فائدة منه أنه كذكر النحل لا يفيد. وهو مفهوم قاربه الفيلم في سؤال ورد فيه “ماذا لو مات الذكور وبقيت النساء؟” سيكون مجتمع نساء. ومعلوم أن الذكر الذي يتزوّج الملكة يموت على الفور.
من هذه الثيمة بالغة الحساسية ينطلق السؤال الأهم في الفيلم الذي يوجهه المصوّر للناس خلال تجواله في الشوارع “هل تعلم أن ذكر النحل يموت بعد الزواج؟”. ويرى زركلي أن “طرح هذه الفكرة التي لها أساس واقعي حياتي لدى النحل هام، لأن لها مدلولات إنسانية عميقة، فحياة الإنسان تتقاطع في جوانب منها مع حياة النحل. فكلاهما يبتغي الاستمرار للمحافظة على البقاء، لكن تفاصيل هذه الحياة وكلفتها تبدوان باهظتين أحيانا. فذكر النحل يواجه مصيرا مأساويا في حياته، وهو ميت لا محالة، فكل الذكور يموتون لأنهم لا يقدّمون عملا، والناجي الوحيد هو من يتزوّج الملكة الذي يموت بدوره بعد الزواج فورا”.
ويتابع المخرج السوري مبيّنا تقاطع ذلك مع الحياة الإنسانية “تكوين أسرة وتأسيس بيت هو من الأحلام الكبرى التي يسعى لها كل إنسان طبيعي، وهذا ما يشكّل حافزا لديه للتوجّه نحوه، لكنّ نمطا محدّدا من الناس الذين يمتلكون هواجس خاصة وأنماطا ذهنية مختلفة غالبا ما ترتبط بالحياة الإبداعية، يواجهون مصائر صادمة في هذا المشروع الحياتي، ويمكن أن يحمل مشروع الزواج لهم متاعب كبيرة، نظرا إلى الطبيعة النفسية والذهنية التي يحملونها، لذلك لا تكون النتائج كما يجب. وتحفل الحياة الزوجية لهؤلاء بالكثير من المطبات والصدامات”.
هواجس تجريبية
الفيلم تجربة سينمائية غريبة الملامح يحمل فكرا تجريبيا والكثير من تفاصيل العمل فيه حملت هذه الروح. ويقول زركلي “صوّرت حوالي عشر ساعات من المادة السينمائية الصالحة للعرض، وكان الفيلم خاضعا لعمليات التعديل بشكل مستمر وعلى امتداد سنوات. قبل أيام قليلة من التصوير لم أكن أعلم ما أريد تصويره في قسم من الفيلم، لكن السؤال الأهم فيه كان واضحا، وهو مبنيّ على تحضير عميق وطويل ومدعّم بأبحاث ودراسات”.
ويضيف لـ”العرب”، “لم أشأ تقديم فيلم اعتيادي، فالفكرة التي تدور في بالنا عميقة وهي تحتاج الكثير من العمل، وبطريقة سردية مختلفة، لذلك صوّرت الكثير، وعندما قمت بالمونتاج أيقنت أنني أمام مسألة صعبة وهي اختيار اللقطات المناسبة التي ستعبّر عن الفكرة التي أريد الوصول إليها. كان حجم المادة مساويا لأضعاف ما أحتاجه في الفيلم، فوضعت العديد من الحالات المونتاجية إلى أن وصلت إلى الحالة النهائية”.
واعتمد الفيلم على وجود حالة من الغرافيك التي رافقت معظم زمنه، وظهرت مؤكّدة لأفكار يُريد المخرج الوصول إليها، فكان حاملا فكريا قدّم حلولا بصرية مساعدة، مشت بالفيلم إلى مكامن قوته، حيث أوجد المخرج لغة بصرية مُربكة رفعت حالة الغموض عن اللقطات العادية حينا ولم تفعل في أحيان أخرى.
والفيلم بالشكل الذي ظهر عليه ومحتواه الفكري وطريقة السرد التي ابتناها، سيكون عصيّا على فهم شريحة كبرى من الجمهور، وهو حال معظم أفلام التجريب.

عن خصوصية هذه الفكرة وخطورة تفاعل الجمهور معها في مرحلة العرض يبيّن زركلي “أحمل هذا الهاجس في فكري فعلا، فالفيلم ليس نمطيا، ولا ينتمي للأفلام التي تقدّم عادة في معالجة المواضيع الاجتماعية، لكنني أعوّل على صدق النوايا لدينا في إيصال هذه الأفكار لعامة الناس بطريقة مختلفة وغير صادمة، أعتقد أن صدق المقولة سوف يكون جسر التواصل مع الجمهور فيه”.
وحمل الفيلم لغة بصرية صرفة، وغاب الحوار لحدوده الدنيا، فمنذ تشكيل اللحظات الأولى فيه، رسم عبر لقطات متنوّعة، بعضها يقدّم للمرة الأولى في تاريخ السينما السورية لغة بصرية خاصة. كما في لقطات الكاميرا الطائرة (درون) التي صوّر بها سقف سوق الحميدية بالعاصمة دمشق، حيث اعتلت الكاميرا سقف السوق وصوّرت ما تحت القبة الحديدية التي تغطيه في لقطات تظهر تجمهر الناس في هذا السوق الشعبي العامر بالحياة وضجيجها. وهي لقطات لم يسبق أن ظهرت في السينما السورية.
وكذلك في لقطات مركز المدينة بالكاميرا الطائرة، حيث صوّر العديد من شوارعها وتقاطعاتها في رمزية تضير إلى التداخل الحياتي بين الناس والنحل. كما رسم الفيلم بمشهدية موظفة مسير النحال في آفاق مختلفة حتى وهو على ضفاف الماء والمصوّر يتبعه بكاميراته، حيث يصلان لمساحات جرداء وهما يرسمان خطواتهما وحيدين، بينما تحوطهما وتقيّدهما علامات الساعة الاثنتي عشرة التي تحاصرهما، ثم يسيران فوق طريق ترابي بين البر والماء مليء بالمطبات التي تظهر في سلسلة لا تنتهي مشكّلة طريقا وعرا أمامهما لا بد من تجاوزه.
واعتمد الفيلم لغة كاميرا متناوبة بين المصوّر ووجهة نظر المتلقي الذي يُشاهد المصوّر وهو يتجوّل في الشوارع بلقطات مختلفة الأحجام، وفي لحظات محدّدة يُشاهد شخوصا من وجهة نظر المصوّر السائل وكانت دائما قريبة وأحيانا قريبة جدا. وهذا ما أعطى الفيلم المزيد من الاختلاف في طريقة تناول المادة المصوّرة وخلق حالة من التشويق المُتناقض بين قبول ورفض لهؤلاء الأشخاص المارين، ممّا يُضاعف رغبة المُشاهد في مُتابعة المزيد.