فوزي سعدالله: يهود الجزائر نشروا موسيقى الأندلس

تزخر الجزائر بتاريخ عريق تتداخل فيه الحضارات والثقافات والأعراق، ما أفرز حضارة ثرية بفنونها ومعمارها. لكن وقع طمس أهم معالم هذه الحضارة مع سنوات الاحتلال الطويلة، التي حاولت تغيير وجه الجزائر بلد الثقافة المتنوعة. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الكاتب والباحث الجزائري فوزي سعدالله الذي قدم بحوثا هامة للثقافة الجزائرية.
الباحث فوزي سعدالله صحافي وكاتب جزائري، عمل في الصحافة الجزائرية، لفت الانتباه بروبرتاجاته وتحقيقاته الميدانية الطريفة التي تتناول الحياة العامة في الجزائر كجذور الموسيقى والعمران، وتاريخ اللباس وأشكاله، والطعام، وغيرها من المواضيع حتى أطلق عليه “حكواتي القصبة”.
اهتم سعدالله بموضوع يهود الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي، وأصدر ثلاثة كتب عنهم “يهود الجزائر•• هؤلاء المجهولون”، و“يهود الجزائر•• موعد الرحيل”، وأخيرا “يهود الجزائر•• مجالس الغناء والطرب”، وعرف عنه اهتمامه الكبير بالتراث الموسيقي الجزائري، وولعه بالتراث الأندلسي حيث نشر كتابا يتناول مسألة الشتات الأندلسي في الجزائر وفي العالم.
يظل تواجد اليهود في الجزائر من أعقد المواضيع التي يحذر الجميع من مقاربتها أو الخوض فيها، لأنها مرتبطة بتاريخ الجزائر العريق، والذي يعرف تجاذبات وصراعات وحقائق مخفية وغامضة ومزيفة وحقيقية، ومع ذلك واجه الكاتب الجزائري فوزي سعدالله الأمر بشغف الباحث المنقب في عمق هذا التاريخ ومفاصله واخترق المجال وقدم مساهمات رائدة في هذا المضمار وأصدر كتابين عن يهود الجزائر عبر التاريخ ومدى ارتباطهم بالأرض وماذا قدموا.
اليهود والأندلس
عن مدى تأثير اليهود على الحياة العامة في الجزائر، يقول الكاتب “في الحقيقة، هم من تأثروا بالأغلبية الساحقة المسلمة وعاداتها وثقافتها بشكل عام وليس العكس”.
وخلال الثورة التحريرية، يقول سعدالله “التحقت بالثورة أقلية يسارية قليلة لم تتجاوز بضع مئات، فيما وقفت نسبة كبيرة منهم مع المحتلين وحاربوا الثورة، لكن هناك فئة هامة أيضا بقيت صامتة إلى أن حسمت الثورة الأمور سنة 1962، فاختارت الرحيل إلى فرنسا واختارت أن تكون فرنسية بإرادتها ولم يطردها أحد عكس ما تروج له الصهيونية وأبواقها الإعلامية والسياسية”.
قادنا الحديث عن اليهود إلى موضوع مهم في مسار الكشف عن تاريخ الجزائريين الذين هاجروا إلى فلسطين حيث كتب سعدالله الكثير عنهم وعن علاقتهم بالجزائر، يقول في هذا الصدد “هم كثر في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وبشكل عام في بلاد الشام، هؤلاء دفع بهم إلى اللجوء إلى المنطقة هربا بدينهم وهويتهم وقيمهم وحتى أرواحهم من الاضطهاد الاستعماري الفرنسي في الجزائر، لاسيما بعد فشل مقاومة الأمير عبدالقادر الجزائري بين 1832 و1847، وإخفاق المقاومة التي فجرتها ثورة الحاج محمد المقراني والزعيم الروحي الشيخ الحداد عام 1872، وأحفاد هؤلاء موجودون إلى اليوم في البلدان المذكورة، ومعروفون في دمشق وفي غيرها من المدن السورية، وحتى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين السورية واللبنانية معا، فأصبحوا فلسطينيين بعد استيطانهم عدة مدن على غرار حيفا ويافا وطبرية وصفد والعموقة وهوشة وديشوم”.
ويتابع سعدالله “هؤلاء أسهموا في المقاومة الفلسطينية، مثلما كانوا ضمن قوات عزالدين القسّام خلال ثورة 1936، وجاءت حينها إلى فلسطين مجموعات من هؤلاء الشاميين جزائريي الأصول قاربت الألف متطوع للجهاد من سوريا”.
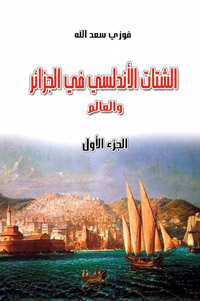
ويتابع “كما لا يجب أن نغفل ذكر الفلسطينيين من أصل جزائري ضمن منظمة التحرير الفلسطينية ومختلف تنظيمات المقاومة ضد الصهاينة”. ويذكر الباحث سعدالله عددا منهم “بين هؤلاء الشاميين المنحدرين من الجزائر، هناك عائلة خْلِيفَاوِي أصيلة منطقة ذْرَاعْ بن خَدَّة في منطقة جبال جَرْجْرَة، شمال الجزائر، التي شَغَلَ أحدُ أبنائها وهو اللواء عبدالرحمن خليفاوي
(1930 – 2009) منصب رئيس الوزراء السُّوري قبل عقود في عهد الرئيس حافظ الأسد، والدكتور عبدالله مغربي الذي يشغل وظيفة سامية في حكومة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأدباء والعلماء، دون أن ننسى المواطنين البسطاء منهم كعائلات بُوعَدُّو وحَقُّو وآيَتْ يحي والطيّب وقَاسِي وآيَتْ أحمد والحَدّاد”. ويأسف لحال هؤلاء الذين “أهملهم التاريخ والأنظمة في بلدهم الأصلي كما أوطانهم الحالية”.
من بين أبرز بحوث فوزي سعدالله موضوع “الشتات الأندلسي”، وهو عنوان كتابه الأخير، أبرز من خلاله جملة من الأفكار والحقائق عن التراث الأندلسي، وعن علامات الاختلاف والتوافق بين الحضور الأندلسي في دول المغرب العربي وبقية العالم.
يقول “الشتات الأندلسي هم أهل الأندلس وأبناؤهم وأحفادهم الذين دفعهم الظلم والاضطهاد الإسباني المسيحي/ الصليبي بعد سقوط مملكة غرناطة في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى التشتت في العالم. هذا الشتات عِبارة عن خليط عرقي ثقافي حضاري شديد الثّراء، لأن الأندلس كانت أم الدنيا في كل شيء وفي مجال، اختلطوا في ما بينهم وانصهروا على مدى سنين في قالب ثقافي عربي إسلامي لينسجموا في شعب واحد وبلاد واحدة، وإن تذبذبت خارطتها السياسية ورقعتها الجغرافية وتفككت أنظمتها تدريجيا، بمعتقدات متعددة وتقاليد متنوعة.. أهل الأندلس في الحقيقة هم العرب والبربر والأفارقة والإسبان والبرتغاليون والفرنسيون والإيطاليون والجورجيون والرُّوس والألْمَان والآسيويون القادمون من آسيا الصغرى وحتى من الصين والهند وأفغانستان. مع العلم أن العنصر الإسباني كان إلى غاية القرن الـ10 الميلادي يشكل أغلبية سكان الأندلس وليس العرب ولا البربر”.
بحث فوزي في جذور الموسيقى الأندلسية لسببين رئيسيين، فهو – كما يشرح “أنحدر من مدينة الجزائر التاريخية التي نُطلق عليها مجازا وخطأ اسم ‘القصبة‘، فيما القصبة هي فقط القلعة الموجودة في أعلاها المعروفة بـ’دار السلطان’ وليس المدينة بِرمّتِها. ومدينة الجزائر التاريخية هذه تعد حضنا تاريخيا عريقا للفنون الموسيقية الحضرية العربية الأندلسية في بلادنا. أما ثاني سبب فهو أن بحثي في موضوع تاريخ الطوائف اليهودية في الجزائر قادني حتميا إلى الخوض في الموسيقى الأندلسية، لأن نسبة كبيرة من يهود الجزائر كانت تنحدر من أصول أندلسية”.
ويضيف قائلا “حدثت اضطرابات خطيرة منذ تداعيات زلزال سقوط غرناطة سنة 1492، التي جلبت إلى الجزائر مآسي الاحتلال الإسباني لعدد من المدن الساحلية، ثم تداعيات سقوط الجزائر بيد الاحتلال الفرنسي بين سنتي 1830 و1962، والتي أدت إلى استهداف أسس ثقافة المجتمع الجزائري وذاكرته، بإشاعة الجهل والفقر حتى انقطع تقريبا التواصل المعرفي بين أجيال ما قبل 1830، وأجيال ما بعد الاستقلال عام 1962”. صمد الغناء الأندلسي يقول سعدالله “َفي وجه كل هذه المحن وإن لحقت به خسائر معتبرة كضياع حوالي نصف نوباته الأربع والعشرين”.
العمران الإسلامي

عن خصوصية العمران الجزائري وارتباطه بما أنتجته الحضارة الإسلامية، يرى سعدالله أنه “عمران عموده الفقري هو الفلسفة العمرانية والمعمارية الإسلامية والإضافات في التفاصيل عبر القرون والتي قد تستطيع أن تتطور إلى نمط جديد قائم بذاته. ويتأكّد ما أقول من الاطلاع على المدن الإسلامية خلال القرون الماضية كمدينة الجزائر التاريخية، التي نسميها اليوم ‘القصبة‘، وفاس وتونس وطرابلس الغرب والقاهرة والقدس وحلب ودمشق العتيقة وبغداد وغيرها”.
ويتابع الكاتب “الفلسفة العمرانية الإسلامية من سمرقند وبخارى إلى القاهرة والجزائر وفاس وشنقيط في موريتانيا وتنبوكتو في مالي وطليطلة في الأندلس تقوم على قواعد روحية وفلسفية/ أخلاقية محددة ودقيقة على غرار ما ورد في الحديث الشريف ‘لا تحجب الشمس عن جارك‘. وهذا هو حال فن العمارة المصري والشامي والفارسي والتركي العثماني والأفغاني والهندي في شقه الإسلامي. والقاعدة ذاتها تنطبق على الأنماط الغربية والآسيوية غير الإسلامية، أي أنها جميعها خاضعة لجوهر فلسفي/ روحي تاريخي مشترك وإضافات متوالية عبر العصور في عملية تراكم معرفي تاريخية حيوية”.
ويرى سعدالله أن “العمارات هي حوصلة للعمارة البيزنطية وما قبل البيزنطية والإسلامية الأندلسية والشامية مع إضافات محلية، وعندما نغوص أكثر في التاريخ سنجد أنه في عهد المرابطين والموحدين تداخلت الأنماط العمرانية/ المعمارية المحلية على ضفتي البحر المتوسط الإسلامي وتوحدت. لذا، أصبحت الدار القرطبية والإشبيلية والغرناطية هي تقريبا ذاتها الدار البجائية والقسنطينية والعنابية والتلمسانية في الجزائر، وهي ذاتها في مراكش وفاس وتونس وطرابلس الغرب ودرنة في ليبيا، حتى البنائون والمهندسون كانوا يتحركون بين ضفتي المتوسط كأن تجد مهندسا أندلسيا يبني الديار والقصور في تلمسان أو في مدينة الجزائر أو في مرّاكش أو نظيرا له من الضفة الجنوبية يبني ويشيد في غرناطة ورندة ومالقة”.
مع الأسف كل هذا التنوع وهذا الحضور القوي لمختلف التأثيرات الجمالية الهندسية العمرانية، يراه سعدالله “خرب ودمر من طرف الاحتلال الفرنسي.. دمر كل ما هو جزائري القلب والقالب، بما في ذلك العمران”.




























