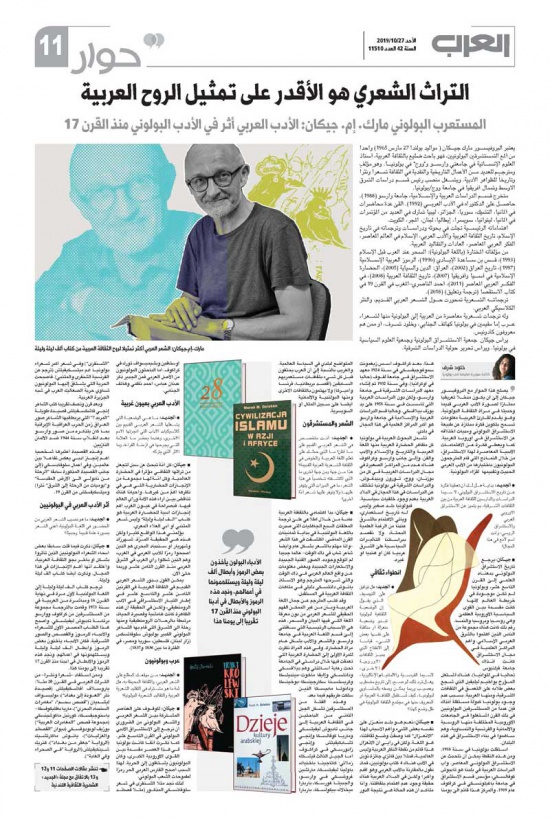طارت "السكرة" وحضرت فكرة المجالس المحلية

عندما خرج الآلاف من الشباب التونسي في الشوارع والأحياء والمدن في حملات بيئية، بدا الأمر وكأنه متسق مع أفكار ومشروع الرئيس الجديد قيس سعيّد بقلب نظام الحكم في المستقبل، ومنح الشعب سلطة إدارة شؤونه في مجالس محلية بعيدا عن سلطة المركز المباشرة.
لكن تلك الحملات التلقائية للتنظيف والطلاء خلطت بين المباني التراثية والتاريخية وبين المنشآت العامة والخاصة، الأمر الذي دفع سلطة الدولة إلى التدخل لإصلاح ما تم إفساده عفويا، وهذه الواقعة قد ترسم صورة عن علاقة الشد والجذب المحتملة بين المركز وبين الجهات أو اللجان.
والآن وبعد أن طارت نشوة الفوز التاريخي بالرئاسة لرجل القانون المتقاعد قيس سعيّد، حضرت الفكرة ومن ورائها التساؤلات حول المشروع السياسي الذي يلوح به الرجل ويثير الكثير من التحفظ والتوجس لدى الطبقة السياسية.
ما ينادي به سعيّد من سلطة المجالس المحلية يجد صداه في تعريف الفقيه الفرنسي موريس هوريو للسلطة بشكل عام من أنها “طاقة حرة تتحملها مؤسسة الحكم لمجموعة بشرية عبر التأسيس المستمر للنظام والقانون”، ما يشير إلى أن طرق الحكم هي أيضا فعل متحرك ومتغير في التاريخ.
مع ذلك فإن التفسير الذي يذهب إليه فقيه القانون الدستوري والحكم المحلي غيوم يروتيار يقرّ اعتبار أن الحكم المحلي لا يمكن دستوريا أن يحدّ من سلطة الدولة ووصاية المركز. وفي تقديره ينبغي فهم هذا النمط من الحكم على أنه عمليا هو إتاحة مساحة أوسع للشعب من أجل حرية التعبير. ولكنه نظام يفتقد إلى معارضة قوية وذات فاعلية تجاه السلطة في المركز.
فما هي طبيعة المجالس المحلية التي ينادي بها سعيّد؟
فهل ستكون مستلهمة من المجالس العمالية التي نظّر لها كارل ماركس في القرن التاسع عشر ثم أدار لينين وزعماء السوفييت عنها ظهرهم؟ أم أن سعيّد يقصد من وراء مشروعه، تعزيز الحكم المحلي بحيث يتم الاقتداء مثلا بنظام حكم الكونتونات في سويسرا باعتبارها أرقى تجارب حكم الديمقراطية المباشرة؟
يجد تعبير المجالس العمالية أو “الشيوعية المجالسية” صداه نظريا على الأقل، لدى جزء من المؤيدين اليساريين من حول الرئيس الجديد، وهو تعبير وجد تطبيقه تاريخيا لدى العمال الروس في إضراباتهم ببيترسبرغ في بداية القرن الماضي، غير أن البلاشفة لفظوه ما إن أحكموا قبضتهم على السلطة بعد الحرب العالمية الأولى. وأحدث هذا الانقلاب البلشفي شرخا مع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في الغرب.
لكن يظل تعريف الفيلسوف الماركسي الإيطالي أنطونيو قرامشي للمجالس المحلية أكثر قربا لواقع الحال إذ أنها حسب رأيه “تمثل جهدا متواصلا للطبقة العاملة حتى تحرر نفسها بنفسها وبوسائلها الخاصة، من أجل أهداف لا تشاركها فيها طبقة أخرى، دون أن تفوّض سلطتها لوسطاء أو سياسيين”.
وهذا التعريف يعدّ الأقرب نسبيا لنظام اللامركزية في الحكم بإيطاليا اليوم، حيث تمنح فيها استقلالية فعلية للجماعات المحلية تكاد ترتقي إلى وضع الدول الأعضاء في الدولة الاتحادية، وقد يكون هذا النموذج الأقرب إلى تفكير سعيّد.
ومع أن سعيّد لم يتحدث بشكل مفصل عن مشروع القانون الذي ينوي تقديمه فإن نظام الحكم المحلي أو حكم المجالس، يتلخص بحسب ما لمّح إليه في انتخاب مجالس محلية، ومن ثم مجالس جهوية تتولى بدورها انتخاب مجلس وطني (البرلمان)، ويرافق هذا تعديل للنظام الانتخابي الحالي بالانتقال إلى الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القائمات، لأن هذا النظام يظل الأنسب لقاعدة القرب بين الناخب والنائب في المحافظات.
وفي تقدير قيس سعيّد فإن من مزايا هذا النظام أنه سيسمح علاوة على تخفيف العبء عن المركز، بمنح الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس المحلية وسلطة اتخاذ القرارات، كما سيحدّ من الفساد المستشري وسيمنح دفعة للتنمية المتعثرة في الجهات المهمشة والفقيرة ويعزز من فاعلية المراقبة والمساءلة.
لكن تلك المزايا لا تلغي تحفظات المنتمين إلى الأحزاب السياسية ومن بينهم من أيّد سعيّد في السباق الرئاسي ومنهم أيضا متخصصون في القانون الدستوري، على فكرة انتخاب المجالس التمثيلية على درجتين، الأمر الذي قد يفضي في الأخير إلى إضعاف السلطة التشريعية وتشتيت السلطة بشكل عام.
كما لا يخفي المنتقدون لهذا المشروع أن نظام هذا الحكم يشترط بنية اجتماعية وإدارية متطورة ومستوى متقدما من نضج التجربة الديمقراطية، وهو ما لا يتوفر موضوعيا في تونس التي لا تزال تمر بمرحلة انتقال سياسي وديمقراطي.
وثمة أيضا ما يعزز من خشية الطبقة السياسية الحالية في ما يرتبط برغبة سعيّد، وإن كانت غير صريحة وواضحة، في تنظيم استفتاء على النظام السياسي برمّته من أجل العودة إلى النظام الرئاسي بصلاحيات أوسع للرئيس، مقابل إلغاء منصب رئيس الحكومة وتعويضه بالوزير الأول كما هو الأمر في النظام السياسي الفرنسي.
خطوة الاستفتاء ومع أنها تصدر عن رجل ينظر إليه في تونس كأب القانون الدستوري، فإنها تثير حساسية بالغة لدى معارضين لنظام الحكم السابق قبل الثورة، وهي في تقديرهم قد تكون مدخلا للمغامرين لاحقا قصد التأسيس لدكتاتورية جديدة، رغم كل التطمينات التي تعهد بها سعيّد في خطاب التنصيب من أن “حنين البعض للعودة إلى الوراء هو لهث وراء السراب”.