قاص عماني يفتح صندوق أحلامه لأجل متعة القراء

يهتم القاص العماني محمد الزرافي في مجموعته “صندوق الأحلام”، باللحظة الختامية لحيوات أبطال مغمورين يحاولون بجهد الحياة أن يشكّلوا مواقفهم منها، مستخدماً أسلوب الإيماء أحياناً، والتصريح في أحايين أخرى، دون أن تفقد الخاتمة صدمتها التي أراد لها منذ لحظتها الأولى؛ من اختيار العنوان حتى القفلة النهائية. “العرب” كان لها معه هذا الحوار حول مجموعته والساحة الأدبية العمانية وغيرهما من القضايا.
نواجه في قصص المجموعة القصصية “صندوق الأحلام” لمحمد الزرافي الصادرة مؤخراً عن دار مسعى الكندية بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، مثل: قصة “الملاحق”، و”القلم الجاف”، و”ما حدث للنوارس”، وغيرها، نهايات مفتوحة تستدعي يقظة القارئ لكل مقدمات الزرافي السردية القصيرة التي تذهب به للنهاية دون أن يذكرها. وفي ظل ذلك يوزّع مناخات مجموعته بين عدّة قضايا، بعضها ذاتي، وبعضها بمدلول اجتماعي وسياسي، ولكن جميعها متفقة على أبطال منكسرين في هامش الحياة.
يلمس القارئ في قصة “صندوق الأحلام” -التي تتكئ عليها المجموعة في عنوانها- الحدث القصصي المتصاعد من لحظة تدشين الطريق المؤدي بالبطل إلى الحلم لينتهي بالأحلام المؤدية إلى الطريق. وهنا يفكك الزرافي الدراما القصصية بصورة تخييلية فانتازية لما يجب أن تكون عليه الأمور خارج صندوق الأحلام. الأمر نفسه في قصة “لا نجوم في المدينة” التي رتّبت بشكل رمزي مواعيد الرجل الوحيد أمام الظل الآدمي المتخيّل.
هكذا يستمر القاص الزرافي في بناء عوالمه القصصية عالماً تلو عالم بين الخيالي والواقعي، ففي قصة “نهاية” تتجلى لحظة الفردانية المطلقة، وقسوة المدينة والعالم أمام الإنسان، لتعيد لنا مسرح علاقته بالمدن الإسمنتية التي تقدّس العمل وتحول الإنسان إلى مجرد ماكينة ضخمة لابتلاعه.
بداية من النهاية
يقول الزرافي متحدثاً لـ”العرب” إن “هذا الكتاب هو أفكار استخلصت، وآراء أوردت، في ما رأيت وسمعت وحدث ويحدث، فهو إذن، مشاهدات انبعثت من حوادث، ومواقف، عن تجربة متواضعة في هذه الحياة. إن ‘صندوق الأحلام’ يحوي كتاباتي الأولى في القصة القصيرة، التي يعود بعضها إلى ثلاث سنوات خلت. في ذلك الوقت، كنت أكتب لأجل نفسي فحسب، واضعًا في ذهني أن القارئ الوحيد للقصة التي أكتبها هو أنا، وحريصًا على وضع التأثير الذي أردت أن أحس به كقارئ، وعندما تأتي فرصةُ نشر، لن تكون هذه الكتابات الأولى إلا تجربة قديمة مفيدة، تشبه الحبوَ الذي يسبق خطوات الطفل الأولى، تكون منطلقًا لكتابة ما هو أفضل”.
ويتابع “ورغم أنني لم أكن أخطط لنشر قصصي الأولى، فقد تنبّهت لاحقاً إلى أن كونها ‘القصص الأولى’ يجعلها ذات أهمية كبيرة، حيث نشرها يُعدّ بناءً لمرحلة أولى، تكون مستقبلا، حلقة من الحلقات، تُمثل خبرة ذلك الزمن التي بُنِيَت فيه، وتسلّمها للتي تليها. وغني عن البيان، أني إذ ذاك، لم أكن ألقي بالًا لرقيبٍ أو غيره. كنت أنسج الخيال في بعض القصص، لرؤيتي أن هذه هي أفضل طريقة لتقديمها، لتعطي التأثير الذي تحتويه”.
وعن بنائه الخاص للحظته القصصية يقول القاص “ترجع اللحظة إلى تفكيري في نهاية القصص قبل البداية غالبًا، أي أني منذ البدء أكون على علم بالحدث الذي ستنتهي به قصة ما، والطريقة التي ستُختتم بها، قبل أن أعرف بدايتها تمامًا، وأتحقق الطريق الذي ستسلكه كي تصل إلى تلك النهاية. لطالما تأثرت بنهايات ما كنت أقرأ من قصص، وكنت أجد فيها قوةً، تخلّف وقعًا مؤثرًا في النفس، تجعلها من القليل الذي يدمغ الذاكرة بختم أبدي. ومن النهاية، تكون البداية وفقًا لما أراه، على أني لا أقول إن النهايات تكون ثابتةً دائمًا، وليست معرّضة للتغيير خلال الكتابة”.
المتعة والحرية
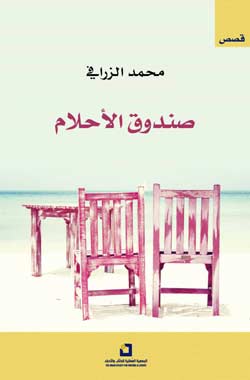
عن رأيه في مكانة القصة القصيرة المعاصرة جماهيرياً، وهل هي قادرة على إحداث تأثير ومتابعة كما هو الحالة في الرواية. يقول الزرافي “أرى أن عمل القاص في نسج قصص متقنة، لا يقل صعوبة عن عمل الروائي في روايته، فكل الكلمات في القصة القصيرة، محسوبة، ولها قيمتها في مكانها، وترتيبها، ووقت قدومها، ولا تكون حشوًا لأجل ملء فراغ، وإنما للقيام بما يزيد في قيمة القصة، وحتى إن كان هذا يشمل كتابة الرواية كذلك، فهو أكثر أهمية في كتابة القصة. ولكونها –أي الكلمات- تشكل قصة قصيرة: فهي ترزح تحت مهمة جذب القارئ والتأثير فيه، في سطور قليلة، ووقت قصير. وما إن ينبغ قاص في وضع الكلمات في قوالبها المُثلى، إلا وبلغ ذاك الشأو، الذي يستطيع فيه إحداث التأثير والمتابعة عند الجماهير، وخلق حضور قوي كحال الرواية، ولست أزعم، على أيّ حال، أني بلغت مبلغًا مشابهًا”.
يرى القاص أن القارئ عندما يهمّ بقراءة كتاب، ينتظر من الكاتب أن يساعده، ويعلمه ويوضح له، ويخلص في حديثه وهنا يتحمل الكاتب مسؤولية كبيرة في كتابة ما يستحق القراءة. يقول “مسؤولية الكاتب على من يكتب في الأدب، أيًا كان ما يكتبه، إن كان يسعى لأن يصل لفئات مختلفة، أن يضع في قائمة أولوياته، متعة القارئ، الذي سينتقي كتابه من بين المئات من الكتب الأخرى ويصرف وقتًا من عمره المحدود في قراءته، فالقارئ إن كان مستمتعًا بما يقرأ، سيواصل القراءة”.
ويضيف في الشأن نفسه “هذا عندي هو ما يبعث روح القراءة في النفس ويجعلها مستمرة، يقظة، ويكون ذلك على أفضل وجه، بتقديم معان جديدة في إطار جذّاب، أو عرض معان سابقة في صورة غير معتادة، وخلق الصور الفكرية الجميلة، التي تعطي التفاصيل الصغيرة في الأشياء، قيمتها، وتكشف مواطن الجمال والحكمة فيها، فتكون القراءة بهذا كله، لذّة في تنمية الفهم، وتوسيع الإدراك، والإحساس بأن إحدى أعظم المتع في هذه الحياة: هي متعة أن تعرف”.
وفي ختام الحوار تطرقنا إلى مواقف المثقفين في عمان من حرية الرأي والتعبير، وكيف يتم قراءة متغيراتها لا سيما بعد مجموعة استدعاءات طالت بعض المثقفين العمانيين على خلفية رأيهم السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
يقول الزرافي في هذا الموضوع “لا يرتاب عاقل، أنه لا بدّ من حدود في كل شيء، يعرف الناس قبلها وبعدها، ما يجوز وما لا يجوز. ورغم أن كلمة: حدود، قد تلقي في خَلَد المرء معنى التطويق والتضييق، فإنها في حقيقة رسمها، ضمان للحرية، ومعاني الحرية، وبدونها نكون كالذي ألقى حبلها على غاربها. وقد يزعم الزاعم، بأن الحدود ليست إلا منعًا للحرية المطلقة المنشودة التي تمثل حقًا من الحقوق، وهذا، ليس إلا مواربة وخداعا، إذ لم تكن الحرية المطلقة على أي جانب من جوانبها، إلا مرادفة للفوضى الكلية”.
ويتابع مختتما “غير أننا لا ننكر أن الحدود في حرية الرأي والتعبير ضاقت في مواضع، حقها فيها أن تتسع، والحظر الذي لم نعلم له سببًا واضحًا، لعدد من الكتب في معرض الكتاب الماضي (مسقط)، مثال من أمثلة”.




























