نقاد وباحثون سعوديون يقتحمون أسرار الروايات والقصائد

قراءة النصوص الأدبية تفتح أكثر من باب، فنجد القراءة العادية السطحية وفي مقابلها القراءة العميقة العلمية، ولعل هذه الأخيرة أكثر تفرعا بين النقاد والدارسين والباحثين الجماليين أو العلميين، حيث يتشابك في الأدب الجانب الفني بالمعرفي ما يتطلب تأسيسا لطرق قراءة متجددة دائما تجدد الإنسان وتجدد آدابه وفنونه.
جاء ملتقى قراءة النص في نسخته الـ16 بعنوان “تحولات الخطاب الأدبي السعودي في الألفية الثالثة”، مركزا على ملامح الهوية الوطنية وتجلياتها في الخطاب الأدبي، والقصيدة العمودية وسلطة البقاء، والقصيدة الجديدة وأسئلة المرحلة الراهنة، وتداخل الأنواع الأدبية من النوع إلى التماهي، والآفاق الجديدة في السرد والأنواع والتقنيات، والأدب السعودي في مقاربات النقد العربي، واتجاهات النقد السعودي بين المنهجية والتطبيق، بالإضافة إلى خطاب النص الدرامي السعودي وقضايا العصر.
وانتظمت أخيرا جلسات الملتقى، التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة، بحضور جمع من الأدباء والمثقفين، حيث بدأت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور صالح المحمود، وشارك فيها الأستاذ الدكتور مرزوق بن تنباك بورقة عن “مفهوم الهوية الوطنية”.
الهوية والانتماء

في أولى جلسات الملتقى تناول بن تنباك في ورقته الهوية الوطنية وأهميتها للفرد والمجتمع، مركزا على مفهوم المواطنة والهوية الوطنية عند النخبة السعودية خاصة ودلالتها ومدى الوعي بحقوقها وواجباتها بعد التوحيد السياسي للمملكة، مشيرا إلى أنه اجتمعت بموجب الوحدة السياسية عادات وثقافات وقيم ومذاهب أصبحت تنتمي إلى المواطنة والهوية الواحدة والحقوق العامة للأفراد والمجتمع.
وفي بحثه الموسوم بـ”ملامح الهوية الوطنية في الشعر السعودي” اتخذ الباحث ياسر أحمد مرزوق أستاذ الأدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية بجامعة تبوك من ديوان “وطني عشقتك” للشاعر مُسلّم بن فريج العطوي نموذجا لإثبات فرضياته، حيث يشير إلى أن مفهوم الهوية انتشر وغطى مجمل العلوم بل وفرض نفسه على العديد من العلوم.
كما قدم الدكتور محمد سيد علي عبدالعال أستاذ الأدب العربي المشارك بجامعة جازان ورقة تناولت “دوائر الانتماء وتقاطبات الهوية في الخطاب الروائي السعودي”، وقد أشار من خلالها إلى ظهور أنماط لشخصيات روائية سعودية في القرن الماضي، لا تحمل خصوصية الهوية وملامحها المحددة المتمايزة، مرتئيا في ذلك “هروبا من سلطة القارئ، الذي تكتنفه سياقات ثقافية تؤطره، وتشكل ذائقته، فكان التخفي وراء شخصيات تحمل هويّات مغايرة هو سبيل الروائيين في معالجة وجهة النظر، إلى أن تشكلت البُنى الثقافية الجديدة في القرن الجديد، فكانت الجرأة التي ميزت سردياته واقتحام المسكوت عنه”.
واتخذ عبدالعال من رواية “مجاعة” للروائي جابر مدخلي (1981) نموذجا للتدليل على الفرضيات في ورقته، معللا هذا الاختيار بكون مدخلي أبرز الروائيين الذين تجلت لديهم ثيمة الوطن التي شكلت دوائر الانتماء وتقاطبات الهوية في سرده المتصل بداية من روايته “مجاعة” مرورا بروايته البارزة “إثبات عذرية” ووصولا إلى روايته الأخيرة “حوش عباس”.
وعنون الدكتور صالح العمري ورقته بـ”الهوية المتخيلة: البداوة لدى الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية” حيث سعى في ورقته إلى الكشف عن المكونات الخفية للهوية البدوية والصور الكامنة للذات والآخر التي يستحضرها الشعراء الشباب في دواوينهم وقصائدهم، وعن مدى الواقعية والوهم في هذه الصور، كما أثارت الورقة السؤال حول دور الهوية الصغرى (البداوة) في ظل الوطن كهوية كبرى تختضن وتشمل الجميع.
قراءات سردية
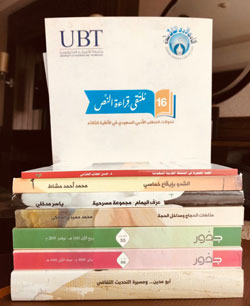
شهدت الجلسة الثانية للملتقى عددا من المشاركات النقدية والقراءة السردية لعدد من الكتاب السعوديين وأدارها الدكتور حسن النعمي. وقدم فيها الدكتور حسن حجاب الحازمي ورقة حملت عنوان “الرؤية السردية في رواية.. ما تبقى من أوراق محمد الرطيان.. لعبة الشكل وتمويه المعنى”، قدمت الورقة مقاربة لرواية الكاتب السعودي محمد الرطيان، متكئة على مقولات البنيوية السردية التي تنظر إلى الرواية على أنها تقوم على دعامتين رئيسيتين: الحكاية والخطاب.
وتحدثت الدكتورة بسمة عروس عن سردية عبده خال بين التمثيل الواقعي والانزياح، وهي دراسة في التحولات والأشكال، وفي ورقتها الموسومة بـ”تحولات الأدب السعودي وإشكالية التحقيب” تضع الباحثة الدكتورة لمياء باعشن هدفا رئيسيا يتمثل في محاولة رصد الكتل الزمنية المكونة للأدب السعودي، وفحص الآلية المستخدمة في تقسيم مُدَده المتتالية على المحور التعاقبي.
من جانبه عرّج الدكتور ماجد الزهراني على رواية “موت صغير” وحصولها على “البوكر العربية” لعام 2017، ليجعلها هدفا لورقته “ألق الانتشار وأفق الانتظار”، لقياس مدى الاهتمام بالرواية السعودية، حيث يقرر الزهراني أن الرواية السعودية المعاصرة احتلت مكانة مرموقة على المستويين العربي والعالمي، لما تحفل به من تطورات فنية وفكرية لفتت الباحثين للسبر في أغوار هذه النصوص الإبداعية المُنتجة والكشف عن مكنوناتها، جاعلا من هذا الاهتمام هدفا للدراسة والبحث عن أسباب الحضور الكثيف للرواية.
وفي ورقته بعنوان “ناقد النص والمنصة.. الغذامي وثقافة تويتر” يذهب الدكتور عادل خميس إلى القول إن الغذامي أحد الذين تنبهوا للتغييرات التي جلبها عصر ما بعد الحداثة، ونبهوا على ضرورة أخذ التحولات القادمة بجدية ومسؤولية، ومنذ تحوله إلى مشروعه في النقد الثقافي بداية الألفية الثالثة، وهو يحاول ممارسة ما عزم عليه، متعاملا مع الظواهر الثقافية المختلفة بوصفها نصوصا لها أبعادها وسياقاتها الخاصة.
ورصدت الباحثة الدكتورة أمل التميمي في ورقتها “تحولات السيرة في الأدب السعودي من الأشكال التقليدية إلى الدراما العالمية”، متسائلة في البداية: هل طرأت تحولات على السيرة في الأدب السعودي؟ ثم مستعرضة التحولات التي مر بها الأدب الذاتي في المملكة ورحلته من الأشكال التقليدية في الصيغ المكتوبة إلى الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني والتفاعلي إلى الشكل الدرامي، ويوميات اليوتيوب، إلى السينما العالمية.
من جانبها وضعت الباحثة مشاعل الشريف موضوع “تحولات القضايا السردية في الرواية النسائية السعودية.. قضايا المرأة في روايات أميمة الخميس أنموذجا”، مشيرة إلى أن بحثها في هذا العنوان يأتي استجابة لعنوان مُلتقى قراءة النص السادس عشر، وأنه يندرج تحت محور “الآفاق الجديدة في السرد: الأنواع والتقنيات”.
القصيدة العمودية
ركزت بعض البحوث على حقل الشعر بتناول القصيدة العمودية، والقصيدة السعودية الجديدة. وبحثت ورقة بعنوان “شعرية الحداثة والعودة إلى الأصول في القصيدة السعودية الجديدة” ، التي قدّمها الدكتور حميد سمير، جاعلا من ديوان “سماوات ضيقة” للشاعر خليف الغالب شاهدا على فرضياته البحثية، في ما يتعلق بشعرية الحداثة وسياق الأزمة، والحداثة وبنية اللغة، والحداثة ورسالة الشعر، وشعرية الحداثة وسياق ما بعد الأزمة، معتبرا الديوان “سماوات ضيقة”، نموذجا لنمط شعري جديد في الشعر السعودي.
من جانبه أكد الدكتور حمد بن ناصر الدخيل في بحثه الموسوم بـ“ريادة القصيدة العمودية في الشعر السعودي” ضرورة استصحاب سبعة أعمدة تقوم عليها القصيدة العمودية، وليس الوزن والقافية فقط، وأن الوزن والقافية يعدّان عمودين من سبعة أعمدة لا بدّ أن تشتمل عليها القصيدة أو الشعر، مشيرا إلى أن الشعر السعودي منذ إرهاصاته الأولى أيام الدولة السعودية الأولى التزم بوحدة الوزن والقافية، وقارب الالتزام في مرحلته الأولى ببعض ما نعدّه من أركان الشعر العمودي.
ورصدت الدكتورة شادية شقرون في ورقتها “الكتابة والاختلاف في القصيدة السعودية الجديدة من سلطة التمرد إلى آفاق التجديد”، رحلة إبداع الشعر التي واكبت تجديدا وتحولات، على مستوى الشكل والمضمون، حيث كان التحول الأول على مستوى الشكل بتكسير بنية القصيدة العربيّة القديمة وتجديد قالبها الشكلي بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية.




























