"موسم الأوقات العالية" رحلة في واقع متشظ

رغم ادعاءات نهاية جنس القصة القصيرة، فإنها لا تتوقف عن التطور مفندة ما يروج من مقولات خاطئة مستمرة في التطور عبر الزمن. فحتى مع تبدل الكلمات وتغيّر مدلولات المعاني وتجدد الأشكال والأنماط، يبقى للقصة القصيرة الكثير مما يمكنها كشفه بعيدا عن هيمنة الفكر التسويقي. وهو ما نراه في قصص الكاتب المصري ياسر عبداللطيف المثيرة.
سمير مندي
تتضمن المجموعة القصصية الجديدة “موسم الأوقات العالية” للكاتب ياسر عبداللطيف، الصادرة عن دار الكتب خان في القاهرة، سبع قصص تتوافق بعضها في خط سردي واحد، بينما تتباين الأخرى في موضوعاتها ومنظوراتها. لكنها، في نهاية المطاف، تقدم قراءة لجيل وواقع تشكل على أنقاض جيل وواقع في مطالع التسعينات من القرن الماضي.
لو بدأنا من قصة “موسم الأوقات العالية” التي جعل منها الكاتب عنوانا للمجموعة ككل، فسوف يسترعي انتباهنا تكوين جماعة “الكريبتو أنثروبولوجي” كما أسماها السارد “الجماعة” التي تكونت من مجموعة من الشباب الذين يقفون على أعتاب التعليم الجامعي، بعد أن أنهوا تعليمهم الثانوي ارتبطت برباط يصفه السارد برباط “التخدير المقدس”.
إذ اجتمعت الجماعة على تعاطي أنواع مختلفة من المخدرات ضمنت لهم الانفصال عن عالمهم، عالم أواخر الثمانينات من القرن الماضي. في إشارة، ربما، إلى تشققات اجتماعية وطبقية بدأت تتسع رقعتها داخل مجتمع مصري يخطو خطوات سريعة نحو العقد الأخير من القرن العشرين.
الجماعة وتفكك الواقع
ألمح السارد في أكثر من سياق إلى تلك التشققات والتحولات التي عرفها المجتمع المصري. على سبيل المثال “حي المعادي” الذي تغيرت جغرافيته بانتقاله من زمن إلى زمن.
يقول السارد، مثلا، حول بوادر هذه التشققات “كان لحدائق البيوت في الضاحية والمساحات الخضراء الصغيرة فوق بعض الطوارات نظام داخلي للري يستمد ماءه من ترعة ‘الخشاب’ التي رُدمت في مطلع الثمانينات. ولكن بقيت الجسور التي تقطعها، كجسر ‘ظلموه’ الذي غنى عنده عبدالحليم حافظ تلك الأغنية الشهيرة في فيلم ‘بنات اليوم’، وجسر ‘كيكي’ التي قيل إنها فتاة يابانية كانت تعيش في معادي الخمسينات وتحب شابا مصريا تقابله يوميا عند ذلك الجسر البديع الذي تبقت منه الآن بعض قطع الخشب والبلاط في منتصف الحديقة التي حلت محل الترعة في ما يعرف الآن بشارع القنال. ولنظام الري ذاك مجار وقنوات ضيقة كانت تمتد بجوار الأرصفة… أما وقد رُدمت الترعة وبطل ذلك النظام فقد تبقت الجسور والقنوات أشباحا رمزية من الماضي”.
السارد ألمح في أكثر من سياق وأكثر من قصة إلى تلك التشققات والتحولات التي عرفها المجتمع المصري
لم يكن هذا التغير المكاني يشير إلا إلى تآكل طبقة لا زالت بصماتها منطبعة على أديم المكان، وذوقها ناطق في أطلاله. “ذُهني” أحد أعضاء جماعة “الكريبتو أنثروبولوجي” كان واحدا من هؤلاء الذين انتمت عائلاتهم إلى هذه الطبقات المتآكلة ولذلك العالم الذي لم يتبق منه سوى “أشباح”.
يشير السارد إلى خواء شقة “ذهني” وفراغها من بعد “عز زائل” أفضى، في نهاية المطاف، إلى أن تتخذ “الشلة” منها موقعا لممارسة “التخدير”. وبوعي أو بغير وعي تعيد “الجماعة” حيازة المكان وشغل فضائه على نحو يسلخه سلخا عن ماضيه العريق، وينظّمه في حاضر جديد يُحيي فيه خرائبيته باعتبارها اعترافا بهزيمة “أخلاقيات” عفا عليها الزمن.
يقول السارد بعد أن أكد على شبحية ما تبقى من أطلال المكان “لكنها كانت صالحة لرسم نقاط الارتكاز في خرائط الجنوح: سيجارة لدى جسر كيكي، أحدهم يتبول بجوار بئر ناصية شارع القنال مع 85، جلسة للاستراحة بجوار كشك الكاشف قبل مزلقان دجلة. ثم المنعطف الرهيب في نهاية شارع 15 نحو طريق ‘مخر السيل’، والفيلا المهجورة المرعبة التي تطل على ‘عزبة المصري’ عبر النهير الجاف”.
عند هذه النقطة سوف يستشعر القارئ الرمزية التي قد تنطوي عليها جماعة “الكريبتو أنثروبولوجي”. فالشق الأول من الكلمة “كريبتو” يعني الشفرة، بينما يشير الشق الثاني إلى سلوك أو ممارسة. وهما معا يعنيان “سلوكا مشفرا” أو ممارسة سرية.
والشفرة، كما نعلم، مجموعة من الرموز التي تحمل قيما وأخلاقا وممارسات تتقاسمها “جماعة” ما قد لا تكون، بالضرورة، منسجمة مع قيم وأخلاقيات وممارسات المجتمع ككل. بل هي، بالأحرى، هكذا لأنها غير منسجمة مع مجتمعها الكبير. مما يستدعي السرية ويستوجب الكتمان. وممارسة “التخدير” هو شكل من أشكال التمرّد الذي يصل، في راديكاليته، إلى حدّ عدم الاكتراث بإيذاء النفس. بمعنى أن “التخدير” هو أقرب ما يكون إلى احتجاج على أوضاع وقيم وممارسات تشرخت، حتى لو كانت هذه الشروخ غير واضحة بما يكفي.
فقبل “التخدير” تقاسمت الجماعة، مثلا، حب “الشطرنج وتنس الطاولة والروك أند رول”. ولنلاحظ ما تحمله موسيقى “الروك أند رول” من ثورية ترتبط بهوامش الثقافة. بخلاف ذلك فإن قطبي الجماعة، أو النواة الصلبة، التي قامت عليها كانا يتشاركان حب “قراءة الروايات والشعر”.
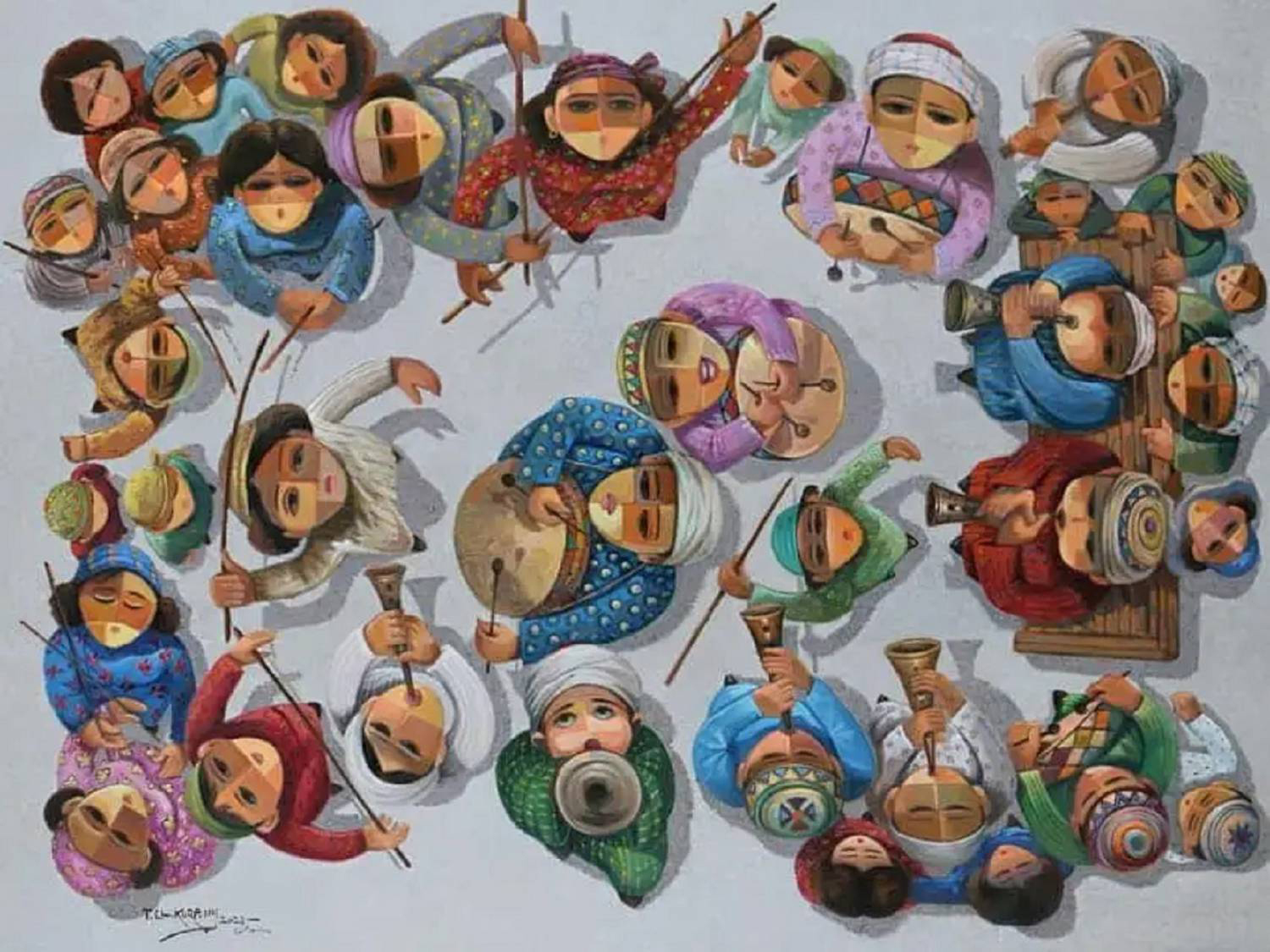
وبالتالي فداخل الجماعة الصغيرة كانت تتشكل نواة لجماعة إبداعية أصغر ترى الفن في الواقع، والواقع بعيون الفن. أليس التخدير هو، بمعنى من المعاني، اصطناع لنشوة تقارب نشوة الإبداع التي يلامس فيها الفنان أو الكاتب منابع إلهامه ويمتح منها؟ وبعبارة أخرى فإن جماعة “الكريبتو أنتروبولوجي” هي بمثابة استعارة لجماعة تقود تمردا إبداعيا تتغير فيه أشكال الكتابة وطرق ممارسة الذات. ليست هذه الرمزية، علاوة على ذلك، بعيدة عن الرمزية الإبداعية التي أضفاها، من قبل، نجيب محفوظ على جماعة أو “تنظيم سياسي” في قصته “التنظيم السري”. فكلاهما يستعير مغامرة ما، سواء مغامرة “التخدير”، أو مغامرة “العمل السياسي” من أجل إبراز مغامرة تمرد إبداعية.
سوف يلاحظ القارئ، أيضا، تحول ضمير السرد من “النحن” في القصتين “شهوة الملاك” و”موسم الأوقات العالية” إلى ضمير المتكلم “أنا” في قصة “قصص الحب التأثيرية”.
كما سيلاحظ أن هذا التحول يجري في موازاة الانتقال من نطق السارد/ البطل بلسان حال جماعته، جماعة “الكريبتو أنثروبولوجي” التي ربط التخدير بينها “برباطه المقدس”، إلى النطق بلسان حال نفسه، بعد انفصاله عنها.
الشفرة مجموعة من الرموز التي تحمل قيما وأخلاقا وممارسات تتقاسمها “جماعة” ما قد لا تكون، بالضرورة، منسجمة مع قيم وأخلاقيات وممارسات المجتمع ككل
يقول السارد في قصة “موسم الأوقات العالية”، “أنا يونس عبدالواحد العضو السابق في تنظيم ‘هاي تايم’ ‘للكريبتو أنثروبولوجي’ بالمعادي، شبح المجموعة الصامت وراويها العليم. أتكلم عنها كما أتكلم عن نفسي… أنا كل الناس… وكل واحد عرفته هو أنا”. ثم في إشارة تالية إلى انسلاخه عن جماعته، يقول “انتهى فصل وحشي من الحياة، وانفرط قطيع الذئاب. انطوي كل واحد على حياته الخاصة. عادوا آحادا، وصرت فردا راويا لنفسي وعنها”.
القصص الثلاث التي تسرد تطورا أشبه ما يكون بسرد “التكوين” الذي يُضيّع فيه الفرد نفسه ليجدها مرة أخرى، جاءت على منوال هذا التطور أشبه بثلاثة مشاهد في حكاية واحدة متصلة من خلال خط سردي واحد، ومنفصلة من حيث ترتيبها في الكتاب. ربما يحاكي الفصل ما أشرنا إليه من انفصال البطل/ السارد عن جماعته. وربما أراد الكاتب محاكاة الانقطاعات الزمنية التي تتخلل الحياة ككل، بقطع تتابع السرد في القصص الثلاث. طالما أن الأحداث لا تقع، في واقعها، بنفس التسلل والتتابع الذي يجري ويتتابع في السرد.
والمهم أن الكاتب، لهذه السبب أو لذاك، قد قطع التواصل السردي بين القصص الثلاث بقصص لا تنطوي على اهتمامات ذاتية. فلا بد وأن يتوقف القارئ عند قصتي “الربيع في شتوتجارت” و”دراسة عن العشق الأوديبي” قبل أن يصل إلى النقلة الثانية في خط هذا التطور من خلال قصة “موسم الأوقات العالية” ثم يتوقف ثانية مع قصة “2005 أجرة القاهرة” قبل أن يصل إلى النقلة الأخيرة بقصة “قصص الحب التأثيرية”، وقبل أن تصل المجموعة، ككل، إلى ختام بقصة سابعة قصيرة جدا بعنوان “القمر فوق بحر الرمال العظيم”.
إعادة بناء الواقع

ضمن هذا السياق سوف يلاحظ القارئ الطريقة التي يتبادل بها الفن والواقع مواقعهما في المجموعة ككل. ففي قصة “شهوة الملاك”، مثلا، وبالتوازي مع سرد وقائع اغتصاب “فتاة المعادي”، الحدث الذي هز مصر منتصف الثمانينات من القرن الماضي، يجري سرد المعالجة السينمائية التي تناولت الموضوع.
ضمن هذا التخييل السينمائي الأدبي للواقعة يشير السارد إلى شخصية صلاح أبوحلاوة المتهم الأول في الجريمة، ونظيرتها في السينما التي جسدها الفنان المصري حمدي الوزير في فيلم “المغتصبون” 1989. قراءة السارد للشخصيتين الواقعية والسينمائية لا تخلو من تلميح إلى تدهور السينما عموما، والتدهور التدريجي خصوصا الذي آل إليه ممثل مثل حمدي الوزير بعد أن حبسه المخرجون في دور المغتصب كأنما أصابته لعنة صلاح أبوحلاوة الذي آل مصيره إلى الإعدام.
والتدهور قار في ممثل انتقل من أداء أدوار تناقش قضايا جادة، كما في شخصية “ضيف” التي لعبها في فيلم “سواق الأتوبيس” لمخرج مثل عاطف الطيب، إلى ممثل يواصل لعب دور المغتصب في أفلام المقاولات مثل فيلم “قبضة الهلالي” لمخرج مثل إبراهيم عفيفي. إن الفن، مرآة الواقع، من هذا المنظور، يصبح انعكاسا لواقع يتحلل مفسحا الطريق أمام واقع آخر بديل يتشكل.
وخطا الكاتب خطوات أبعد نحو محو الغلالة الشفافة التي تفصل الواقع عن الفن في قصة “قصص الحب التأثيرية”. حيث تصبح القصة بأحداثها وجوّها تمثيلا أدبيا للنزعة الانطباعية أو التأثيرية التي تتخذ من لوحة كلود مونيه “انطباع عن شروق الشمس” أيقونة لها.

المجموعة القصصية الجديدة “موسم الأوقات العالية” للكاتب ياسر عبداللطيف تتضمن سبع قصص تتوافق بعضها في خط سردي واحد، بينما تتباين الأخرى في موضوعاتها ومنظوراتها
إذ يعيد السارد/ البطل قراءة هشاشة علاقته بامتثال باعتبارها “انطباعا” تشكَّل في لحظة تاريخية محددة انقضت بانقضاء هذه اللحظة. مثلما يعيد، في موازاة هذا التخييل للواقع، قراءة تجربته في الشعر باعتبارها تجربة تُوقع الشعر موقع الواقع. أو بعبارة أخرى تضفي على الشعر صبغة واقعية. يقول “كنا نكتب الشعر بإخلاص من يريد أن يرى الشعر في الحياة نفسها، في حركة الفرد وسط محيطه، واشتباكه مع عالم قديم يندثر”. (قصص الحب التأثيرية).
تتحول هذه اللحظة من “انطباع” في قصة “قصص الحب التأثيرية” إلى “صراع” يجري على خشبة مسرح في قصة “2005 أجرة القاهرة”. فعندما يريد السارد/ البطل، على سبيل المثال، أن يفضح الصراع الخفي بينه وبين رئيسه في “الجمعية” الأهلية على “جينا” الفتاة الإيطالية الشابة. ويفضح، بالتالي، أحد أشكال فساد المثقف في مصر، فإنه يضع مشهد الصراع في قالب مسرحي يجري أمام جمهور وهمي يصفق في نهايته. يصل الصراع إلى ذروته بتركه للجمعية، وسط قناعة بعدم جدية هذه الجمعيات في مصر.
يقول “ووضعت كأس الويسكي جانبا وغادرت المكان، أمام ذهول عيني جينا التي لم تفهم لماذا توتر الجو، ولماذا غادرت فجأة. وسط تصفيق حار من جمهور وهمي! لم يكن بالطبع باقي المدعوين قد انتبهوا لهذا الحوار السريع والقاطع على خشبة مسرح ذلك الركن من الغرفة بالأريكة والمقعد الوثير المجاور لها”. (2005 أجرة القاهرة). اللافت أن المؤلف قد أضفى سمات أدبية مسرحية على هذا المشهد بالذات، فافتتح سرده بتحديد مكان الأحداث، وزمنها وشخصياتها “أنا وجينا وطارق”. في موازاة ذلك ضغط المؤلف الشكل الطباعي للمشهد مميزا إياه عن الشكل العادي الذي يتخذه شكل القصة ككل، ليبدو أكثر قربا من مشهد مسرحي يتغلب فيه الحوار على ما سواه.
تتبقى ملاحظة أخيرة حول طبيعة المكان في هذه المجموعة. فالمكان في مجموعة “موسم الأوقات العالية” يتجاوز الفكرة المجردة التي تفترض أن أي حدث لا بد وأن يقع في مكان ما، إلى فكرة المكان الذي تصبح الأحداث من دونه غير ممكنة أصلا. لا سيما داخل الجغرافيا الأم لياسر عبداللطيف، وبالقرب من فضاءات سنوات تكوينه الملهمة.
وبعبارة أخرى فإن المكان كثيرا ما يتدخل في صنع الأحداث، بل ومن الوارد أن يتدخل في كتابة بداياتها أو نهاياتها. ففي قصة “قصص الحب التأثيرية”، مثلا، فإن الخلاف على المكان هو الذي يضع حدا لعلاقة السارد بحبيبته امتثال. يقول السارد “صارت تتبرم من أماكن لقاءاتنا. كرهت ‘كافيه ركس’ وكرهت التوفيقية وحواري شارع الألفي وجلال التي كنا نقضي في مقاهيها جلساتنا. تنامى لديها شعور بأننا منفيان بعيدا عن الحياة. كانت تقصد بالتحديد حياة الوسط الثقافي في مثلث الرعب المشهور بين ميدان طلعت حرب وشارع البستان. ترى أننا ضائعان كممثلين لأدوار ثانوية في فيلم قديم، وهي تريد بقعة الضوء في بطولة ما على مسرح الحياة التي تدور هناك. وأخذت تصر على أن نغير أماكن لقاءاتنا نحو منطقة باب اللوق وقصر النيل… سرت معها تلك الليلة البعيدة من التوفيقية حتى ميدان التحرير وتركتها على أبواب عالمها السعيد لنفترق للمرة الأخيرة”. (قصص الحب التأثيرية).
أيضا ما يلعبه “حي المعادي” في هذه المجموعة من أدوار لا تقل عن أدوار البطولة. فالقصة الأولى في المجموعة “شهوة الملاك” بطلها الأول، “حي المعادي” نفسه، سواء بما وفّره الحي بهدوئه ومتاخمته لأحياء تُصدر الجريمة مثل “طرة”، “المعصرة” و”كوتسيكا”، من مسرح مناسب لوقوع جرائم مثل جريمة اغتصاب “فتاة المعادي”. أو باعتباره مسرحا لسنوات تكوين جماعة “الكريبتو أنثروبولوجي” التي ربط التخدير بينها “برباطه المقدس”.
القصص تسرد تطورا أشبه ما يكون بسرد التكوين الذي يُضيّع فيه الفرد نفسه ليجدها مرة أخرى
السارد الذي يمتلك وعيا طبوغرافيا أعاد رسم “الحي”، لا بوصفه حي النشأة أو ملعب الطفولة، إنما بوصفه “نقاط ارتكاز” لممارسة التخدير، بتعبير السارد. ومع إعادة توزيع المكان طبقا لوظيفته التخديرية الجديدة، يتأكد حضور المكان باعتباره “أطلالا” وشاهدا على زمن مضى. وتتضح، من ناحية أخرى، سخرية الجماعة من كل ما كان يمثله المكان، ومما كان يحمله من قيم وأخلاقيات مُورست على أرضه. يقول السارد “أما وقد رُدمت الترعة وبطل ذلك النظام، فقد تبقت الجسور والقنوات والآبار أشباحا رمزية من الماضي، لكنها كانت صالحة لرسم نقاط الارتكاز في خرائط الجنوح”. (موسم الأوقات العالية).
بل إن السارد كثيرا ما يتخذ لقصصه “مداخل” مكانية، وكأنما يتحتم علينا أن نقف في مكان ما لينفتح باب حكايات وأحداث بعينها. فالمكان هو مفتاح سر السرد ومُشغله الأساسي. ففي مستهل قصة “قصص الحب التأثيرية”، يقول السارد مثلا “شارع قصر العيني هو مدخل سكان جنوب القاهرة إلى ‘وسط البلد’، وريد يقودهم بين عمائره القديمة نحو ميدان التحرير ومنه إلى مناطق قلب العاصمة وكل أنحاء المدينة. تتقدم عينان في توغل بطيء من قصر العيني نحو اتساع المكان، ثم تتوقفان لاختيار الوجهة: باب اللوق وقصر النيل؟ أم التوفيقية والأزبكية؟ لا بأس من الطمع واهتبال الخيارين: تضع المدينة على صحن، وبالسكين تقسمها إلى قطع صغيرة تأكلها على مهل، بالشوكة واحدة تلو الأخرى”.
داخل القصة نفسها يتكرر المكان باعتباره مدخلا سرديا لما سوف يجري من أحداث. سواء في رسمه لفضاء جامعة القاهرة حيث “المكتبة المركزية” مسرحا لأولى فصول حكايته مع امتثال. أو شارع “عبدالخالق ثروت”، بوسط القاهرة، الذي كان بمثابة شاهد على تطور العلاقة وتصاعدها قبل أن تصل إلى ختام على “أعتاب ميدان التحرير”.
◙ ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية اللندنية


























