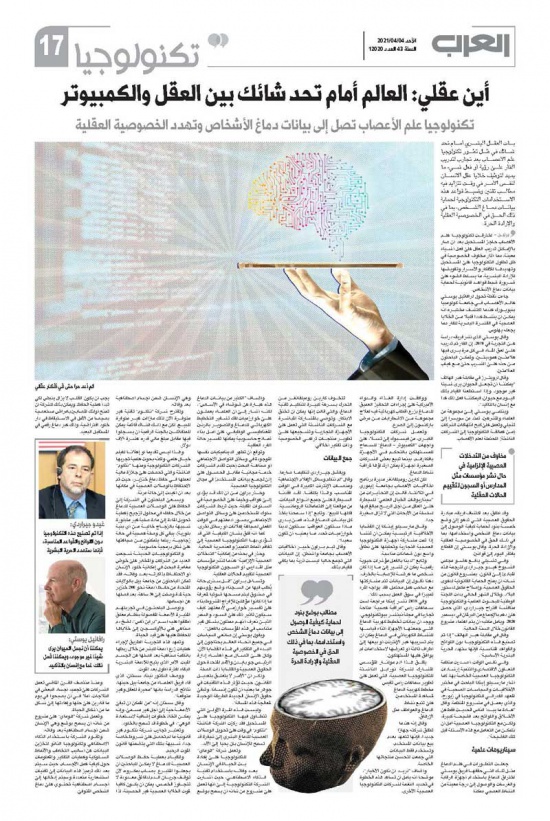غرنيكا بيكاسو وحوذي تشيخوف ضد نشرات الأخبار

يقول المثل الإنجليزي إن “الاعتياد يُولِّد الاستهانة”، ما يُقصَد به أن كثرة التعرُّض لشيء ما أو شخص ما، غالبًا ما يكشف عيوبه التي ظلَّت خافية لمدة من الزمن؛ عندها تسقط عنه قشرة الوقار والاحترام، فيُستهان به. غير أن هذه المقولة قد تؤخَذ على مَحمَل أبعد وأعمق من كل هذا، حين نتأمَّل ما يتعرَّض له وجدان البشر في عصر الإعلام المرئي والبث المباشر والمتواصل على مدار الساعة.
قد يُفهَم من مثل “الاعتياد يُولِّد الاستهانة” أن اعتياد المآسي والجوائح التي تضرب المدن والمجتمعات ليل نهار على الشاشات وعبر الوسائط المختلفة، يُسرِّب لقلوبنا حسًّا بالاستهانة واللامبالاة، ويودي بنا إلى حالة من قلة التعاطف مع ما يحدث أمام أعيننا، مهما اعتقدنا في أنفسنا الرحمة والحس الإنساني السليم.
لنتصوَّر مثلًا أن مجاعةً ضربَت إقليمًا في أفريقيا، فأخذ الإعلام المرئي ينقل صور الأطفال الجياع، بارِزي العظام، مُنتفِخي البطون، على مدار اليوم عبر القنوات والمنشورات و”الميمات”، بل وحتى النِّكات ورسومات الكاريكاتير؛ كيف يكون وَقْع هذا الحدث المأساوي على نفوسنا؟ لا بد أننا نستاء لأول وهلة، بل قد نُصاب بغُصة تُشبِه في أثرها لسعة سلك كهربائي عارٍ. ثم ماذا؟
مع توالي النشرات وتكرار الصور والفيديوهات عبر كافة المنصّات، سيتسلّل إلينا الفتور، ستفرغ بطاريات التعاطف قليلًا بقليل، حتى لا تعود اللسعة محسوسةً من الأساس، ومع تتابع المآسي والنكَبات التي تضرب الكوكب هنا وهناك، سنكتسب حصانةً نسبية إزاء هذا النوع من التأثُّر؛ لن تعود مشاهد الجماعات المنكوبة بالحروب والتهجير والأوبئة والزلازل والتسونامي وغيرها تؤثر فينا مثلما كانت في وقت سابق، إذ تجاوزنا هذا الشعور بفضل الاعتياد وما تولَّد عنه من استهانة.
فن تثبيت الزمن

التعاطف هو أحد الدوافع النفسية والروابط الاجتماعية التي لطالما ميّزَت المجتمعات الإنسانية، وساهمَت بدور محوريّ في استمرارية البشر وتقدُّمهم على جيرانهم فوق كوكب الأرض، فبغير التعاطف ما كان لأفراد الجماعات البشرية أن يتكاتفوا في مجابهة الضواري والتقلبات المناخية القاسية، وأن يقوموا بهجرات طويلة يواجهون خلالها كافة الصعوبات، وأن يتحمَّلوا عبء الصغار والمسنّين لسنوات طوال، حتى استزراع المحاصيل واستئناس الحيوانات ما كان ليتحقق إلا بشيءٍ من التعاطف مع الأرض والكائنات.
يمكننا أن نلاحظ هذا النازع البشري الأصيل والهام في الكثير من الطقوس والسلوكيات التي كشفَت عنها الأبحاث الأنثربولوجية، وكذلك في الموروث الشِّعريّ والغنائي المنقول عبر العصور، حتى الفلسفات والأيديولوجيات التي وضعها المفكرون يقوم الكثير منها على أساس من التعاطف والانحياز الطبقيّ والعنصري أحيانا.
لذا يكون من الخطورة بمكان أن تُستَنزَف هذه الطاقة البشرية الخاصة والجوهرية في تأسيس المجتمعات، بأن نجعلها عُرضة للتآكل والتلاشي أمام هجمات الاعتياد التي تُصدِّرها الشاشات والمنصات ليل نهار.
الفن هو أنجع لقاح يقي البشرية من ذاك الفايروس اللعين؛ فايروس اللامبالاة، إذ نادرًا ما يتعامل الفن مع البشر كجماعات وزرافات، بل غالبًا ما يُركِّز على شخص بمُفرده، أو على عدد محدود من الأفراد في ظروف محددة، حيث يعكس عبر حكاياتهم وخصوصية تجاربهم فكرةً أكثر عمومية.
لنتأمَّل مثلًا لوحة بابلو بيكاسو الشهيرة “غرنيكا” التي استوحاها من قصف الطائرات الحربية التابعة لقوات فرانكو وحلفائه الألمان والإيطاليين الفاشيين لقرية غرنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
لو وقعَت مثل هذه الحرب اليوم لتابعنا مشاهدها عبر نشرات إخبارية موقوتة ومنتظمة مسبوقة بتترات موسيقية محفوظة مكررة تُهيئ المشاهد لتقبُّل الفواجع التي ستُعرَض عليه خلال الدقائق التالية، حيث تُستهلُّ بملخص لما سيشاهد “في هذا الموجَز” أو خلال “هذه النشرة الإخبارية”، كأنه يتلقى مصلًا ضد أي تعاطُف ممكن، ثم تتوالى المشاهد السريعة التي تلتقط الحدث من زوايا بعيدة وكادرات عمومية، وسرعان ما تُختتَم النشرة بأخبار الفن والرياضة كنوع من الترويح تمهيدًا للعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية، فينتهي الأمر كأن شيئًا لم يكن.
نادرًا ما يتعامل الفن مع البشر كجماعات، بل غالبًا ما يُركِّز على شخص بمُفرده أو على أفراد محدودين
هكذا يتكرر الأمر كل ساعة حتى نتخلَّص من أصغر شُبهة للتعاطف والتأثُّر، ونستحيل بشرًا لطفاء سعداء غير مبالين.
أما لوحة بيكاسو فلم تلعب مثل هذا الدور “الوقائي” المخفِّف لأثر الفواجع والمآسي الإنسانية لمتستخدم الحقائق في صناعة الكذب كما يفعل الإعلام المرئي، بل إنها صنعَت العكس على وجه التحديد، فكما يقول بيكاسو “جميعنا يعرف أن الفن لا يقول الحقيقة؛ الفن كذبة تجعلنا نُدرك الحقيقة”. ونِعم الكذب ما قاله بيكاسو عبر لوحته الشهيرة “غرنيكا”.
تلك الجدارية الرهيبة التي يتوقَّف أمامها زوار متحف الملكة صوفيا للفن الحديث، فلا يستطيعون الإشاحة بأبصارهم بعيدًا عن الفجيعة الماثلة أمامهم في كل تفصيلة رسمها بيكاسو بطريقته التكعيبية المذهلة على الجدارية الهائلة التي تُحيل ملامح البشر والحياة لمزقات يمكن تفكيكها وإعادة تثبيتها في وضعيات غريبة ومفزعة؛ هل ثمة ما يعكس بصدق بشاعة الحرب مثل كذبة بيكاسو؟
في “غرنيكا” تصرخ المرأة التي تحمل رضيعها الميت في يسار اللوحة، فيما تتساقط عيناها على هيئة دموع تهوي من وجهها، ويرقد الجندي مبعثر الأطراف في أسفل اللوحة – تحت سنابك الحصان – عاجزًا عن الوصول إلى المرأة الصارخة، ممسكًا بمقبض سيف مكسور تنبت منه زهرة شائهة.
أما المرأة في يمين اللوحة فتبدو كأنما تسقط وسط الحرائق التي سببها القصف، فيما تتساقط ملامحها وفتحتا أنفها على هيئة دموع مبعثرة. المرأة الوحيدة التي لها ملامح معتدلة لم تسقط بعد من مواضعها، هي تلك التي تدخل المشهد عبر كوة في الجدار، حاملةً مشعلًا صغيرًا لا يُشع منه أي ضوء، بل يبدو منطفئًا تمامًا في حضور المصباح الكهربائي الكبير المهيمن على المشهد، والذي يُشع ضوءًا على هيئة عين كبيرة متوحشة.
ثمة حصان صارخ، وثور مفزوع غير مصدِّق، كما هنالك طائر معذَّب الملامح مبعثَر الجناحين. على هذا النحو يُثبِّت بيكاسو اللحظة الزمنية المفجعة، في ملامح شخصياته كما في عموم الجدارية الهائلة، ليُجبر الناظر إليها على الوقوف أمام كل حالة على انفرادها، عوضًا عن العبور بعجالة على مشاهد عمومية تُجمل البشر والأنقاض والأشلاء في كومات بلا ملامح يمكن نسيانها أو التجاوز عنها بسرعة موجَز إخباريّ.
سينما تواجه الأخبار

تخوض السينما مواجهات عديدة لحملات التطعيم ضد التعاطف ونشر أمصال اللامبالاة التي تُشرف عليها نشرات الأخبار كل يوم.
جميعنا شاهد لقطات من الحربين العالميتين الأولى والثانية عبر نشرات وبرامج إخبارية في مناسبات شتى، ولا بد أن العديد منا قد لاحظ كيف تبدو بعض المشاهد ذات الكادرات المفتوحة والإيقاع الأسرع من المعتاد، كرتونية على نحو ما، كأنها تنتمي لفيلم من أفلام شارلي شابلن. أما الأفلام السينمائية التي تناولَت الحربين فلا تسمح للقاح اللامبالاة بالتسرُّب لأوردة المشاهدين لحظة واحدة.
لنا مثال في فيلم “دَنكيرك” للمخرج الكبير كريستوفر نولان الذي يتناول عملية إجلاء قوات الحلفاء من ساحل دنكيرك الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. يُقحمنا أحد المشاهد السينمائية داخل كابينة طائرة حربية، لنُعايش طيارًا فيما يواجه طائرةً مُغيرة يُفلِت بالكاد من صاروخها الموجَّه لذيل طائرته، ومن نيرانها التي تكاد تلتهم جناحه، بل نُعاينه فيما يتلقى قذيفة مصوَّبة بدقة تهوي بطائرته في قاع البحر. لا يمكننا نحن المشاهدون إلا التعاطف مع هذا المقاتل في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، غير أننا نضع أنفسنا في داخل كابينة طائرته، نخشى على حياتنا، ونحمد الله على سلامتنا فيما نتمنى له المثل.
حتى المشاهد التي تُصوِّر الجموع لا تسمح لنا برفاهة تأمُّلهم ككومة باهتة من الجنود النمطيين، بل كبشر متباينين، متصارعين ومتعاركين، تلمع في عين الواحد منهم نظرة مرعوبة من طائرة تُقبل على الشاطئ، بينما تُفصح عينا زميله عن إصرار لا يلين على المقاومة، فيما يُبدي ثالث نظرات لا مبالية تبوح بالاستسلام.
أما في قعر السفينة المشرفة على الغرق، فالجنود المنتمون لنفس الجبهة يتصارعون في ما بينهم، مَن منهم سيقوم بمعالجة الثقب الذي سيُغرق الجميع؛ فالجميع خائف، أناني، ينازع من أجل الحياة ولا يُبدي جسارة كافية إزاء الموت، لذا نُدفَع رغمًا عنا إلى التعاطف معهم مهما تصرفوا بشراسة وهمجية وأنانية مقيتة، فنحن مثلهم لا نريد الموت، نستمسك بالحياة إذ نجد أنفسنا مكبَّلين في ظروف ليست من اختيارنا، تمامًا مثل شخصيات لوحة بيكاسو المفزوعة المبعثرة.
أدب يُجابه اللامبالاة

باستطاعة الأدب، في صورته المثالية، أن يقوم بما هو أبعد من ذلك، فعلى عكس الفنون البصرية مثل الفن التشكيلي والسينما، يغوص الفن السردي والشِّعري بحُرية أكبر داخل النفس البشرية، فيكشف عن خباياها التي قد تولِّد المزيد من التعاطف والتأثُّر في نفس القارئ والمتلقّي.
فها هو تشيخوف في قصته “لمن أشكو كآبتي” يصوِّر الحوذي العجوز مُقوَّس الظهر أيونا، الذي توقَّف حتى عن إزاحة ندف الثلج التي تتساقط فوق معطفه وتغوص به في المزيد من البرودة والوحدة، والذي يسعى لأن يُشرِك أيَّ شخص آخَر في مأساته؛ لقد مات ولده في المستشفى ليلة أمس ولا يجد مَن يستمع إليه ويتعاطف مع بؤسه.
يشرع الحوذي في قصِّ حكاية ولده على الشبان الذين يستوقفونه في شوارع المدينة الغارقة في البياض البارد، فينهرونه ويزجرونه حتى يُسرع بتوصيلهم إلى مبتغاهم دون ثرثرة مملة، بل ويسبّونه ويُطلقون عليه النكات القبيحة، ولا يدفعون له ما يكفي من المال لإطعام فرسه الهزيل.
السينما تخوض مواجهات عديدة لحملات التطعيم ضد التعاطف ونشر أمصال اللامبالاة التي تُشرف عليها نشرات الأخبار
غير أنه لا يهتم لذلك، بل يسعى للبحث عمَّن يُفضي إليه بوجعه، فيعود إلى الإسطبل ويبحث عن حوذي زميل يبُثُّه أحزانه، فيجدهم يغطون في النوم غير مبالين، ولا يجد في النهاية إلا الحصان لكي يستمع إليه ويهزُّ رأسه في تعاطف متوَهَّم.
في الحياة الواقعية قد لا يُثير في نفوسنا هذا الحوذي العجوز ذو المظهر البائس والقيادة البطيئة إلا الضجر، غير أنه سيُثير الشفقة والتعاطف لا محالة حين يوضَع تحت مجهر الفن ويتعرَّض لجهاز أشعة الكتابة الإبداعية. فما بالنا لو خاض بنا الأدب غمار الحروب وأقبية السجون، ما بالنا لو عبر بنا وحلَ مرضٍ فاتك، أو لُجَّة عشق مقموع، من المؤكَّد أن بإمكانه أن يحملنا ليس فقط على التعاطف بل على ذرف الدموع.
قد لا يكون باستطاعة الفن أن يُنقذ العالم من الحروب، من الأوبئة والزلازل والبراكين، لكن بإمكانه أن يُنقذ البشر من الفتور، من العدمية واللامبالاة، من فخ الاعتياد ومعرَّة الاستهانة.