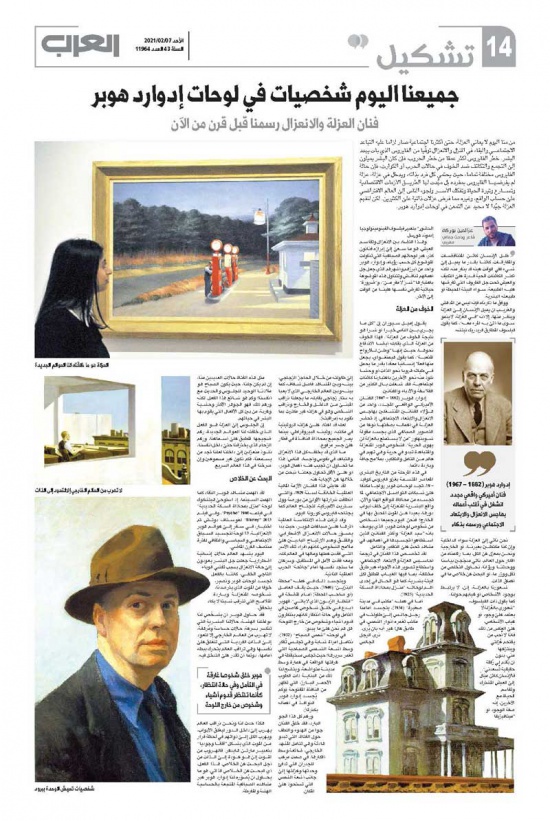حيوية الشعر الجديد بين كتابة الدفقة الأولى وآليات الاشتغال

غيّرت الثورة التكنولوجية أدوات الكتابة من الورقة والقلم إلى الكتابة على الشاشة عبر مفاتيح رقمية، كما سهلت وسائل التواصل الاجتماعي نشر النصوص الأدبية ولاسيما الشعر، حيث صار الشعراء ينشرون قصائدهم طازجة مباشرة بعد لحظة الإبداع، لكن هذا وإن كان نوعا من التفاعل المباشر مع القراء، فإنه يخفي الكثير من العثرات، خاصة في غياب التنقيح والتعديل اللازمين لكل نظم شعري، حيث لا كتابة رصينة دون محو وتعديل.
تتجه الكتابة الشعرية الجديدة في أغلب نماذجها إلى أن تكون وليدة لحظتها، متمردة على الهندسة الصارمة، ومتوسلة السيولة والعفوية والبكارة والنزعة الطفولية، وهي ملامح مقترنة عادة بالكتابة الأولية، التي تأتي متدفقة قبل التشذيب والتنقيح والتدخل الحسابي، خصوصا مع انتشار البث الإلكتروني، وضخ النصوص مباشرة بعد كتابتها على صفحات السوشيال ميديا.
ومع توهّج بعض هذه النصوص ورهافتها، فإن هذه الكتابة الأولى المنفلتة، في الكثير من وجوهها، قد تشوبها الثرثرة، بالرغم من قصرها، والمجانية، والتهويم العاطفي، والفيوضات المتداعية خارج كثافة اللحظة المرجوّة وفرادتها، الأمر الذي قد يقتضي أحيانا المراجعة، والتدخل الذهني الواعي، ربما بقسوة، بالحذف والمحو والاشتغال والتعديل.
النشر الرقمي
في ضوء عدم وجود اتفاق على جوهر العملية الشعرية وماهيّتها وميكانيزماتها، يتجدد السؤال: أين تكمن حيوية الشعر، ومادّته الخام، في المقام الأول؟ وإلى أي مدى أثّر النشر الرقمي عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على هذه الثنائية المُربكة في توازنات القصيدة المتأرجحة بين: شطحات الدفقة الأولى، وآليات الاشتغال؟
انتابت الطرق التقليدية للكتابة تغيرات كثيرة في عصر الرقمية وثورة المعلومات ووسائط النشر الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة. وإلى جانب التحولات التي شهدتها فنون وآداب راسخة فتحت صدرها للأصداء الرقمية مثل الشعر والقصة والرواية، ظهرت ألوان مبتكرة تلائم مرحلة ما بعد الورق، وهي التي تندرج في إطار الأدب التفاعلي الإلكتروني.

وأسهم النشر الرقمي عبر مواقع الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا وغيرها في انتشار النصوص العربية المختزلة، تحت مسمّيات متنوعة، من قبيل: قصيدة الومضة، الشعر المضغوط، قصيدة النانو، الهايكو العربي، وغيرها من الأنساق التي ظهرت ورقيّا في بادئ الأمر، ثم تضاعف حضورها في الفضاء الإلكتروني، خصوصا بعد انتشار التصفح عبر الشاشات الصغيرة، الموبايل، التابلت، أجهزة كندل، التي يناسبها المحتوى المكثّف.
مثل هذه الصيغ الشعرية، وغيرها، المتكئة على الوميض البرقي الأخّاذ، واستلاب الحواس من النظرة الأولى، مالت أكثر إلى اعتماد الفلسفة الارتجالية في الإبداع، ومبادئ التداعي الحرّ لدى السورياليين، حيث الإنجاز العفوي المباشر للأفكار والخواطر، والتعبير عن الحالة من غير تهيئة مسبقة ودون تنقيح أو إعادة صياغة، واقترن ذلك التوجه باستخدام الشاعر الكيبورد لتأليف نصوصه وبثها لحظيّا بشكلها النهائي.
وتُراهن هذه النصوص الشعرية على الطزاجة والانفلات من الأطر الجاهزة ورفض الخلطات المعدّة سلفا، وحققت سيولة حقيقية أنعشت الشعر وانتشلته من جموده، لكن الإسهاب في تداعيات اللاوعي والانتقالات غير المتوقعة قد يقود في بعض الأحيان إلى ما سمّاه قديما الناقد محمد مندور “الطرطشة العاطفية”، بمعنى الإفراط في التهويم والانزلاق إلى أمور فرعية، فتتوه القصيدة وتضيع بؤرتها الضوئية المشعّة، وحتى إن كانت ذات كلمات محدودة، فإنها تفقد تركيزها وتأثيرها.
رفعت مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا أسهم الإبداع اللحظي والقصائد الخاطفة على حساب الذهنيات المتكلسة، وهنا تزداد أهمية تفهّم أين تكمن حيوية الشعر الموجودة بذاتها، وكيف يمكن للشعراء الجدد استثمار وقود الدفقة الأولى البريئة من دون التشتت في انجرافات وانحرافات عن المسار.
سطوة الافتراضي
يرى الكاتب والناقد المغربي عبدالمنعم الشنتوف، أن الإبداع الشعري لا يمكن تمثله إلا بوصفه كيمياء رائعة تتخلق من تفاعل ذي طبيعة مركبة ومعقدة للذات مع أشياء وظواهر للحياة والوجود.
ويقول في تصريح لـ”العرب”، “باعتبار ذلك، يكون خلق القصيدة أشبه بمخاض مدموغ بجرعات من المعاناة واللذة في آن. وحيث إن القصيدة تتأسس على وسيط اللغة وتستثمر التخييل بوصفه حدسا بالعوالم الممكنة وانزياحا عن الواقع وإكراهاته، فإن استسهال كتابتها يبقى فعلا مستهجنا، ويستلزم اقترابا نقديّا أكثر صرامة، خصوصا تحت تأثير ما أفرزته الثورة الرقمية وتداعياتها المذهلة في سيرتنا اليومية بمختلف تجلياتها الاجتماعية والثقافية”.

كان للانتشار السريع للهواتف الذكية وتطبيقاتها المذهلة وتنامي الحضور القوي لوسائط التواصل الاجتماعي دور كبير في خلخلة الرؤية إلى العالم والعلاقات الإنسانية، وأصبحت الحياة مدموغة بسطوة الافتراض واقتضاءاته، ولم تكن الكتابة الإبداعية بشكل عام والشعر بخاصة بمنأى عن هذا التأثير بمنحييه؛ السلبي والإيجابي.
وأشار الشنتوف إلى أنه صار من المألوف أن تمطرنا صفحات الفيسبوك بطوفان من النصوص المصنفة شعرا، وتفتقر إلى أدنى مقومات الشعرية، حيث أصبح استسهال النشر على جدران الفضاء الأزرق قاعدة في ظل غياب وانحسار وشللية النشر التقليدي في المنابر الثقافية من مجلات وملاحق ثقافية، وهنا تُطرح إشكالية ركون الشاعر لمراجعة أو تنقيح نصوصه قبل نشرها رقميّا، وكان قديما يطلق على هذه العملية مصطلح “التحكيك”.
يعتقد الناقد المغربي، أنه يمكن للثورة الرقمية وكشوفاتها أن تسعف الشعر بتحقيق وضمان انتشار أفضل، شريطة الابتعاد عن الإسفاف والضحالة والعجلة والادعاء، والشاعر الحقيقي هو الذي يعي قيمة ما يبدعه، ويحترم القارئ، ولا يمكنه إلا الركون إلى الأناة وإخضاع نصوصه للتنقيح والمراجعة قبل نشرها في الفضاء الأزرق أو غيره من الوسائط الرقمية.
وفي رأي الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبوسعدة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصة للكثيرين ممن يمتلكون موهبة الكتابة ومن يحترفونها، وممن أيضا لا يفقهون عنها شيئا، فقد أصبحت مكانا للعرض والقراءة وللوصول الأسرع إلى القارئ، فنجد القصائد والنصوص النثرية والومضات الإبداعية والخواطر، وكل يختلف في طريقة عرضه وكتابته ورؤيته، ونجد الكثير من النصوص العفوية أو وليدة اللحظة التي لم تخضع للتنقيح بعدُ.
وتؤكد أبوسعدة، لـ”العرب”، أن هذه النصوص هي الأصدق، “بعد تجربة ثلاثة دواوين، أدرك جيدا أن التنقيح والتشذيب والحذف بعد الدفقة الأولى يُكسب النص نضجا وقراءة أفضل بكثير عما كان عليه النص في الوهلة الأولى، لأننا نتخلص ساعتها من الحشو الزائد والزخارف التي تنقص من جودة النص، لهذا عندما نُخضع النص لقراءة ثانية وثالثة بصوتٍ عالٍ، نجد أننا نستطيع أن نصل به إلى الأفضل، ما يُكسب القارئ جمالية أكبر، واستمتاعا أكثر”.
فقدان الضوابط

يوضح الشاعر اللبناني بلال المصري أن النشر الرقمي فتح الباب واسعا أمام مختلف التجارب الشعرية، وأفرز منها الغالي والنفيس دون أي ضوابط، ما أدى إلى توسعة المشهد الشعري العام، أو لنقل إن صح التعبير انفجارا هائلا أحدثته الثورة الرقمية، وقد لا تنتهي آثاره على الإطلاق، مع استمرار النشر الإلكتروني، وستستمر تداعياته في خلق العبث والمجانية، جنبا إلى جنب مع كتابات أخرى قيمة، تشكل التشظي الدائم مع استمرار حركة النشر الإكتروني.

ويوافق بلال المصري الكاتب الروسي مكسيم غوركي الذي قال “إن الكاتب السيء مثل الكاتب الجيد يجب أن يُعرّف”، بمعنى آخر، من حق الجميع التعبير عن أنفسهم وتقديم ما لديهم من كتابات، لكن اللافت في قول غوركي أنه لم يكن في عصر النشر الإلكتروني، بل قبل ذلك بكثير، ما يجعلنا نتوقف عند مسألة مهمة للغاية، وهي أن الأمر برمته لا علاقة له بالوسيلة التي ننشر بها، إنما بالكاتب نفسه، فقد نجد كتبا ورقية كثيرة من هذا الطراز الذي تحدث عنه.
في النشر الإلكتروني، المسؤولية كبيرة على المتلقي الذي يجب أن لا ينجرف خلف المجاملات، لأنه بذلك يضر الكاتب ويضلل الجمهور العام. وأغلب التعليقات تحمل الكثير من المجاملات التي لا تمت لحقيقة النص المشار إليه من خلالها، وهنا مشكلة كبيرة جدّا، تعكس كمّا هائلا من النفاق الفارغ والتضليل، وخطورة النشر الإلكتروني، حيث يصبح النص الشعري رهين التعليقات والإعجابات التي تنهال عليه، دون مصداقية حقيقية تعبر عن قيمة النص.
معيار نشر القصيدة بالنسبة إلى بلال المصري هو نفسه، سواء أكان النص ورقيّا أم إلكترونيّا، ويقول “أقيّم نصي، وأعيد تقييمه مرارا، وأحيانا أنشر النص القصير بشكل مباشر على وسائل التواصل، فقط عندما أكون متأكدا من جودته”.
وبحسب الناقد المصري محمد سمير عبدالسلام، فإن الكتابة الشعرية، وأي نوع من أنواع الكتابة، بما فيها النقد، لا تقع منعزلة عن علاقات القوة الثقافية والتكنولوجيا، وإيقاع العصر، بالإضافة إلى الجانب الذاتي في الكتابة.

ويذكر عبدالسلام في تصريح لـ”العرب” أن “تطبيقات المحمول، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وانتشار المدونات، والصفحات الشخصية، أسهمت في التعزيز من سرعة إيقاع الكتابة، والنشر، والتعديل المستمر أيضا على ما تم نشره؛ وهو أمر واقع بالفعل، لكنه لا يعني حدوث عملية تطوير جمالي في بنية القصيدة؛ فهذا الأمر يحتاج وقتا طويلا من القراءات المنظمة لمدارس الشعر العربي، والعالمي، ومحطاته الرئيسية، وللحاصلين على جوائز نوعية في الشعر؛ مثل جوائز نوبل، وبوليتزر، وجائزة ت. أس. إليوت في الشعر؛ فضلا عن متابعة الشعراء الذين مثلوا محطات نوعية في مسيرة الشعر العربي، والعالمي”.
أما مسألة سرعة الكتابة أو العفوية، فقد وجدت بصور متنوعة في التيارات الحداثية الدادائية، والسوريالية، في سياق مختلف عن سياق التكنولوجيا الراهن.
وكان للراحل مصطفى سويف كتاب قيم في هذا المجال، تتبع فيه نشأة العملية الإبداعية في النفس وتطورها التدريجي عبر مقابلات، واستبيانات قدمها مع عدد من الشعراء، وعنوانه “الأسس الفنية للإبداع الفني” في الشعر خاصة، ولا نزال نحتاج إلى من يواصل هذا الجهد، الذي أسهم فيه أيضا د.يحيى الرخاوي، ود.شاكر عبدالحميد.
حجم الموهبة
يرتبط السؤال الملحّ دائما بماهيّة الشعر وطبيعته في كل عصر تبعا لمستجدّات هذا العصر الجديد وتطوّراته، وهو أمر يُفضي حاليا إلى البحث عن هذه الماهيّة الشعرية في عصر ثورة المعلومات والرقميّات.
ويلفت الشاعر والناقد السوري مازن أكثم سليمان، لـ”العرب”، إلى أنه يُفترض أن تكون لحظة الكتابة الشعرية الأُولى لحظة إبداعيّة ينبثق فيها النص طازجا مُبدِعا متعدد الأبعاد الفنية، ولعل هذه المسألة تتعلق بحجم الموهبة وقدرة الشاعر الذاتية على الابتكار والإبداع.

وإذا كان الاشتغال على النص يعني، ربما، إعادة خلقه من جديد، فإن هذا الخلق الثاني ينبغي أن ينهض على أساس خلق أوّليّ أصيل؛ فإذا غاب الانبثاق المُبدع في البداية، نقُصت الموهبة، وتراجَعت المُستويات الفنية والجمالية والمعرفية.
ويمثل التدخل التنقيحي والتَّشذيب والتَّعديل والعمل على النص المحاور الضرورية، مهما بلغ إبداع الشاعر، لكن الاشتغال على أساس مبدع شيء، وترقيع نصّ مُهلهل فنيّا وضعيف تخييليّا شيء آخر.
وقال مازن “كلما ازدادت الدّربة والخبرة والموهبة الإبداعيّة، خرج النص شبه جاهز إلى الحياة بحيويّة لا يُغيِّرُ من ماهيته النشر الرقمي في العالم الافتراضيّ، فالشعر المُبدع هو نفسه في الرَّقميّات وعلى الورق وفي العالم الواقعي”.
وشدد الشاعر السوري على أن ثوابت الإبداع الشّعريّ لا تتغير في عصر الرقميات نوعيّا؛ إنما شكليّا، ويبقى الزمن دائما عاملَ حسمٍ وتصفية بين النصوص الأصيلة والنصوص الطّارئة السَّطحيّة، مهما طغى صخب الاستهلاك والانتشار الإلكترونيّ، حيث تظل حيويّة الشّعر منوطة بطاقة المُبدع الأوَّليّة، وهيَ أشبه بطاقة عموديّة ابتكاريّة تأسيسيّة، تتقاطعُ معها في مرحلة تالية طاقة أفقية مُرتبطة بالتَّشذيب والتَّدقيق والتَّنقيح والتدخُّل الحسابيّ، وهي أُمور يتقلَّص دورُها كلما كان الشّاعر مدجَّجا بالخبرة والموهبة التي تحمي نصوصه من الاستهلاك المجاني، وتحفظ لها حيويتها، وتحميها من أسر السُّيولة المفرطة، ووهم التّعيُّن السَّريع.