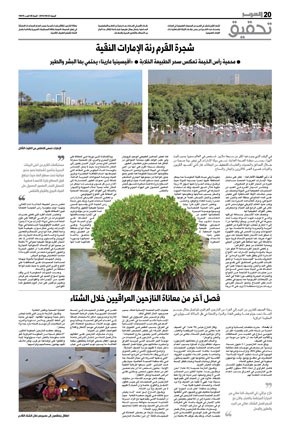تجارب مسرحية رائدة لقامات عربية تألقت كتابة وإخراجا

للدراماتورجيا في المسرح مجال دلالي واسع، فهي تدل على وظائف متعددة ظهرت تباعا مع تطور المسرح، والمصطلح مأخوذ من الفعل اليوناني الذي يعني “يؤلّف، أو يشكّل الدراما”، ويستخدم بلفظه اللاتيني في أغلب لغات العالم، وكذلك في اللغة العربية، لعدم وجود مرادف له، بل تستخدم مصطلحات أخرى تشير إلى فعالياته مثل: تكييف، أو إعداد، أو قراءة، أو كتابة. وفي الخطاب النقدي الحديث صارت تضاف، في بعض الأحيان، صفة الدراماتورجية على هذه الكلمات، فيقال “تكيييف دراماتورجي”، و”قراءة دراماتورجية”. وفي القرن السابع عشر كان مؤلف النص المسرحي في أوروبا يسمّى “الدراماتورج”، ومصطلح “الدراماتورجيا” يعني فن تأليف المسرحيات.
وتطور المعنى في ما بعد، مع انتقال مركز الثقل تدريجيا من النص إلى العرض، ومن مؤلف النص إلى معدّ العرض.
تجارب عالمية
تمثّل التجربة الألمانية في المسرح أول انفتاح في معنى الكلمة على مدلولات جديدة تتخطى عملية الكتابة لتشمل العمل المسرحي بمجمله، بما فيه عمل الممثل وشكل العرض.
وقد ميّز لسنج بين مؤلف النصوص المسرحية بالمعنى الذي كان سائدا، والدراماتورج، وبذلك خرجت الدراماتورجيا من الأفق المحدود لتأخذ معاني ودلالات أخرى أوسع، بحيث أصبحت تعني الاستشارة الأدبية، فالدراماتورج هو مستشار أدبي يهتمّ أساسا بالنصوص وبالمخطوطات الموجهة للعرض.
فالدراماتورجيا في هذا الإطار، تعني قراءة النصوص، وأحيانا ترجمتها أو إعدادها، وأصبحت توجد في تقاطع العلاقات التي يفرضها الإنتاج المسرحي: التأليف، الإخراج، النقد، الصحافة.
ثم جاء بريشت فطوّر أسلوبا في التحليل الدراماتورجي للنص، والعمل مع الممثل لكي يبدأ هذا المفهوم في الانتشار بمعناه الجديد، وصار مصطلح “دراماتورجيا” يغطي مجال المسرح كله بما فيه كتابة النص، وتحضير العرض، ودراسة تاريخ المسرح والنقد.
وخلال عمل برشت دراماتورجا مع المخرج ماكس رينهاردت صارت الدراماتورجيا تعني الوظيفة الأيديولوجية، بحيث اكتسبت دورا خاصا في الإنتاج المسرحي، فهو المسؤول عن الانتقال من النص إلى العرض.
ومن ثم أخذت الممارسة الدراماتوريجة تتقاسم مع الإخراج مهمة الإنتاج المسرحي، فحين يقوم المخرج بالإعداد التقني المشهدي للعرض المسرحي يقوم الدراماتورج بالإعداد النظري، خاصة بناء الحكاية، ويتولى مسؤولية التنسيق بين عناصر العرض.
المخرج التونسي فاضل الجعايبي تميز بإضفاء جمالية رفيعة على تجاربه التي تنهل من الواقع بجرأة
في المسرح العربي تعرضت وظيفة الدراماتورج، خلال العقدين الماضيين، إلى كثير من التشويه والتسطيح، إذ بدأنا نلاحظ ظهور اسم الدراماتورج مع المخرج في بعض العروض المسرحية، من دون أن يكون له جهد دراماتورجي حقيقي في التجربة، إما بسبب عدم إدراك الدراماتورج لوظيفته، أو بسبب دكتاتورية المخرج، أو لجهل الطرفين العلاقة بين عمل المخرج، وعمل الدراماتورج.
ولذلك بات الكثير من المخرجين يقومون وحدهم بنوع من القراءة الدراماتورجية من أجل التحضير للعرض، هذه القراءة يمكن أن نطلق عليها عملية “مسرَحَة” أو “تمسرح”، وقد اتخذ هؤلاء المخرجون الخيار الدراماتورجي طريقة في إبداعهم المسرحي، رغم اختلافهم في التجربة المسرحية منحى وأسلوبا.
فالمخرج العراقي صلاح القصب، مثلا، اجتهد “مخرجا دراماتورجا” طوال ربع قرن من خلال مسرح الصورة ونصوص عالمية، أغلبها كلاسيكي: هاملت، الملك لير، ماكبث، العاصفة، طائر البحر… معتمدا قراءة تأويلية تختزل النص، أو تعصف به، أو تنفيه أحيانا.
وقد شكلت هذه التجارب مغامرة فنية لم تكتفِ بإثارة اللذة الجمالية المتأملة، وبإطلاق أعلى حدّ ممكن من العلامات المسرحية الاعتباطية “الرمزية” فحسب، بل هدفت إلى استفزاز وعي المتلقي، وخلخلة ثوابته المعرفية، وكسر أفق توقعه، وإلى تعليق المعنى، أو إرجائه، بالمعنى الذي اجترحه ديريدا. وهذا ما يسوغ لنا أن نعدها التجارب المسرحية الأكثر قربا، في المسرح العربي، إلى تيار ما بعد الحداثة.
مسرحة عربية
اشتغل المخرج قاسم محمد في إطار التراث والثقافة الشعبية، إلى جانب نصوص شرقية وعربية، شاحنا إياها بدلالات إنسانية وقيم نبيلة مطلقة، من خلال صوغ مسرحي يقوم على الطقس الشعبي، والاحتفال، واللعب، والحكي، وغير ذلك من أساليب التعبير المحلي.
وتميز المخرج التونسي فاضل الجعايبي بإضفاء جمالية رفيعة على تجاربه التي تنهل من الواقع موضوعات في غاية الحساسية والجرأة، وأحيانا المسكوت عنها، أو غير المفكّر فيها، بسبب هامشيتها من وجهة نظر المبدعين التقليديين، فمن مسرحية “عرب” إلى “يحيى يعيش” مرورا بـ”العوّادة” و”فاميليا” و”كوميديا” و”عشّاق المقهى المهجور” و”سهرة خاصّة” و”جنون” و”خمسون”، ظل يُسائل علاقات شخصياته بذواتها وبالآخرين وبالمؤسسات وبتاريخ تونس وبعالمنا المعاصر.
في المسرح العربي تعرضت وظيفة الدراماتورج، خلال العقدين الماضيين، إلى كثير من التشويه والتسطيح
ووظفت مقاربة جواد الأسدي الإخراجية في عرض “المجنزرة ماكبث” فكرة القوة الغاشمة، في نص شكسبير، وهوس الهيمنة لتسليط ضوء رمزي على الوضع الذي عاشته المنطقة العربية خلال حرب الخليج الثانية، والتركيز على الكارثة التي نتجت عن الطغيان الأعمى.
وتخيّل المخرج سامي عبدالحميد فضاء جديدا تدور فيه أحداث مسرحية “عطيل”، في إخراجه لها، هو مطبخ في فندق درجة أولى، بوصفه بيئة مناسبة للصراع بين الأسود والأبيض، أو الصراع بين عنصرين: أحدهما ينتمي إليه عطيل، والثاني ينتمي إليه ياغو.
وعلى أساس هذا التخيّل كيّف نص شكسبير، وقدمه في تجربة إخراجية تحمل عنوان “عطيل في المطبخ” مفترضا عطيل رئيسا للطباخين (شيف)! بدلا من كونه ضابطا في الجيش الإيطالي، وياغو وكاسيو وزملاءهما طباخين أيضا، في حين افترض ديدمونة نادلة، ووالدها مديرا للفندق أو للمطعم.
وحذف من النص الأصلي كل ما من شأنه أن يشير إلى الأمكنة والمهن، ووزع الأحداث على المطبخ والمطعم، وجعل اللونين الأسود والأبيض علامتين مهيمنتين على كل شيء طوال العرض، ابتداء من أغطية الموائد، ومرورا بالصحون والقدور، وانتهاء بالمواد الغذائية التي تطبخ. وهكذا استثمر المخرج الكثير من العلامات اللونية في بناء سيميائي جدلي لتأكيد رؤيته الإخراجية، وفرضيته المتخيلة لطبيعة الصراع في العرض.