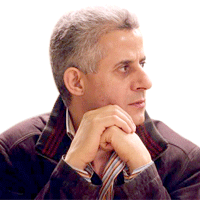المعلقات العشر قصائد تشبه الوثائق

قرون طويلة مرت على الشعر العربي منذ نشأته، تعاقب خلالها شعراء كثر على تصدر هذا الفن الممجد عربيا، ولكن قصائد المعلقات الشعرية ظلت خالدة إلى اليوم، ولم يزحها عن الذاكرة أي شعر جاء من بعدها، وهو ما يدعو إلى العودة إليها دائما ونشرها إلى قراء اللغات الأخرى ككنوز ثقافية عربية.
حظوظ الأمم من رواج إبداعها الكتابي محكوم بمكانتها في خريطة الحضارة، واللغة تسير بمحاذاة قدرة الأمة على إنتاج المعرفة، فمن ينجب ابنا يحق له وحده أن يمنحه اسمه. ولا تكفي مظاهر التحديث للدلالة على الانخراط في الحداثة، ولعل فاقدي الشيء يدمنون الإفراط في استهلاكه.
وقد جنى التراجع الحضاري العربي على الإبداع اللغوي، وحال موقع العرب الحالي دون تعرّف القارئ غير العربي على التراث الكتابيّ العربي الأقدم والأغزر مما تحظي به أي لغة. هذا الرصيد الثريّ يشمل الفقه والتاريخ والتصوف والفلسفة والعلوم السياسية والطبيعية والآداب، ومن أبرز ما تزهو به اللغة العربية المعلّقات التي صدرت في طبعة جديدة تستهدف جيلا جديدا.
صدور هذه الطبعة، غير التقليدية وعنوانها “المعلّقات لجيل الألفية”، يعيد المعلّقات إلى واجهة الإبداع الشعري، ويرسّخ مقولة “الشعر ديوان العرب”، باعتباره ذخيرة لغوية تمثل سجلا حيويا، للحروب والعادات والمعاملات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والعاطفية والصراع العشائري والتفاوت الطبقي والتمرد.
هذه النصوص التي أنتجت قبل أكثر من خمسة عشر قرنا لا تزال نابضة بالحياة، بفضل الغنى الكامن في اللغة، وطاقة الألفاظ على التجدد وحفظ المدلولات، حتى أن امرأ القيس في معلقته التي بدأها بقوله “قفا نبكِ مـن ذكرى حبيب ومنزل” أورد لفظ “الغبيط”، ومن تلك البادية سرى معناه، وعبر القرون وبلغ الريف المصري، وإن بدأ “الغَبيطُ” في الاختفاء، ليصير من ضحايا التحديث.
نصوص خالدة
أصدر “المعلّقات لجيل الألفية” مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع مجلة “القافلة” الصادرة عن أرامكو السعودية. في مجلد بالعربية والإنجليزية، (489 صفحة)، يضم المعلقات العشر لامرئ القيس، وطَرَفة بن العبد، وزهير بن أبي سُلمى، ولبِيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنترة بن شداد، والحارث بن حِلّزة، والأعشى القيسي، والنابغة الذبياني، وعَبيد بن الأبرص.
وفي مقدمة عنوانها “المعلقات في حضورها الدائم” قال محمد أمين أبوالمكارم نائب رئيس تحرير مجلة القافلة إن المعلقات العشر خالدات، تعبر زمانها إلينا، “تشكّل قاموسا للغة العربية ودستورا للنحاة، ومصدرا لمتعة لا تنتهي لأولئك المفتونين ببلاغة الفن اللفظي الرفيع.. وثيقة للمؤرخين وعلماء الاجتماع، ودليل للجغرافيين”.
النصوص التي أنتجت قبل أكثر من خمسة عشر قرنا لا تزال نابضة بالحياة، بفضل غناها اللغوي والجمالي
يحيي الكتاب أشهر عشر قصائد قبل الإسلام، ويقدم للقارئ مقدمات وشرحا ميسّرا، ويخاطب القارئ باللغة الإنجليزية التي ترجمت إليها المعلقات ومقدماتها، بواسطة “فريق من الخبراء العالميين في الشعر العربي.. وفي بعض الأحيان، تبدأ عملية من المفاوضات التأويلية بين الشارح والمترجم والمراجع لترجيح كلمة هنا أو حركة إعرابية هناك”، كما قال حاتم الزهراني المشرف على المحتوى إن اللغتين العربية والإنجليزية تقاسمتا “بهجة تأويل هذه النصوص الخالدة”، على أيدي أربعة شرّاح، وأربعة مترجمين هم: ديفيد لارسن بجامعة نيويورك، سوزان بينكني ستيتكيفيتش بجامعة جورجتاون، كفين بلانكنشيب بجامعة بريغام يونغ، هدى فخرالدين بجامعة بنسلفانيا. وإن هذه الترجمات “الجديدة بالكامل” وفّرت سياقا يناسب القارئ بالإنجليزية.
شرحَ المعلقات باللغة العربية كل من: سامي العجلان، وصالح الزهراني، وعبدالله الرُّشَيد وعدي الحربش. وعرّفت المقدمات بحياة الشعراء ومنزلتهم، وألقت أضواء على الأماكن والأشخاص الواردة بالمعلقات، وفسّرت سياق بيئتها وتاريخها بعد أن صارت نصّا إنسانيا.
وأطلق على المعلقة هذا الاسم، لاصطفائها ضمن عيون الشعر قبل الإسلام، وتعليقها على أستار الكعبة، وقد صمدت في اختبار الزمن، حتى صدورها ضمن مشروع أشرف عليه بندر الحربي رئيس تحرير مجلة القافلة، وضمت اللجنة الاستشارية كلا من سعد البازعي الأستاذ بجامعة الملك سعود، ومنيرة الغدير الأستاذة الزائرة بجامعتي هارفارد وكولومبيا، وروجر ألن أستاذ الأدب العربي بجامعة بنسلفانيا، وبياتريس غروندلر أستاذة الأدب العربي بجامعة برلين الحرة.
كنوز شعرية
وضع الكتاب عنوانا للمعلقات، فالمعلقة الأولى حملت عنوان “مغامرات الهوى والشباب” لامرئ القيس المصنّف من الطبقة الأولى من شعراء العرب، وهو مثال لبطل تراجيدي تقلب حياتَه حادثة، هي مصرع أبيه، فترك الأمير رغد العيش، وسعى إلى الثأر لأبيه الملك، إلى أن مات في أنقرة بعد لقائه بقيصر الروم، إذ ذهب إليه ليعينه على استعادة ملكه، ولهذا حمل لقب “الملك الضلِّيل”.
وتبدأ المعلقة بدعوة الشاعر لصاحبيه إلى الوقوف على أطلال أحبة غادروا المكان، “قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل”. ثم يترصد الشاعر لبنت عمه “عنيزة” ورفيقاتها لدى مرورهن بالغدير، ونجح شغبه معهن في تأخيرهن عن اللحاق بركْب العشيرة، ونحر ناقته لإطعامهن.
التقليد الفني في استهلال القصائد بالوقوف على الأطلال استنّه امرؤ القيس. وتستمد معلقته تجددها من عنايته بالتصوير البانورامي لمسرح الأحداث، من المعالم الجغرافية وظواهر الطبيعة إلى التفاصيل الصغيرة في المشهد، وهو في القلب منه، واصفا ضعفه ودموعه أيام الترف واللهو، ومجترئا على التصوير الحسي لمغامرته العاطفية، بعد نحْر ناقته، وذهاب الركب، واضطراره إلى تقاسم الهودج مع عنيزة. “ولما دخلتُ الخدر خدرَ عنيزة/ فقالت: لك الويلات إنك مرجلي. تقول وقد مال الغَبيطُ بنا معا:/ عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل”. ولكنه أصرّ على البقاء غير مبال بثلقهما على البعير، وتباهى بنرجسيته التي تجعل النساء شغوفات به، لا يشغلهن حمل ولا رضاعة.
انتقل “الغَبيطُ” من الجزيرة العربية إلى مصر، من الصحارى إلى الأرض الخصبة، وصار جزءا من قاموس الزراعة. كان لدى امرئ القيس يعني الهودج الذي يسعه مع عنيزة، وتحولت دلالته إلى وعاء من خيش أو قماش مقوّى ذي عدلين، يوضع فيه السماد أو التراب، وتحمله الدابة. وفي مقابل مشهدية حسية تفنن فيها امرؤ القيس بجسد المرأة، أفرط طرفة بن العبد في وصف ناقته، في معلقته التي يستهلها بقوله “لِخوْلةَ أطلال ببرقة تهمد”. وحملت المعلقة في هذا الكتاب عنوان “التمرد وفلسفة الحياة والموت”، إذ قُتل الشاعر شابا بأمر من ملك الحيرة. ورغم الوفاة المبكرة، يراه البعض تاليا في المكانة الشعرية لامرئ القيس.
قصيدة طرَفة هي أطول المعلقات العشر، ويتضمن نصها المعتمد 105 أبيات، منها واحد وثلاثون بيتا للتغني بمحاسن ناقته، “حتى يمكن أن يعد هذا الجزء وحدة موسوعية لغوية وثقافية عن الناقة وأعضائها، وصفاتها المستحسنة عند العرب”.

الكتاب يحيي أشهر عشر قصائد قبل الإسلام، ويقدم للقارئ بالعربية والإنجليزية مقدمات وشرحا ميسّرا
واستبدت الناقة الأسطورية بهذه المساحة بسبب الحالة النفسية لشاعر شاب متمرد حاصره الخذلان، وكانت ناقته “طوق نجاة.. تحولت إلى معادل موضوعي لكل رغبات طرفة غير المحققة، وآماله العريضة في الحياة المتخيلة التي أراد أن يحياها”. والبيت الثاني في معلقة طرفة “وقوفا بها صحبي عليّ مطيَّهُم/ يقولون: لا تهلِكْ أسى وتجلّد” يتطابق مع البيت الخامس في معلقة امرئ القيس، باستثناء كلمة القافية “وتَجمّل”. تضمين؟ إغارة؟ تحية؟
البيت الحادي والثلاثون، في معلقة طرفة، يوثق وعي الشاعر الشاب بمحيطه الجغرافي والحضاري. في وصفه للناقة يقول “وخدٌّ كقرطاس الشآمي ومِشفرٌ/ كَسِبت اليماني قدّه لم يُحرَّد”. يشبّه خدّ الناقة بصحيفة بيضاء يحملها رجل من الشام، “حيث يكثر النصارى المعتنون في ذلك العهد بالكتب والأوراق”.
وأما شفة الناقة المستقيمة المعتدلة فتذكّره بالسِّبت، وهو جلد البقر المدبوغ، “ونسبته لليمن تحلية له”؛ لأن اليمن كان “بلد الملوك وصناعة الجلد المتقدمة في ذلك العهد، فلا تجد فيها اعوجاجا في القطع، أو تفاوتا في المقادير”. في هذا البيت سردٌ مكتنز، أطول عمرا من الشاعر، وتجاوزا للبيان الفني، فيوثّق لحظة تاريخية تبرز جانبا من حياة العرب.
طرفة من شعراء استثنائيين استشعروا قرب النهاية، وكانت حياتهم شهبا. ففي صولاته واندفاعه في المعركة رأى موته قريبا، فأوصى ابنة أخيه “معبد” بما يجب أن تذكره من مناقبه في نعيه.
وفلسفة الزمن عنده أن الحياة كنز ينقص بمضي الأيام: أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة/ وما تنقص الأيام والدهر ينفد. وبقيت من معلقته إلى اليوم مأثورات: فإن كنتَ لا تستطيع دفع منيّتي/ فدعني أبادرها بما ملكت يدي. وكذلك: وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة/ على المرء من ظلم الحسام المهنّد. وينهي المعلقة بحكمة شيخ لم تتح له الأيام أن يكونه: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا/ ويأتيك بالأخبار من لم تُزوّد.
وفي ملعقة زهير بن أبي سُلمى التي حملت عنوان “أنشودة السلام” خلاصة تجربة حكيم بلغ الثمانين، “ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لكَ يسأم”. ويقول إن ما يكمته الناس في أنفسهم يعلمه الله، فيعجّل النقمة، أو يؤخرهم “ليوم الحساب”، ومن الحكم أيضا: ومن هاب أسباب المنايا ينلْنه/ ولو رام أسباب السماء بسلّمِ.
وفي مقابل “أنشودة السلام”، تنهض غطرسة عمرو بن كلثوم في معلقته وعنوانها “التباهي وأسئلة الحرية”، بادئا بفعل أمر: “ألا هبّي”؛ فتدور كؤوس الخمر، في استعراض للقوة والاستعلاء القبلي، أمام الملك المستبد عمرو بن هند. ويتردد فيها ضمير المتكلم بصيغة الجمع “وأنا الشاربون الماء صفوا/ ويشرب غيرنا كدرا وطينا”.