"المطابقة والاختلاف" مشروع نقدي يخرج الثقافة العربية من الصدام

تحكم الفكر النقدي العربي اليوم الكثير من الثنائيات، التي تبدأ من الأنا والآخر، ولا تنتهي من إنشاء المقابلات بين الأفكار والتصورات التي يحاول أغلبها كشف الاختلاف أو تأكيد التفاعل بين الذات والآخر، وبين العرب والغرب بصفة خاصة، وهو ما قاد إما إلى الانكفاء على الذات أو الذوبان في الآخر.
يبحث مشروع “المطابقة والاختلاف” للناقد العراقي عبدالله إبراهيم، بأجزائه الثلاثة الصادرة عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، في الروايتين الغربية والإسلامية حول الذات والآخر، مؤكدا على فكرة أساسية هي أن المركزيات تصاغ استنادا إلى نوع من التمثيل الذي تقدمه المرويات الثقافية (الدينية، والأدبية، والتاريخية، والجغرافية، والفلسفية، والأنثروبولوجية) إلى الذات المعتصمة بوهم النقاء الكامل، والآخر المدنس بالدونية الدائمة.
ويرى الناقد أن التمركز هو نوع من التعلّق بتصور مزدوج عن الذات والآخر، تصوّر يقوم على التمايز والتراتب والتعالي، ويتشكّل عبر الزمن بناء على ترادف متواصل ومتماثل لمرويات تلوح فيها بوضوح صورة انتقيت بدقة لمواجهة ضغوط كثيرة.
التمركز الذاتي
تكشف التحليلات المعمقة للمرويات الكبرى الطريقة البارعة للسرود التي تنتظم حول حبكة دينية، أو ثقافية، أو عرقية مخصوصة، مخضعة كل عناصر السرد لخدمة تلك الحبكة، التي تظل يقظة في إثراء تمجيدي للذات، وخفض تبخيسي للآخر.
هذا ما سوّغ لإبراهيم ضرورة الانطلاق من واقع العالم اليوم من أجل كشف الأسباب التي تتبلور فيها أفكار التمركز، كما هو الأمر بالنسبة إلى المركزية الإسلامية في الرهانات والسجالات القائمة في عصرنا، حيث يتطلّع مشروع الناقد إلى الالتحاق بالبحوث الفكرية، التي تسعى إلى البحث في معنى العالم، وتسهم في تفسيره، فلولاها لكان العالم، حسب رأيه، مازال مبهما، يشوبه الالتباس؛ فالمشاريع الفكرية تقترح تأويلا للعالم، ووصفا للمعرفة، وتتخطّى ذلك، في بعض الأحيان، إلى بسط مقترحات حول تغيير الأفراد والمجتمعات، وإعادة النظر في تواريخها.
وقد قطف العالم ثمار الكثير من البحوث الفكرية، وأفاد منها، وعلى الرغم من ذلك، أغلبها أمسى اليوم في ذمّة التاريخ؛ لأنها انتظمت في إطار نموذج (paradigm) خاص بعصرها، كالنموذج اللاهوتي، أو الميتافيزيقي، وما عادت فاعلة في العصور الحديثة، غير أنّها حفّزت الأفكار الجديدة إمّا لمعارضتها وإمّا لموافقتها، وإمّا لتخطّيها.
وبما أنّه لكلّ عصر نموذجه الفكري، يرى إبراهيم أنه من اللازم الاعتراف بأن عصر بناء الصروح الفكرية الكبرى قد انحسر، وبدأ يتوارى، وحلّ محله عصر النقد والتحليل؛ أي تحليل الصروح التي وُضِعت تحت تصرف الناس نظاما متّسقا من الفرضيات والنتائج. ولطالما ألهمته تلك الصروح بالطموح، وليس بالنتائج؛ فلكي يقع الإلمام بظاهرة كبيرة، كالمركزيات الثقافية، والدينية، والعرقية، ينبغي تمهيد الأرضيّة، ووضع الإطار المنهجي، واقتراح المفاهيم، ثمّ صوغ رؤية يصدر عنها الباحث في مقاربته لتلك الظواهر.
لقد انغمس الباحث في مشروع “المطابقة والاختلاف” نحو ربع قرن، بالتوازي مع غوصه في دراسة الظاهرة السردية باعتبارها ظاهرة ثقافية. ويعترف بأنه انخرط في دراسة المركزيات الثقافية، وهي تشكّل لبّ المشروع، وعالجها على مستويين؛ أولهما ظاهرة التمركز حول الذات في سياقها الثقافي والتاريخي، وثانيهما تحليل فرضيّاتها وبنياتها، والسعي إلى تفكيكها من أجل تفريغ حمولاتها الأيديولوجية. وكان يجري تعديلا على بعض أفكاره كلّما وجد حاجة إلى ذلك.
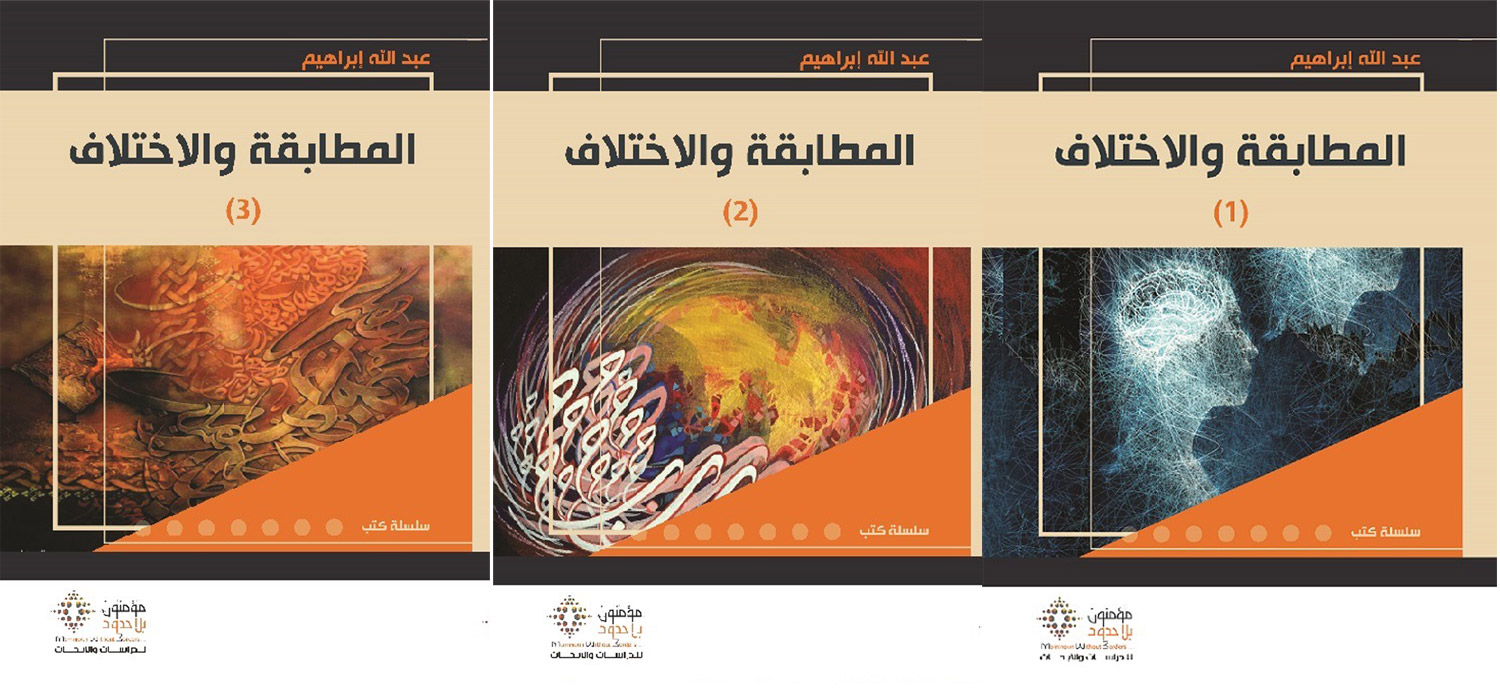
يتساءل إبراهيم في تمهيده للمشروع: كيف يمكن كشف صورة التطابق، التي تتّصف بها الثقافة العربية الحديثة مع المركزيات الكبرى: المركزية الغربية، والمركزية الإسلامية، أي المركزيات التي لها صلة مباشرة بثقافتنا؟
ويرى أن الجواب يكمن في الفحص النقدي، الدقيق والجريء، لمعطيات تلك الثقافة، وذلك الفحص سيكشف معضلة مكينة استوطنت نسيجها الداخلي، ألا وهي “مماثلة” الثقافة الغربية، من جانب، و”مطابقة” تصوّرات الثقافة الدينية الموروثة، بطابعها السجالي وليس العقلي – الثقافي، من جانب آخر.
فحيثما اتّجهت تلك النظرة في حقول التفكير المتعدّدة، لا تجد أمامها (على مستوى الرؤى والمناهج والمفاهيم) غير ضروب من “التماثل” و”التطابق” مع ثقافات استُعيرت من مرجعيات مختلفة مكانيا وزمانيا، فرضت حضورها وهيمنتها في المعطى الثقافي الحديث مباشرة، وتجاوزت ذلك إلى حدٍّ أصبحتْ فيه على صلة وثيقة بالتصورات التي تنتج ذلك المعطى، سواء أتمّ الأمر استنادا إلى مبدأ القبول أم تمّ استنادا إلى مبدأ الرفض وردّ الفعل.
ويعود ذلك، في ما يعود، إلى سببين رئيسين: أولهما يتّصل بهيمنة “المركزيات الثقافية الكبرى” ومحدِّداتها الأيديولوجية، وهي تمارس اختزالا لثقافتنا الحديثة، وثانيهما: الاستجابة السلبية لمعطيات تلك المركزيات، وعدم القدرة على التحرّر من فرضيّاتها الأساسية، والاختلاف المعرفي معها، وهو أمر يتعلّق بواقع الثقافة العربية الحديثة، التي رهنت ذاتها بعلاقات امتثالية لتلك المركزيات، ولم تفلح في بلورة أُطر عامة فاعلة تمكّنها من الحوار المتفاعل معها، فكانت تستعيد تصوّراتها دون مراعاة التباعد المرجعي والزمني.
الحاجة إلى الاختلاف
الثقافة العربية الحديثة رهنت ذاتها بعلاقات امتثالية للمركزيات الغربية، ولم تبلور أطرا عامة لحوار متفاعل معها
ليس المقصود بـ“الاختلاف” في هذا المشروع، كما يقول الناقد، الدعوة إلى “قطيعة” مع الآخر، ومع الماضي، والاستهانة بهما، واختزالهما إلى مكوِّن هامشي؛ ذلك أنّ القطيعة لن تحقّق إلا العزلة والانغلاق، والاعتصام بالذات ومطابقتها على نحو نرجسي مَرَضي لا يمكّنها أبدا من أن تتشكّل على نحو سليم ومتفاعل ومتطوّر، بل إن الاختلاف المقصود في هذا المشروع يوفّر حرية نسبيّة في ممارسة التفكير دون شعور بإثم الانفصال عن الماضي، ولا خشية التناقض مع الآخر، فهذه المخاوف التأثيميّة والتوجّسات أنتجتها ثقافة المطابقة، وهي مخاوف وتوجّسات تنهار دفعة واحدة إذا انتظمت الثقافة على أسس نقدية واعية وواضحة.
ومردّ الحاجة إلى “الاختلاف” رسوخ ثنائيات ضدّية خطيرة في صلب الثقافة العربية الحديثة، منها، على سبيل المثال: الأصالة والمعاصرة، الذات والآخر، الماضي والحاضر… إلخ. وقد تركت تلك المفاهيم أثرا مباشرا في الفكر انقسم الوعي بسببه إلى شطرين متضادين؛ بل متناحرين، حيث أصبحت تلك المفاهيم بذاتها «مرجعيات» ثابتة ونهائية، توجّه عمل الفكر، وتحدّد مجالاته، وتقوّم نتائجه، وكلّ منهما يعتصم بذاته في نسج براهين تؤكّد صوابه، وتسفّه أمر المفهوم المضاد.
ويؤكد إبراهيم أن النقد الذي يتطلّع إليه مشروع “المطابقة والاختلاف” هو ممارسة معرفية واعية تتوغل في تلافيف الظواهر الثقافية والدينية والعرقية، لتكشف أمام الأنظار طبيعة تلك الظواهر، وآلية الممارسات الخادعة التي تقوم بها، سواء في إنتاج ذات تدّعي النقاء كما تقول بذلك المرويات الإسلامية، أو في اختزال الآخر وفق نمط يوافق منظورها كما تريد المرويّات الغربية.
ومن ثم فإن المشروع يهدف إلى توسيع مديات الوعي في ما يخص طبيعة الظواهر الحاكمة في عالمنا المعاصر، وتخصيب تشعّباته النقدية، وإعطاء أهمية للبعد التاريخي للثقافات دون أسرها في نطاق النزعات التاريخية.
فالنقد، في نهاية المطاف، ممارسة تعي شرط حريّتها، وهو تفكير في موضوع التمركز غربيا أكان أم إسلاميا، من أجل إبطال نزعة التمركز وتكسير مقوماتها الداخلية، وفصل الوقائع المُختلطة ببعضها، والمُنتجة في ظروف تاريخية متصلة بـ“الذات” و“الآخر”.

ولا يتقصّد النقد إيجاد قطيعة شكليّة مع هذا أو ذاك، بل ترتيب علاقة نقدية وفق أسس حوارية وتفاعلية وتواصلية، بهدف إيجاد معرفة جديدة تقوم على مبدأ “الاختلاف”، الذي هو بديل لـ”المطابقة”، فيكون اختلافا عن خرافات الذات المتمركزة على نفسها وأساطيرها، ومسلّمات الآخر المتمركز ومصادراته ومغالطاته؛ فلا يمكن أن تكون معرفة “الآخر” مفيدة إلا إذا تمّ التفكير فيها نقديا، والاشتغال بها بعيدا عن سيطرة مفاهيم الإذعان والولاء والتبعية، وبعيدا عن أحاسيس الطهرانية الذاتية وتقديس الأنا.
وأخيرا، إنّ من الأهداف الأساسية لهذا النقد تغيير مسار التلقّي، الذي يقصد به الباحث الطريق الذي تأخذه الأفكار الأخرى للدخول في وعي الذات، فتتشكّل ضمنها، وهي حاملة معها دلالاتها، دون أن تخضع لمراجعة، حيث تحتفظ بمحمولاتها وسياقاتها الأصلية، وهو ما يُحدِث انقساما شديدا في الذات الثقافية، لأنّها لم تُكيّف تلك العناصر، بسبب غياب الإطار المنظّم والمكيّف القادر على إعادة إنتاج تلك العناصر، بما يجعلها مكوِّنات في هذه الذات، وليس جزءا غريباً عنها، ومهيمنا عليها، وما يحصل أنّ تلك العناصر ستمارس أفعالها كأنّها ضمن نسقها الثقافي الأصلي، وهذا يقود إلى تعريض مكوِّنات الذات إلى انهيارات داخلية، لأن تلك العناصر نُضّدت جنبا إلى جنب، ولم تركّب محمولاتها وفقا للشروط التاريخية للذات الثقافية.
إن وظيفة النقد المعرفي، حسبما يرى إبراهيم، تكمن في أن يسهم في تغيير مسارات التلقّي، ويقترح كيفيات لاندراج عناصر الثقافات الأخرى في الذات الثقافية، فالثقافة العربية أصبحت حقل صدامات لا نهائية بين المفاهيم والمقولات والرؤى والتصورات المستعارة، وذلك سببه عدم الاهتمام بمسار تلقّي الأفكار الذي يؤدّي إلى أن تحافظ المكونات الغريبة على نفسها دون الانصهار في نسق الثقافة الجديد الذي يحتضنها.




























