الظاهر بيبرس.. ملحمة بنكهتين مصرية وشامية

آخر حبات الثلج كانت عام 2018 عندما استقبلت القاهرة بطلها الأسطوري في معرض للفنان الكازاخستاني دوران كاستييف الذي قدم لوحات مفعمة بأجواء المعارك التاريخية التي خاضها مواطنه الظاهر بيبرس، وكأنما بالقاهرة تعلن تضامنها مع عشاق البطل الملحمي وتشاركهم البحث عن مسلك يبقي سيرة المملوكي الذي حكم عقول المصريين حية لا تموت.
ثمة أكثر من سبب مقنع ووجيه يجعلنا نعرّج على بطل السيرة الشعبية الظاهر بيبرس (1223 – 1277)، في مثل هذه الأيام من شهر الصيام: أولها أن هذا السلطان المملوكي كان الشخصية الوحيدة الموثقة تاريخيا ومازالت سيرته تروى على ألسنة الرواة والحكواتيين في سهرات المقاهي الرمضانية على الرغم مما اعتراها من تضخيم بلغ حد الأسطورة.
ثاني هذه الأسباب هو أن الصلاة كانت قد غابت عن الجامع الأزهر الذي مرت أكثر من ألف عام على إنشائه، ليس بفعل كورونا طبعا، بل بعد أن أطاح صلاح الدين الأيوبي بحكم الفاطميين، ولم تعد إليه إلا بأمر من السلطان الظاهر بيبرس، في العصر المملوكي.
أما الأكثر من ذلك هو أنه، وفي مثل هذه الأيام من شهر الصيام، فإن بيبرس كان يطعم كل ليلة خمسة آلاف شخص بحسب الرواة، وكان يناصر المستضعفين ويبطش بالظالمين فينزل من قلعة الجبل متنكرا للسؤال عن حال الرعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الإدارية التي أقامها.
عصر الدسائس

كل هذا، وإلى جانب انتصاراته على المغول والصليبيين، جعل من السلطان المملوكي بطلا قوميا وشعبيا تمجده السير الشعبية في مصر وبلاد الشام وغيرها فتغاضت عن أخطائه التي ذكرتها كتب التاريخ مثل أيّ زعيم يأبى الوجدان الجماعي أن ينتقده، فتنزهه عن كل شيء، رغم أن هذا المملوك قد وصل إلى سدة الحكم في عصر يعبق بالدسائس والمؤامرات والاغتيالات.. ولم يكن بيبرس بمنأى عنها.
ومثل سيرة كل بطل ملحمي لا شيء يبدو اعتياديا في حياة الظاهر بيبرس، بدءا من اسمه الذي لم يولد معه بل وهبته إياه الأقدار في رمزية تنضح ألغازا ودلالات (اسمه في البداية بيبرس البندقداري ثم محمود العجمي ثم الظاهر.. الخ). وتتعرج الأحداث وتتشابك ليختلط فيها الواقعي بالمتخيل، المنطقي بالسريالي، والروائي بالتوثيقي لتصنع عالما من الإدهاش فاق شرطية “الآن وهنا” في النسيج الروائي ليتخطّى حدود الواقع المعيش نحو حياة أخرى تسمح بها فلسفة التقمص التي تؤمن بانتقال الروح إلى جسد آخر بعد موت الجسد.. وهو ما يقيم الحجة والدليل على أن السيرة الظاهرية قد شارك في بنائها رواة آخرون قادمون من ثقافة تؤمن بمبدأ التقمص.
ربما كان دخول هذا الخط هندوسي الأصل على أن عشاق الظاهر بيبرس لا يريدون له الموت فأوجدوا له مسلكا نحو الخلود.
في أغلب الطبعات الشعبية، وحتى الحديثة التي تم تحقيقها، تبدأ السيرة الظاهرية بعبارات دينية تقول “الحمد لله الحق المبين، المحسن البر الأمين. السلام الذي سلم عن العقب والزوجة والبنين. الذي آمن به كل شيء”. ثم تنتقل بعد ذكر بعض الوقائع الخيالية في بغداد إلى فقرة تصف مسير هلاون (هولاكو) إلى بغداد وصفاً شيقاً يوحي بكبريات الملاحم في السينما العالمية “فسار الملعون هلاون، في ستين ألفا من الفرسان وكلهم يعبدون النيران دون الملك الديان، راكبين خيولا مثل الغزلان وساروا يقطعون البراري والوهاد. طالبين أرض بغداد”.
سرديات غريبة
نفهم من مقدمة السيرة التي تفتن جميع المصريين أنها غريبة كل الغرابة عن أرضهم في خيوط نشأتها الأولى، لكنها قدرهم الذي نسج في بلاد بعيدة ترزح تحت الحروب والويلات لتسكن في ديارهم ويعمّ الأمن والأمان.
وكان لكلّ راوية لسيرة شعبية أن تبدأ من الينابيع الأولى، إذ لا بد لكل بطل أن يمتلك قصة تخصه وحده ولا يتمتع بها غيره، لذلك حظي بيبرس بواحدة من أجمل السير التي تليق ببطولاته فاتحد الخيال بالواقع لينقذ كل منهما الآخر.
الذهنية الشعبية تبحث دائما عن سرديات غريبة وملفوفة بالغموض والمواربة لأبطالها، فلا يتوقع المرء في البداية أن يكون لشخصية مستضعفة ومهانة “شأن عظيم” كما في الميثولوجيا الإغريقية، وحتى قصص الأنبياء والصالحين.
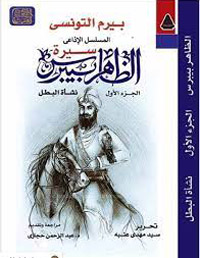
وأبدع الرواة المصريون دون غيرهم ممن تحدثوا وأضافوا للسيرة الظاهرية في بلاد الشام والعراق، فاحتفوا، كما ينبغي الاحتفاء، بأول حاكم إسلامي يتحول إلى بطل شعبي، وبلسان مصري فصيح يسوق الأمثال الشعبية والملح والطرائف، ضمن بيئة محلية فمحوا الفوارق الطبقية وآخوا بين لغة الحاكم ولغة المحكوم. الدليل على ذلك أن أغلب من حكم مصر بعد عهد الملكية، يحاول أن يتحدث بلهجة المصريين البسطاء أي بلغة الظاهر بيبرس والمحيطين به، وذلك سعيا وراء كسب ودّ الجماهير، لكنّ الأمر يبدو عسيرا أمام صعوبة المسألة المعيشية التي من شأنها أن تسرق روح الدعابة وخفة الروح.
أول ظهور لبيبرس في الرواية المصرية على وجه الخصوص كان على هيئة غلام مريض ذليل محتقر اسمه محمود العجمي “لا يأكل ولا يشرب ولا ينام من شدة المرض والأسقام”. ولكنّ أميراً يدعى “أيدمر” وتاجر مماليك السلطان الصالح أيوب واسمه في السيرة “الخواجة علي ابن الوراقة” عطفا عليه وأدركا من ذكائه وفصاحته أنه أمير من أولاد الملوك من أرض خوارزم فأكرماه واعتنيا به إلى أن فتحت شهيته واشتاق لأكل “كشكاً بالدجاج”، ومع مرور الوقت شفي وصار محترماً ومهاباً.
وتتوالى الأحداث في السيرة إلى أن يسمع بيبرس عن مصر من وزير يدعى “نجم الدين البندقداري” الذي وصفها له قائلاً “هنيئاً لمن سكن فيها، وأظلته سماؤها، وسقاه نيلها، لم يخلق مثلها في البلاد، ففيها المساجد وفيها الأهرام التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفيها العلماء والأدباء والشعراء”. فتعلق قلب بيبرس بها وذهب إليها مع نجم الدين ودخل القاهرة من باب النصر. وبعد مضي الأيام في القاهرة تبناه الملك الصالح وزوجته فاطمة (شجر الدر) بعد أن وضع الصالح القبضة بينه وبين بيبرس وقال له “يا ولدي هذا عهد الله شهد الله علينا أنك ولدي وأنا والدك” ثم أخذه إلى شجرة الدر ووضع القبضة بينهما.
يتسلق بيبرس في سلم السلطة لما يتمتع به من قدرات ومهارات تجمع بين الفروسية والذكاء من ناحية، والمكر وحسن استغلال الفرص من ناحية أخرى. وهنا يختلف المؤرخون الثقاة مع الشعبيين من الهواة وجمهور المعجبين من الحالمين، ولكن سواد العامة من الميالين إلى حب الخرافة والمبالغة يفضلون بيبرس فارسا لا يهزم ولا يخطئ.
كانت صاخبة ومثيرة حياة هذا المملوك الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يحلم به إنسان فما بالك بعبد مجهول النسب وبيع في أسواق النخاسين.
لذلك ولأجل ما سبق ذكره من أسباب يصعب على المرء أن يحشو أثناء التحدث عنه الضحل بالسمين فيغوص في أسماء الشخصيات المتآمرة والمناصرة على حد السواء، ذلك أن بيبرس كان بالفعل حاكما ذا ميزات، لكنه في النهاية شخصية مؤسطرة لا يمكن تناولها إلا على سبيل الوقوف عند السيرة الشعبية كإرث تجتمع حوله شعوب مناطق مصر والشام والعراق وتركيا، وحتى خراسان وبلاد القوقاز.
روح الفكاهة

الظاهر بيبرس لم يكن إلا حلقة صغيرة من الحقبة المملوكية التي امتدَّت حُدُود دولتها لِتشمل الشَّام والحجاز، ودام مُلكُها مُنذُ سُقُوط الدولة الأيوبيَّة سنة 1250، حتَّى بلغت الدولة العُثمانيَّة ذُروة قُوَّتها وضمَّ السُلطان سليم الأوَّل الديار الشَّاميَّة والمصريَّة إلى دولته بعد هزيمة المماليك في معركة الريدانيَّة سنة 1517.
ما قاله الملك الصالح للفتى المملوكي بأنه بمثابة ولده مصدقا الرؤيا التي عاشها في المنام، مكّنت رواة السيرة من إلقاء الظاهر بيبرس، في أتون الأحداث أو فلنقل على ضفافها، كمن يتهيأ للسباحة في بحر عميق الأسرار، ويبطن الكثير من الأهوال والمخاطر، وكذلك الدرر واللآلئ. إنها بداية موفقة، وعلى الطريقة المصرية في التمهيد لعمل درامي شديد الإثارة وكثير التشويق، حيث انفرد رواة أرض الكنانة بتمصير السيرة حتى النخاع، ونزعوا عنها كل ما يتعلق بالأقاليم الأخرى كما فعلوا بالتغريبة الهلالية. وكان ذلك على عكس الرواية الدمشقية التي تنسب الظاهر بيبرس إليها، وهو الذي خرج منها عبدا في سوق النخاسين ثم عاد إليها ملكا يتباهى الدمشقيون بإنجازاته كالمكتبة الظاهرية التي مازالت تقع إلى الآن على بعد خطوات من الجامع الأموي.
الطبعة الشعبية الدمشقية للسيرة الظاهرية تعج بدورها بالتشويق وتؤصل لدمشقيتها من خلال ما نسمعه على لسان حكواتي مقهى النوفرة العريق كل مساء، وإلى حد اليوم. ونلاحظ تباينا واضحا في سرد السيرتين بحسب طبيعة شعب كل بلد ومزاجه الاجتماعي.
روح الفكاهة الشامية تختلف عن مثيلتها المصرية في رواية سيرة الظاهر بيبرس، فالأولى تركّز على البطولة المطلقة وما يعرف بـ”القبضاي” لدى أهالي الشام، والثانية تجمع بين الفتوة وروح النكتة والظرافة وكثرة التلصص عما يدور خلف القصور المغلقة. وتبدو فيها الأسوار الطبقية واضحة للعيان.
أما عمّن ألّف سيرة الظاهر بيبرس فهو سؤال يظل معلقا في الهواء مثل كل القصص الشعبية التي تتدحرج جيلا بعد جيل وتكبر مثل كرة الثلج، وإن كان الكاتب والموثق عبود عطية قد قال: ألفها الشعب!
بين الظاهر وبيرم

إنها ـ بالفعل ـ مهارة ينفرد بها الرواة الشعبيون في مصر فتغدو إرثا محليا خالصا تُخصص له الدراسات كما في كتاب “البنية الأسطورية في سيرة الظاهر بيبرس” للباحث إبراهيم عبدالحليم حنفي الذي يتناول فيه سيرة هذا الحاكم المملوكي من خلال البناء الأسطوري الذي سيطر على تكوينها، مثل النبوءة والحلم، والأمكنة الأسطورية، والعوالم الأسطورية، التي أثرت في بناء البطل حتى أصبح أسطوريًا، وكذلك الأنساق الوظيفية التي أسهمت في بناء الأحداث والتكوين بعامة واللغة ومفرداتها وأشكالها والأبطال والمساعدين، وتعدد أشكالهم وقدراتهم الخارقة في مساندة البطل.
لا يختتم الحديث عن سيرة الظاهر بيبرس دون ذكر عمل بقي مرميا سنين طويلة في أرشيف الإذاعة المصرية وهو السيرة الشعبية للظاهر بيبرس للعبقري بيرم التونسي التي قدمتها الإذاعة عام 1960 في حلقات مسلسلة على جزأين، الجزء الأول ضم 188 حلقة.
ولن نكون مبالغين إن قلنا إنّ هذا العمل يعتبر أفضل مرجع للباحثين والمتقصين لحياة بيبرس، لما اتسم به من موضوعية معرفية كما يقول الكاتب والمؤرخ المصري سيد عنبة. لقد أثبت بيرم أنه عارف في “علوم شتى، فنراه مستوعبا جيدا لأحداث التاريخ، وعارفا بجغرافية المنطقة التي دارت فيها الأحداث، ومحللا لسيكولوجية الأشخاص والجماعات التي أتي ذكرها في السيرة، ومطوّعا وناحتا للكلمات كي تعبر عن المواقف الدرامية، وأشياء كثيرة لا يمكن أن تتوفر في شخص واحد إلا إذا كان عبقريا وبيرم التونسي كان كذلك”.
السيرة هي آخر أعمال بيرم حيث كتب في مذكراته قبل وفاته بأربعة أيام “عسى أن يمتد بي الأجل حتى أقوم باستكمال هذه الملحمة، وبهذا تنتهي حياتي مكافحا كما بدأت مكافحا، إذ لا أنوي أن أقوم بعدها بأيّ عمل إلى أن ألقي ربا كريما”.
وتتضمن السيرة مجموعة هائلة من الأشعار والأزجال والأغاني ضمن السياق الدرامي لأحداث السيرة. ففي الجزء الأول منها كتب بيرم ما يقرب من 300 قطعة شعرية بالإضافة إلى 100 أغنية، وفي الجزء الثالث كتب ثلث هذا العدد.
ولا بد من تقديم الشكر لسيد عنبة على ما قام به من مجهود ليرى العمل النور ثانية حيث قام بتفريغ محتوى الحلقات وكتابتها على الورق، وقسمها كما يقول إلى ثلاثة أجزاء كل جزء يعالج مرحلة من حياة بطل السيرة، وقام بتسليمها إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب في نوفمبر 2018.
أما الرؤية الغربية النافذة لسيرة هذا القائد المملوكي ورفاقه فقد عالجها الباحث الفرنسي جوليان لوازو، مع فريق بحث في سلسلة دراسات معمقة، صدر منها إلى الآن خمسة عشر جزءاً عن المركز الفرنسي للشرق الأدنى، وذلك بالاعتماد على دفاتر ثلاثة حكواتيين مارسوا هذه المهنة في مدينة دمشق.
ومثل نهايات أبطال السير فإن عشاقه ومريديه أرادوا له خاتمة تليق بحبهم وشغفهم به فقالوا إنه، ولما مات الملك الظاهر بيبرس في الشام خاف الأمراء من طمع الأعداء فحملوه سراً إلى دمشق وأشاعوا أنه مريض وبعدئذ نقلوه للقاهرة في هودج ورحل معه جيشه لمصر ودفنوه في القلعة.
بايع المماليك أكبر أولاده ناصر الدين برقه خان، ولكن لطمع المماليك في الحكم لم يدم إخلاصهم لحكم أولاد الظاهر بيبرس، إذ وفي بحر ثلاث سنوات قتل ولداه اللذان لم ينالا لقب ملك أو سلطان إلا بالاسم.
أليس في هذا أيضا، رغبة في جعله البطل الأوحد، والذي لا يتكرر أو يقع التناسل منه أو استنساخه.




























