الشعبوية ليست تهمة بل أسلوب صراع

عادة ما يُطبَّق مفهوم الشعبوية على اليمين المتطرف، لكون الحركات التي تؤلفها ترتكز على تجميع غضب الطبقات الضعيفة واقتراح حلول توهم بأنها جديدة وسحرية. بيد أن الباحثة الفرنسية شانتال موف، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ويستمنستر، تدعو صراحة إلى شعبوية يسارية، وتبين في كتابها الجديد “لأجل شعبوية يسار” أن الشعبوية هي استراتيجيا للوصول إلى السلطة.
في كتابها “لأجل شعبوية يسار” تدعو شانتال موف إلى شعبوية اليسار، معتبرة أن الشعبوية تقوم على حشد الشعب ووضعه في مواجهة النخب لمقاومة الهيمنة النيوليبرالية، ولكنها تتنكر في الحقيقة لكل القيم التي انبنت عليها الديمقراطية المعاصرة.
هو كتاب يقع بين التنظير والمانيفستو، ومؤلفته اعتادت أن تعالج ثيمة الشعبوية منذ الثمانينات، مع الأرجنتيني إرنستو لاكلو خاصة، أي أن ما تطرحه ليس ناتجا عن رغبة في إثراء الجدل القائم حول صعود الخطاب الشعبوي في أنحاء شتى من العالم، وإنما هو وليد متابعة ودرس وتحليل. والمعروف أن موف تناهض الماركسية الكلاسيكية (إذ تحتج على تصوّرها الجوهري للطبقة الاجتماعية) والديمقراطية التداولية (فهي تعترض على الصبغة الافتراضية لموقف عقلاني محايد) والديمقراطية المباشرة (لأنها تعتقد أن الصراع السياسي ينبغي أن يُبنى في أشكال من الالتزامات الجماعية).
العقل الشعبوي
تكتسي مقاربة شانتال موف أهميتها لسببين. أولا، أنها تطرح إطارا نظريا لمقاربة سياسية عادة ما يعاب عليها نقص تمفصلها وملاءمتها. ثانيا، أنها بسبب التأويل الذي تقدمه، تتوق إلى جعل الشعبوية استراتيجيا تناسب الديمقراطية الليبرالية والتعددية الحديثة.
بيد أن هذا الجانب من مقترحها يبدو أكثر إشكالية. فإن كانت تعني بالشعبوية استراتيجيا سياسية هدفها توحيد الشعب في مواجهته المشتركة ضد النخب والأوليغارشيا أو ضدّ هيمنة ما، ألا تغدو شروط التداول الديمقراطي مهددة بالنبذ المفهومي لبعض الحجج المقدمة، تماما كنبذ حجج الخصوم؟
ثم إن قدرة استراتيجيا المواجهة (نحن ضد الآخرين) على تجنيد الناخبين ضد خصم مشترك، ألا تحول دون وجود مكان عام يمكن أن تُناقش فيه مجمل المثل العليا للعدالة بصفة عقلانية، وتدرس مختلف أساليب تطبيقها بشكل مفتوح؟ ألا يُخشى أن يدمّر هذا التصور السياسي القائم على النزاع والانفعال جانبا كبيرا من المثل العقلانية التي تطمح إليها الديمقراطيات الليبرالية الحديثة منذ عصر الأنوار؟
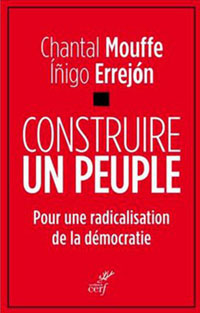
إن الشعبوية التي تقترحها موف ليست برنامجا سياسيا، بل هي كما أسلفنا استراتيجيا سياسية للوصول إلى السلطة، ولكن فكرة اقتراحها على أحزاب اليسار كاستراتيجيا تبدو غريبة نظرا إلى الصورة السلبية التي التصقت بـ”الشعبوية”، والتي تحيل على مواقف سياسية متهافتة على المستوى المعياري، تخاطب العواطف، وتتسم بالعدوانية، وتسوّق للعنف.
لقد استندت شانتال موف إلى تحاليل إرنستو لاكلو، خاصة كتابه “العقل الشعبوي”، لتقترح تحديدا للشعبوية يزيل عنها حملها السلبي، وتطرح محتوى مفهوميّا يميل إلى الحياد قيميّا. فهي إذ تجعل من الشعبوية استراتيجيا “تضع حدا سياسيا يقسّم المجتمع إلى معسكرين، وتدعو أهل الطبقة السفلى إلى التجند ضد من هم في السلطة”، إنما تذكر بنظرية المتحزّب لكارل شميت، التي تؤمن بألا وجود لعمل سياسي إلا عن طريق مجابهة بين “هم” (أولئك الذين هم فوق) و”نحن” (الشعب).
ولكن الفرق بين مقاربتها ونظرية شميت أنها لا تؤمن بمخاصمة جدلية بين صديق وعدوّ بل بمواجهة بين معارضين داخل حلبة ديمقراطية. فالمخاصمة التي يتحدث عنها شميت تعني بالنسبة إليها أن الآخرين (الأعداء) يهددون وجودنا ولا بدّ من إزالتهم في صراع حتى الموت. أما المواجهة التي تدعو إليها موف فتشترط أن يشترك الآخرون (المعارضون) معنا في تزكية مشتركة للمبادئ الديمقراطية، برغم الاختلاف حول المعنى الذي نمنحه إيّاها، أي أن الخصوم يواجهون بعضهم بعضا لأن كل طرف يريد فرض تأويله الخاص لتلك المبادئ. كما أنها تعترض على الأفق الثوري الماركسي الذي يتبلور في مفهوم العدوّ الطبقي، إذ تعتقد أنه لم يعد ثمة أعداء بل خصوم داخل حلبة ديمقراطية واحدة، وأن مفهومها للشعبوية بهذا المعنى يتلاءم مع الديمقراطيات الليبرالية الحديثة.
لقد تركزت الليبرالية الجديدة خلال السبعينات، خصوصا مع النزعة الثاتشرية، وفرضت نفسها كفكرة تعتقد ألا بديل لحكومة الاقتصاد الليبرالي للسوق، بيد أن الاتفاق الأخير لكل الحساسيات السياسية حول هذه الفكرة يدرج مرحلتنا هذه في عهد ما بعد السياسة وما بعد الديمقراطية، إذ انحصر الجدل حول اعتبار جوهر السلطة بين أيدي طبقة واحدة تدافع أساسا عن نظام الأشياء نفسه. إلا أن المؤلفة تؤكد أن الليبرالية الجديدة نشطت في وقت ما، ولكن بعد سنوات من الهيمنة المطلقة، دخلت في أزمة يمكن لليسار أن يستغلّها لفرض نظام هيمنة بديل.
والكاتبة لا تشرح لماذا تعيش الليبرالية الجديدة أزمة، ولو أنها أشارت عرضا إلى تراجع المكتسبات الاجتماعية بسبب تجاوز هيمنتها حدود تقبُّلِ الشعوب لجرائرها الوخيمة، وأن ظهور مقاومة متعددة ضد تلك الهيمنة هو بالضبط ما جعلها في أزمة. وفي رأي الكاتبة أن تعدد هذه الظاهرة هو الذي ينبغي أن تستند إليه شعبوية اليسار لتمنحه شكل معركة لفرض هيمنة جديدة.
وبذلك تغدو الشعبوية استراتيجيا عودة إلى الصراع كمبدأ تشكيل للجدل العام. والكاتبة لا تخفي ترحيبها براديكالية ديمقراطية، لا في أشكالها الأفقية، بل في رفضها لتصور محايد وعقلاني للجدل الديمقراطي ينوب عنه تصور مواجهة تُبرز نقاط تعارض راديكالية وتساهم في تكاثرها داخل الحلبة الديمقراطية. وبذلك تحرص على تمييز تصورها للديمقراطية الراديكالية عن تحاليل ميكائيل هارت وطوني نيغري، وتؤكد على ضرورة اللجوء إلى تمثل الصراع وتنظيمه في شكل حزب.
إن أزمة هيمنة الليبرالية الجديدة تجمع شروط تجديد الصراع في الحياة الديمقراطية، فمعارضة أوليغارشيا الليبرالية الجديدة هي التي تعطي الفرد وسائل بناء عمل مشترك. ولكن ما هي طبيعة هذا الشعب الذي سوف يتوحّد ضد هيمنة تلك الليبرالية؟ بما أن الشعب ليس كائنا معطى بل عامل مكوّن، فإن الكاتبة تعترض على فكرة وجود شعب توحده هوية أو إرادة مشتركة. ورهان شعبوية اليسار هو أن يكون ضمن مسار تقوم على أساسه معادلة بين مختلف المطالب الهجينة، بشكل يحافظ على التمييز داخل المجموعة.
القائد الأوحد

خلافا للتيارات التحررية التي تتصوّر تنظيما ذاتيا أفقيا، فإن بناء الشعب حسب شانتال موف يمرّ عبر عمودية لا غنى عنها، يضمنها في الغالب التفاف مجموعة خلف قائد، وتنفي أن تكون تلك العمودية مدعاة إلى التسلط، إذا كان القائد أفضل نظرائه. ويبدو هذا اللجوء إلى قائد إجابة عن الصعوبة التي تمثّلها المشكلة السياسية الأزلية ألا وهي توحيد مطالب هجينة متعدّدة تحت صراع سياسي واحد بإعلاء صورة القائد، كما أعلى روسو صورة المشرّع. غير أن هذا الحلّ يطرح مشاكل أكثر مما يقدم حلولا.
من الناحية الاستراتيجية، لا يمكن أن ينحصر توحيد شعب، تحت إشراف قائد، في الدولة/ الأمة، ولكنه يمكن أن يتمّ داخلها بصفة أولية، لأن الدولة/الأمة تظل هي المستوى الأكثر ملاءمة للتنظيم السياسي. بعض أشكال الوطنية (غير القومية) قد تكون حمالة لحمية ليبيدية تغذّي أشكال الالتزام السياسي، ولا ننسى دور العواطف في مسار تحديد هوية شعب ما، فعن طريقها يمكن أن يتّحد في شكل مجموعة سياسية. ومن ثَمّ تدعو الكاتبة إلى استراتيجيا شعبوية يسارية تهدف إلى توحيد إرادة جماعية تسندها عواطف مشتركة تروم بلوغ نظام أكثر ديمقراطية.
والكاتبة تستبق ردة فعل الذين قد ينتقدون مقترحها ويجدون فيه مغازلة لليمين المتطرف، فتؤكد أن اليسار ينبغي أن يستفيد من اليمين المتطرف في هذه النقطة لتلبية مطالب كل مستاء من وضعه الاجتماعي والاقتصادي، فالشعبويات تحمل خطابا يروم تجميع الأصوات غير الراضية لاستعمالها كقوّة تغيير سياسي، ولكنها لا تستقطب المستائين بنفس الطريقة، فشعبوية اليسار في اعتقادها تتميز عن شعبوية اليمين بالطريقة التي يتمحور داخلها التناظر “نحن/هم”.
وفي رأيها أن شعبوية اليمين لا تنظر بالضرورة إلى خصم الشعب كطرف مكوّن من قوى الليبرالية الجديدة، لأن الشعب في نظرها هو شعب القوميين؛ بخلاف شعبوية اليسار التي تهتم في المقام الأول بالمساواة، وتسعى لتوحيد كل المطالب الديمقراطية التي تعتبر أن الأوليغارشيا الاقتصادية عدوّ مشترك.
غير أن بعض المحللين مثل بيير كريتوا، أستاذ الفلسفة بجامعة بوردو مونتاني، يميلون إلى الاعتقاد بأن تمييز المفكرة الفرنسية بين شعبوية يسار وشعبوية يمين غير مقنع، لأن حزب مارين لوبان “التجمع الوطني” على سبيل المثال يروّج خطابا مناهضا للأوليغارشيا، ويقترح برنامجا اجتماعيا كي يعطي انطباعا بأنه يستجيب لمطالب الفئات الأشد فقرا، تلك التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. أي أن الجانب الاقتصادي في النهاية يظل أقل أهمية من مطالب الأقليات، ضحايا الميز العنصري، في تحديد الفرق بين شعبوية اليسار وشعبوية اليمين.
الصراع السياسي

هذا الكتاب هو خلاصة نظريات شانتال موف التي تجتهد منذ أعوام في إعادة الروح إلى ديمقراطية تشهد انحسارا خطيرا أمام زحف الليبرالية الجديدة. وما دعوتها إلى المواجهة إلا تأكيد على أن السياسة توجد بوجود وجهات نظر هجينة تعبّر عن تضادّ سياسي يقبل الجدل الديمقراطي، ويضع وجها لوجه قوتين مهيمنتين لا يمكن أن تتعايشا.
ولكن هذه المقاربة التي تزعم أن الوجود السياسي لطرف لا يمكن أن يتم إلا بتدمير الوجود السياسي للطرف المقابل هي أقرب إلى توصيف وضع ثوري لا ينأى عن التضادّ الذي تدينه. ولنا أن نتصور ما يتبقّى من الأحزاب إذا ما اتخذت الحركة التي تدعو إليها شكلَ تمرُّدٍ على النخب وراء قائد، لأن الأحزاب، شئنا أم أبينا، هي بؤرة تشكيل وعي سياسي يتجاوز الوقوف صفّا واحدا ضد الأوليغارشيا، كي يتحوّل إلى مشروع مجتمعي.
فالكاتبة إذ تركّز على البعد النزاعي في تشكل الحقل السياسي، إنما تقلل من دور المُثل الكونية والحجاج العقلاني في هيكلة الالتزام السياسي. ثم إن استعمالها لمصطلح “الشعب” تعني به في الغالب الجانب المهمّش من المجتمع، ذلك الذي يعاني من الليبرالية الجديدة والذي يتمرد على الأوليغارشيا، فإذا الشعب لديها طبقة من طبقات المجتمع تصارع طبقة أخرى، والحال أن مفهوم الشعب في الفلسفة السياسية هو جِماع المواطنين، على اختلاف مشاربهم، ومن دون “ديموس” (الشعب) لا وجود لـ”كراتوس” (سلطة)، بوصف الديمقراطية حكمَ الشعب وليس حكمَ فئة منه.
ومن ثمّ يبدو مشروع شانتال موف موزعا بين كونية الديمقراطيات الليبرالية الحديثة ومواصلة السياسة في شكلها الثوري. هذه الثورية، التي تشترط قائدا يوحّد مطالب الشعب الهجينة تحت سقف حركة واحدة، قد تمثل تهديدا للحريات الفردية، وحسبنا أن نستحضر صورة قائد الشعب عبر التاريخ في أنحاء كثيرة من العالم. فماذا نفعل بالقائد إذا كُتب النصرُ للهيمنة الجديدة؟ هل نحتفظ به مع ما قد يتبع ذلك من سلطوية وشمولية، أو نقصيه مع ما قد ينجرّ عن الإقصاء من عودة المطالب الهجينة التي استطاع تجاوزها؟ أليس من الأفضل في هذه الحالة جمع المواطنين حول أفكار مشتركة بدل وضعهم تحت إمرة قائد لغياب الأفكار المشتركة؟
لقد سعت شانتال موف في هذا الكتاب إلى إعادة النظر في الفكر السياسي لليسار لتقدم نصائح إلى زعماء بوديموس والحزب العمالي وفرنسا الأبية على سبيل الذكر لا الحصر، وتوجهت من وراء تلك التنظيمات السياسية إلى كل من يرفض الليبرالية الجديدة، ويريد التصدي لصعود الشعبويات اليمينية والمعادين للأجانب والقوميين، في وقت تصالحت فيه أغلب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية مع النمط النيوليبرالي وفقدت هويتها في البحث عن توافق بين اليمين الوسطي واليسار الوسطي.
وتؤكد أن الحل لا يكون إلا بعودة الصراع. وفي رأيها أن الديمقراطية الراديكالية والتعددية التي دعت إليها هي إطار لا ينكر دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، ولكنها تطرح بعدا يتمثل في نزاع متواصل يقرّ فيه المتناظرون بأنّهم خصوم وليسوا أعداء. إلا أن الأجوبة التي تقترحها ليست دائما مقنعة، فالتركيز على شعبوية يسار، معارضة للمنظومة، قد يؤدي في النهاية إلى إضفاء الشرعية على شعبوية اليمين، وحتى تدعيمها.




























