الشاعر طارق هاشم: على الشعر أن ينحاز إلى الدراما

يجمع الشاعر المصري طارق هاشم في تجربته الشعرية التي انطلقت أوائل تسعينات القرن الماضي بين كتابة قصيدة النثر بالعامية وكتابتها بالفصحى، وبين العامية والفصحى كان النص متسقا مع تطور الرؤى والأفكار والجماليات الفنية التي حرص الشاعر على خلقها لتكون صوته الخاص. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الشاعر حول كتاباته في الشعر والنقد.
عبر مجموعاته “احتمالات غموض الورد”، “كمان وحيد”، “ناقص حرية”، “إسكندرية يوم واحد”، وأخيرا “اختراع هوميروس” انطلق الشاعر طارق هاشم من التفاصيل غير المرئية أو المهمشة، وقدم نصا بسيطا في روحه الفنية وشفافا في لغته وعميقا في دلالاته ومعانيه، نصا يحتضن تناقضات الواقع واشتباكات الذات معها.
أيضا هاشم باحث في تاريخ الأغنية، وله كتاب “الأغنية المصرية الجديدة مساحات مضيئة”، وكتاب “على الحجار سيرة الغناء سيرة المسرح”. وفي هذا الحوار معه نتعرف على تشكيلات عالمه الشعري ورؤاه في الشعر والنقد والحراك الثقافي.
نكتب لنرى
يقول هاشم “بداية دعني أتذكر معك الحي الذي كان له الأثر الكبير في حياتي أدبيا وإنسانيا من بين كل الوجوه لا بد أن يظهر وجه الحدائق، حدائق القبة بأساطيرها الحاضرة كنهار لا تغيب شمسه، كان سكني بجوار استوديو جلال حيث السينما بعوالمها المبهرة وما بين ‘سينما الهونولولو’ و’سينما الحدائق’ كانت نزهاتنا الدائمة؛ تذكر حين شاهدت هند رستم على الشاشة بالحجم السينمائي يومها عرفت الحب، وأقسمت أن تكون حبيبتي في أنوثتها المترامية الأثر”.
يؤكد هاشم أن تجربة التسعينات كانت أكثر زخما وحضورا وتأثيرا على قناعاته الشعرية، حيث كان الالتقاء بقصيدة النثر وأرضها الواسعة، ويقول “كان اندهاش الكثيرين من شكل الكتابة يجعلنا أكثر إصرارا، وكانت محبتنا وإصرارنا على الخروج من عباءة قصيدة التفعيلة واضحين وقاطعين، كان صوت الحرية أعلى؛ أعترف أننا تلقينا اتهامات غير عادية وغير عادلة أيضا إلا أن صوت القصيدة هو الأعلى”.
ويضيف “كنت أندهش من الحملة على ما نكتب بالرغم من أن المعادلة التاريخية أثبتت أن قصيدة النثر هي نتاج طبيعي لما يحدث، فكما ظهرت قصيدة الشعر الحر في الأربعينات كان من الطبيعي أن تأتي قصيدة النثر الحتمية التاريخية تؤكد ذلك، وبما أن قصيدة العامية تأثرت بحركة الشعر الحر، كان من الطبيعي أن تتأثر بمنجز قصيدة النثر منذ محمد الماغوط إلى آخر شعرائها”.
قصيدة العامية تأثرت بحركة الشعر الحر، فكان من الطبيعي أن تتأثر بمنجز قصيدة النثر منذ محمد الماغوط
ويتابع الشاعر “أعترف أن فترة التسعينات كانت كاشفة وثرية، وكان هناك حراك ثقافي كبير ليس فقط على مستوى شكل الكتابة، بل كانت هناك المشاريع الأدبية المهمة الممثلة في المجلات الخاصة، حتى شكل المعارك كان ملهما؛ كانت المعارك لأجل الوصول إلى مفاهيم لا إلى مقاعد، كل ذلك تأثرت به قصيدة العامية، أما الآن فهناك شعور كبير بالتقهقر والرجوع إلى الخلف حيث عاد الصوت العالي هو الذي يحكم لا الفنية، أعني عادت القصيدة إلى الخطابة التي حارب الكثيرون من أجل مقاومتها لصالح المعنى”.
وحول الجمع بين العامية والفصحى، يلفت هاشم إلى أن “التحول من العامية إلى الفصحى لم يكن صعبا لأنني كنت ابنا للمؤثرات التي طالت قصيدة الفصحى، وكما أشرت البداية كانت مع الفصحى وبالفعل كتبت بعض القصائد بالفصحى إلا أن العامية كانت الأقرب في فترة إلى قلبي، وهذا لا يعني أنني تركتها الآن لصالح الفصحى، فأنا لا أرى مشكلة في أن يكتب الكاتب أكثر من لون أدبي أو شكل أو لغة، فكما قرأنا بوشكين في أشعاره المذهلة قرأنا أيضا روايته الرائعة ‘ابنة الضابط‘، كذلك قرأنا مسرحه، وكذلك الحال بالنسبة لليرمنتوف، فكما استمتعنا بأشعاره أظن أنه من الصعب أن ننسى تحفته الرائعة ‘بطل من زماننا‘. وهناك أيضا فيكتور هوغو الذي كتب الرواية والشعر والمسرح”.
ويشدد الشاعر على أنه إذا تأملنا المشهد الثقافي العربي سنجد لويس عوض صاحب “بلوتولاند وقصائد أخرى” وهو أيضا الناقد المهم الذي كتب روايته الآسرة “العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح”. يذكر أيضا جبرا إبراهيم جبرا الذي كتب الشعر والقصة والرواية والنقد، كما مارس الترجمة.
ويرى هاشم “أن البساطة تنسف الحواجز فحين تقرأ قصائد صلاح عبدالصبور وصلاح جاهين ستكتشف أن المسافة ليست بعيدة، وتجربة ‘اختراع هوميروس’ تحاول أن تصل إلى هذه البساطة، هذه المسافة ما بين اللغة واللهجة، لذا ستجد بعض مفردات العامية بين علامتي تنصيص، كلنا يحلم بأنشودة البساطة التي كان ينشدها عمنا الكبير يحيى حقي الذي قرب ما بين العامية والفصحى في حالات كثيرة، كذلك لم ينج ‘اختراع هوميروس’ من الولع بالدراما والسينما كما أشرت في البداية الوقوع في أسر الحكاية وفتنتها كما في أغلب قصائد الديوان”.
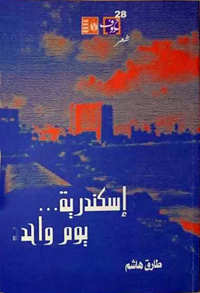
ويشير الشاعر إلى أن حرصه على شفافية اللغة والرؤية عن طريق اللجوء إلى التفاصيل المهمشة أو المركونة يجيء متمثلا بالتعلق بالدقة كما رآها بول فاليري، الدقة كانت وصيته، إننا نكتب لنرى، لنصل إلى عالم أكثر رحابة من عالمنا الضيق، نحتفي بنقاط الضعف لا بنقاط القوة، نحتفي بجراحنا عبر الاهتمام بالمنسي والمهمش والمركون.
وفي رأيه يبدو أننا نفعل ذلك إيمانا منا بمتاهتنا وبكوننا منسيين، إن الكتابة هي التعلق بأسلحة تخيف لكنها لا تقتل. إن المكاشفة هي الحل الأمثل لأن الهروب لا يكون حلا في أغلب الحالات وما نهرب منه لا بد سيواجهنا، الكتابة مواجهة مع الحزن دون أي خوف من النتيجة.. نكتب لنكتشف هشاشتنا في مواجهة الإرهاب اليومي، لذا فالدقة هي الشاطئ والمرفأ.
الشعر المظلوم
نص طارق هاشم صورة لتجليات رؤية العالم في ذاته وكذلك رؤية ذاته في العالم، لتشكل بنية الصورة لديه نصا مكتملا، ويوضح رؤيته قائلا “للنص في أركانه أسرار الذات غالبا، النص يختبر العالم بحساسيته الواهية في بساطتها بجنونه ومرتكزاته المتحولة، كل نص يحمل عالمه ويمضي هكذا في الأفق دون أي خوف، النص أصبح قادرا على ممارسة كينونته في مواجهة الواقع بتحولاته المربكة كل لحظة، حين نقرأ دوستويفسكي سنكتشف أن العالم هو الشخصية، وعلى الشعر أن ينحاز إلى الدراما حتى يكتمل المشهد، فكما استفادت الرواية سر جمالها من الشعر، كان على الشعر ألا يقف صامتا، لذلك ستجد ميخائيل باختين يكتب عن شعرية دوستويفسكي، الصورة في حالات كثيرة أكثر تعبيرا من الكلمة، فكلمة أحبك قد تنساها المرأة في حالات كثيرة إلا أن صورة أول قبلة تظل قابعة في ذاكرتها”.
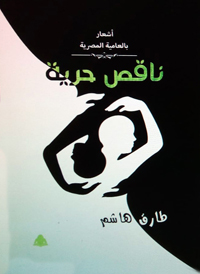
ويشدد هاشم على أن موروث العامية كبير وحافل بالمفاجآت والتحولات، فالقصيدة العامية منذ بيرم التونسي وبديع خيري مرورا بحسين شفيق المصري وحسين مظلوم ثم فؤاد حداد والأبنودي وصلاح جاهين وسيد حجاب قد تغيرت حالتها ومزاجها الفني من مرحلة إلى أخرى، وقد انفعلت بكل هذه التجارب إلا أن تجربة جاهين كانت هي الأقرب دائما والأكثر التصاقا ببساطتها المدهشة، فحين تقرأ قصيدة يوسف حلمي أو فاخر فاخر ستكتشف الإنسان في أدق تفاصيله، وستبقى قصائد كثيرة لفؤاد حداد والأبنودي وستحضر أغنيات سيد حجاب بمفآجاتها الدائمة، إن تجربة الشعر العامي مدينة لكل هذا الجمال ومنطلقاته وأفكاره الكبيرة.
وحول اتهام البعض لشعر العامية بأنه لم يعد يشارك في زخم الحياة الاجتماعية وما تضج به من مواقف وأحداث، يقول هاشم “الشعر كله متهم، القارئ يبحث عن نص إذاعي مستهلك وذلك لزمن طويل، وإذا حاولنا أن نسأل أنفسنا عن سر نجاح الأغنية سنكتشف أن الشعر ظلم لكونه أداة صاحبه ليس أداة مؤسسة، فأغلب التجارب الناجحة مجتمعيا الآن ستكتشف أن وراءها تقنيات لم تقدم جديدا، هي تعيد إنتاج نص دعائي كان مناسبا في حينه، فحين تحب كشاعر نص ‘الخواجهلامبو العجوز مات في إسبانيا’ للشاعر عبدالرحمن الأبنودي ستجد نصا آخر أكثر مباشرة هو الأكثر نجاحا لنفس الشاعر”.
ويتابع “بما أننا قد اتخذنا الأبنودي مثلا فستجد هناك الآلاف من الأصوات التي تحاول أن تكون الأبنودي، وقد تحقق الصوت العالي إلا أن أصالة التجربة تظل بعيدة، فتكتشف أنك أمام حركات دعائية لا نصا أدبيا. إن الشعر دوره أن يكون لسان حال صاحبه وتجربته التي هي ابنة تفاصيل تتعلق بمحيطه الاجتماعي دون صوت عال، الادعاء هو القاتل الحقيقي للنص أي نص”.
ويضيف أن “شعر العامية الآن يعاني من ردة كما أشرت في السابق، فبعد أن قطعت أجيال شوطا كبيرا من أجل تحريره من الغنائية المفرطة حتى وصلنا إلى قصيدة النثر العامية، عاد الصوت العالي والتقفية والخطابة إلى صدارة المشهد، عدا أصوات مازالت تحاول أن تقدم نصا مختلفا”.




























