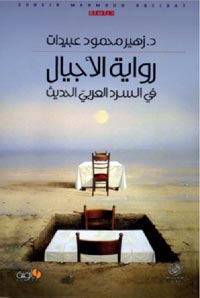السرد العربي الحديث وثلاثة أجيال من الكتاب

يدرس الباحث الأردني زهير محمود عبيدات في كتابه “رواية الأجيال في السرد العربي الحديث”، ثلاثة نماذج روائية تمثل رواية الأجيال على مدى ثلاثة عقود تقريبا هي؛ ثلاثيّة نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) فـي الخمسينات، “العُصاة” لصدقي إسماعيل فـي الستينات، وخماسيّة “مدن الملح” لعبدالرحمن منيف في الثمانينات، ليستخلص من خلالها السمات الفنية المشتركة لهذا اللون السردي، غير غافل عن روايات أجيال أخرى قد تقترب أو تختلف فـي المفهوم والبناء مثل رباعية إسماعيل فهد إسماعيل، أو ثلاثية سهيل إدريس.
تقوم الدراسة، الصادرة عن دار أزمنة في العاصمة الأردنية عمان، على مقدّمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة؛ قدّم الباحث في المدخل مفهوم الجيل، مستعينا بالبعض من الدراسات الاجتماعية، وقد تتبّع جذور رواية الأجيال في الآداب الأجنبية، ووقف أمام أهم أعلامها ونماذجها وظواهرها التي استخلصها من الدراسات، وكان ذلك منطلق الدراسة النظري، أعقبه بدراسة تطبيقية على روايات عربية متعدّدة الأجزاء لتعميق المفهوم في ذهن القارئ.
صورة المجتمع
في الفصل الأول “ثلاثة أجيال في ثلاثية نجيب محفوظ” تناول الباحث ثلاثة أجيال من خلال أُسرة السيد أحمد المصرية في فترة ما بين الحربين، وجعل معيار تصنيف الأجيال زمانيا: جيل الأب ويمثّل وجه الماضي بكل ما يوحي به من تقاليد وقيم وأساليب حياة، وجيل الابن الذي يمثّل الحاضر، وهو مرحلة وسطى متحوّلة، أمّا المستقبل فيمثّله جيل الأحفاد. وعلى هذا النحو استحالت الأجيال إلى صور من وجوه الزمان.
وكشفت الدراسة عن صور الأجيال من خلال التركيز على أفكارها وسلوكها وعلاقاتها وما تحرص عليه، ومن خلال القضايا التي تشغلها. وقدّمت صورة الجيل الأول من خلال معتقدات السيد أحمد، التي كانت شائعة في البيئة التي يعيش فيها جيله، والمنحدرة إليه من الماضي، ومن خلال علاقته بزوجته أمينة وبأفراد أسرته. ثم سلّط الضوء على أفكار الجيل الثاني وهمومه وأشكال سلوكه، وقارن نموذج الأسرة بنموذج أسرة الجيل الأول، وركّز على الظواهر التي اندثرت وتلك التي حملها الجيل الجديد وظلّت حيّة ترافقه.
الدراسة تكشف عن صور الأجيال من خلال التركيز على أفكارها وسلوكها وعلاقاتها وما تحرص عليه
صراع الأجيال
في الفصل الثاني من الكتاب والموسوم بـ”أجيال في العُصاة” يرى الباحث أن رواية صدقي إسماعيل جاءت مثل ثلاثية محفوظ في ثلاثة أجيال من أسرة حلبيّة، وإن قصّرت عنها فنيا وحجما وفضاء؛ جيل الآباء، ويمثّله الجدّ محمد آل عمران، الذي عاش في ظلّ واقع ساد فيه الفساد الاجتماعي والاستبداد والظلم وجشع التجار، وفي وقت كان الحديث فيه عن العصيان واغتصاب الأراضي وانتشار الأوبئة وقتل الناس وعزل الولاة من الأمور المألوفة.
كما نجد جيل الأبناء الذي يمثله عمران مسلوب الإرادة أمام والده حتى في آرائه اليومية البسيطة، إبراهيم الذي يمثّل هو وأسرته نموذج الاختلاف الفكريّ بين جيلين، ومرحلة وسطى تردّد فيها ذلك الجيل بين التشبّث بالماضي والأخذ بالبعض ممّا جاء به الحاضر من منجزات الأمم الأخرى، وسعاد وأسرتها اللتان تمثّلان نموذج الصراع بين جيلين، صراع القديم مع الجديد، نموذج التحرّر المطلق من سلطة الأب وإرادته. أما الجيل الثالث فهو جيل “العصبة” المتمثّل بـ(عدنان وسامي وهاني)، والذي يمثّل قمّة التطوّر السياسيّ ونمو الوعي القومي في سوريا.
|
أمّا في الفصل الثالث “أجيال في مدن الملح”، فإن عبيدات يرى أن مفهوم الجيل اختلط فيه المعيار الزمني بالمعيار الحضاري، إذ جاءت الأسرة الحاكمة في جيلين؛ جيل الأب وجيل الابن، غير أن هذين الجيلين، رغم اختلافهما في الزمان، يشكّلان جيلا حضاريا واحدا، حيث ظلّ الابن صورة عن عقلية والده وعقلية البدويّ في الصحراء، لم يستفد من الاختلاط والثقافات الأخرى، وبقي حبيس عقليّة القبيلة، وعجز عن بناء دولة حديثة، ولم ينفذ التغيير إلى وعيه رغم التطور الذي حققته المدينة في مرافقها التي تعتمد على الآلة الأجنبية.
وأبرز الفصل صورة الأجنبي وصورة العربي في ذهن كل منهما، وقارن بين عقليّة القبيلة وعقليّة الدولة الحديثة، وبيّن موقف العربي من المنجزات الأجنبية وكيف استقبلها وصوّرها. كما تتبع الباحث رحلة المدينة مذ كانت قرية في الصحراء إلى أن صارت مدينة كبيرة تعجّ بالغرباء والأجانب، وركّز على موران وحرّان، بوصف المدينة ذاكرة للأجيال وكتابها المفتوح حيث نقرأ سِيَر حكّامها وإنجازاتهم. وركّز عبيدات على التيارات المعارضة في هذا الجيل وفلسفة ذلك، خاصة التيار الذي عجز عن الانسجام مع حركة الحياة الجديدة فلاذ بالماضي ونبذ كلّ ما يتعلق بالحاضر، وظلّ حبيس أحلامه وآلامه.
استخلص الباحث في الفصل الرابع السمات العامة والظواهر من دراسة النصوص وتحليلها، وهي سمات عامة مشتركة قد يوجد البعض منها في روايات أخرى، وتعرّض للزمن ودوره وأثره في التحوّل لدى الكائنات الحيّة والمعتقدات والأسرة والدولة والحضارات عامة، وكشف عن صورة الزمن كما ارتسمت في أذهان الأجيال المختلفة، كما تعرّض للمصير والمآل لكلّ شكل من أشكال الحياة ولحرص الإنسان على تخليد نفسه بما ينجزه حتى يظلّ حاضرا عبر الأجيال.
كما وقف عبيدات على ظواهر واقعيّة رواية الأجيال وعنايتها بإطار الحقبة التاريخي، وعلى حركة التعاقب التي قامت عليها عناصر الرواية؛ العامّ والخاصّ، الداخل والخارج، الأسرة واﻟﻤﺠتمع، الخاصّ والإنساني، وبيّنت أنّ هذه الحركة التعاقبية تشكِّل أخيرا حركة الحياة واستمرار الأجيال.