الذكاء الاصطناعي.. بين الانبهار اللحظي والتطور الحضاري
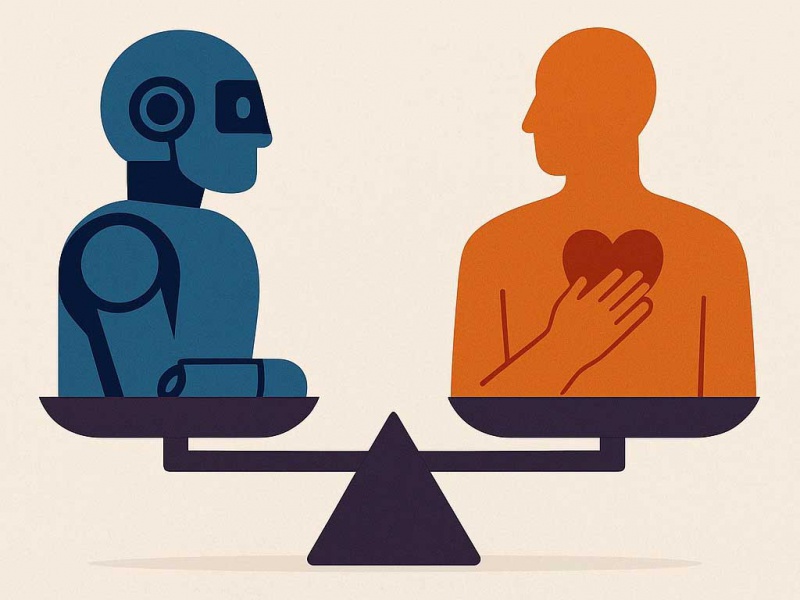
الانبهار المفاجئ بالذكاء الاصطناعي دون وعي حقيقي بدوره، ودون إدراك لأماكن توظيفه، أو فهم لكونه لا يتعدى كونه أداة متطورة لمساعدة الإنسان، قد يضعه في سياق خاطئ. بل قد ينعكس هذا الانبهار سلبًا على العديد من القطاعات الإنسانية، إن تم التعامل معه كبديل كامل عن البشر.
الركض نحو “الخاتمة القصيرة” التي تفترض أن وجود الذكاء الاصطناعي يعني بالضرورة تقليص الموارد البشرية، قد يكون قفزًا غير محسوب النتائج. فهذه ليست السياسة المثلى لتطوير الأعمال، ولا المجتمعات.
إذا أردنا الحديث بشكل أكثر تحديدًا عن دور الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام، فإن الأمر لا يخلو من الفرص، لكنه أيضًا لا يخلو من التحديات. صحيح أن هناك أدوات قادرة على تسريع الترجمة بين اللغات، أو تلخيص النصوص، أو تفريغ محتوى الفيديوهات وتحليلها، لكن حتى اللحظة، كل هذه الأدوات بحاجة إلى كوادر بشرية، وتدريب بشري جيد، وتدقيق واعٍ من محترفين، فاحتمالية الخطأ فيها واردة وما زالت مرتفعة.
في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ذراعًا قوية للعمل الصحفي، إذا استُخدم بحكمة. يمكنه، مثلًا، تسريع عملية أرشفة الوثائق والمقابلات، وتحليل كميات ضخمة من البيانات المتاحة للعامة، لكنه لا يصنع القصة. فهذه الأدوات تفتقر إلى أهم ميزة وهي “الوحي الفكري، الإنساني، الإبداعي والروحي”، كما أنها تفتقر إلى الحدس والبصيرة والموقف.
حتى أن دور هذه الأدوات قد يكون أحيانًا مساعدة في دعم مراوغة الإنسان، وللوهلة الأولى قد نعجز عن التفريق بين إمكانيات الأشخاص ومعرفة حقيقة إبداعهم. لكن، مع تكرار أنماط وأسلوب هذه الأدوات، يصبح من الممكن الكشف عمّا إذا كانت القصص والنتائج من صنع بشري أم آلي بحت.
ومن هنا، نجد تصاعد المخاوف بين الصحفيين من خسارة أدوارهم ووظائفهم واستبدال الذكاء الاصطناعي بهم لاحقًا، إضافة إلى المخاوف من أن شكل المهنة قد يتغير خلال سنوات قليلة، نظرًا للتداخل الحاصل في دور وأساسيات وهُوية الصحفي وصانع المحتوى.
لا توجد صورة رقمية منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي قادرة على التأثير كما تؤثر الصورة الحقيقية، مشاهد كلفت الصحفيين ثمنًا باهظًا من حياتهم، صحتهم، وأمنهم
وهناك بالفعل محاولات لتقزيم دور الصحافة التقليدية في مقابل صعود “المؤثرين” في عالم الإنتاج الإبداعي، لكن، من وجهة نظري، الصحافة التقليدية لم تندثر، بل على العكس، ما زال أمامها فرصة لتزدهر من جديد. لكنها تحتاج إلى بصيرة حقيقية وواعية لدعم استخدام الأدوات المتطورة، وخاصة “الذكاء الاصطناعي”، في الاتجاه الصحيح.
اليوم، ما يميز الصحفي في إنتاجه المقروء، المسموع أو المرئي، هو القدرة على التحليل ومحاولة تفكيك الواقع من كافة الزوايا وبطبقات أعمق، وأن يمتلك بصيرة خاصة وصوتًا فريدًا، علاوة على القدرة على ربط الأحداث بسياقات أكبر وأوسع، خاصة في ظل تعاظم الأزمات والحروب والمعارك على جبهات عدة. هذه أدوار لا يمكن أن يقوم بها إلا صحفي واعٍ، مثقف، واسع الاطلاع، صاحب موقف وبصيرة. هنا يظهر الإبداع الحقيقي، وهنا تتجلى أهمية الفكر والحرية والتنوع، وهنا يستعيد الإنسان صوته.
وهذا في النهاية ما يمنح المتلقي فهمًا أعمق للقصة، وزوايا أوسع لفهم ما يجري من أحداث سريعة ومتتالية، في العالم بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص. لذا، اليوم، دور الصحفي مهم جدًا من أجل محاولة استعادة مساحة الحريات المسلوبة، وإعادة تطبيع فكرة احترام التعددية والاختلاف، وتطبيع حريات الرأي، والفكر، والتعبير في المجتمعات من جديد.
خاصة في عالم باتت الحقوق مسلوبة، والحريات مكبلة، سواء من السلطات أو من الأفراد أنفسهم في مسرح “وسائل التواصل الاجتماعي”، التي باتت أشبه بغرف تعذيب، حيث يُجلد المرء على رأيه بالتنمر والشتائم والهجوم اللاذع. وذلك وسط انحسار مساحات الحوار، وغياب طاولة النقاش والجدال البناء، وغياب ممارسة الحريات في بعض المجتمعات لفترة طويلة.
ولهذا تحديدًا، نعود ونؤكد أن دور الصحفي مهم جدًا. ليس في نقل الخبر فقط، بل بكونه صوت الواقع، حيث يتجلى دوره في مواجهة التسطيح المستمر للأحداث، ومحاولة مواجهة أدلجة الحقيقة.
الإعلام الحقيقي هو من يساعد المجتمعات على الخروج من كهف أفلاطون، ومن يفتح النوافذ لاكتشاف النور. فالإعلام لا يُفترض أن يكون مجرد صدى لظلال نار تُعرض على جدران مظلمة، بل يجب أن يكون كاشفًا للواقع، مثيرًا للأسئلة، دافعًا للتفكير، ومساهمًا في صحوة المجتمعات.
وهذا كله يكمن في عقل وإبداع الأفراد، ولن يتم تحقيقه عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، لأن هناك فرقًا واضحًا بين صناعة الجدل وصناعة الوعي.
فصانع المحتوى لن يكون يومًا قادرًا على الجلوس على كرسي الصحفي، ولا يجدر به ذلك. لكل منهما دور مختلف، وأدوات مختلفة، ولغة مختلفة في المجتمع. الحد الفاصل بينهما أشبه بخيط رفيع، لكن مع تشابك الخطوط، يجب أن يبقى المجتمع واعيًا بذلك.
نعود مرة أخرى إلى الذكاء الاصطناعي. هذه الأدوات تتطور، لكنها بحاجة إلى عقل بشري يُدققها، يراجعها، ويضخ فيها البصمة الإنسانية. تطورها يجب أن يكون في صف الإنسان، لا ضده؛ أن تساعده على أداء عمله بشكل أسرع وأدق، لا أن تسرق مكانه.
ولن تنجح في ذلك أصلًا، لأنها لا تملك ما يملكه الإنسان: الروح، الرؤية، الإبداع، والقدرة على التعبير عن المعاناة.
الصحافة ستبقى، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وعدم القدرة على ضبط الساحة الرقمية وتطور الأدوات، لكنها لن تندثر.
قد تتحول الصحف من ورقية إلى نسخ إلكترونية، لكنها لن تموت. ستبقى مساحةً للإبداع، للتعددية، لصناعة القرار، ولمحاولة بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة. أن تتحول أوراقها إلى غرف عصف ذهني علنية في محاولة لمساعدة المجتمع وصنّاع القرار والسياسات على خلق واقع أفضل يومًا ما، على الأقل.
قد تتغير الإذاعة إلى بودكاست، والتلفاز إلى مساحات تفاعلية رقمية، لكن لن تتوقف الحاجة إلى المحتوى المكتوب، المرئي، والصوتي أو التحليلي. الجمهور، برغم كل هذا التشويش، ما زال يتوق للمعرفة الحقيقية، يتوق إلى وجبة فكرية دسمة في زمن “الوجبات السريعة”.

نرى مقاطع بودكاست تمتد لساعات، تتناول موضوعات فلسفية وتاريخية معقدة، وتحصد ملايين المشاهدات والتفاعلات. هذا دليل على أن الجمهور لم يفقد قدرته على التأمل، بل فقط فُرضت عليه حالة من التسطيح لفترات طويلة.
قد تتطور الأدوات، لكنها لا تستطيع استبدال الإنسان. هؤلاء البشر الذين يعيشون القهر، ويقفون عند هامش الحياة، هم وحدهم القادرون على رواية قصصهم، وكتابة واقعهم. وحدهم يملكون الحق في الحديث عن معاناتهم.
قد يكون الذكاء الاصطناعي، بإبداعه في إنتاج صوره الخاصة ولوحاته ورسوماته وفيديوهاته، قد أضحى “ترند”، لكنه لا يستطيع أن يحاكي ألمًا حقيقيًا أو شعورًا إنسانيًا نابعًا من تجربة معاشة.
لا توجد صورة رقمية منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي قادرة على التأثير كما تؤثر الصورة الحقيقية، مشاهد كلفت الصحفيين ثمنًا باهظًا من حياتهم، صحتهم، وأمنهم.
هذا النص ليس ضد التكنولوجيا، بل دعوة للتوازن، ولإبقاء الإنسان في قلب التطور. والجهود الكبيرة التي تبذلها الدول في تطوير الذكاء الاصطناعي أمر مقدر، والاستثمار في هذه التكنولوجيا يجب أن يصاحبه دائمًا وعي بأهمية الإنسان ودوره. لأن الأصل هو الإنسان، وتجاربه، وبصيرته، وإبداعه. وإخراج الإنسان من هذا السياق، سيُحدث إخلالًا في المنظومة.
لن نكون ضد التطور، بل نحن معه، لأن المجتمعات تحتاج إلى هذه الأدوات. نحتاجها في التعليم، الصحة، الإعلام، الخدمات المقدمة، وفي كافة مناحي الحياة اليومية. لأنه في عام 2025، كان من المفترض أن يحصل الإنسان في كثير من دول العالم على نوعية حياة أفضل، لا أن يتم زجه وغرقه في صراعات وحروب ومآسٍ تأكل روحه يوميًا.
لذا، على المنظومة أن تتذكر: التاريخ لا يسير في خط مستقيم. بل نحن نعيش في دوائر، وما نسميه “تقدمًا”، قد يكون فقط وهمًا مريحًا إذا لم يتم توظيفه بالطريقة الصحيحة.
أو قد يصبح مجرد انبهار عالمي انفعالي لحظي، لأن الحضارات السابقة لم تكن متخلفة ولا متأخرة، إنما سبقتنا في البناء، في النحت، في الهندسة، في المعرفة، العلم، في دفن أسرارها، في الفن والإبداع… وربما في المعنى.
لذلك، تمامًا كما امتلكت تلك الحضارات من التكنولوجيا ما ساعدها في بناء حضارات عظمى، ثم انتهت وفنت، علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي بعدم التخلي عن الإنسانية والإنسان، وعدم التخلي عن معنى الوجود.
لذا، المهم الآن، ألا نفقد قدرتنا على الحلم، والتفكير، والتأمل.






















