الثقافات تنشأ في محيط تعددي منفتح

في كل عصر وفي جميع الحضارات الإنسانية، ظلت العلاقة بين القديم والجديد والمفاضلة بينهما، حاضرة، ولطالما كانت تؤدي إلى الاختلاف وبخاصة في جانب تبادل التأثير بينهما في الواقع، وإن التحولات التاريخية هي من نتائج الحوار بينهما، وإذا كان انتصار الجديد حتمية تاريخية، وهذا ما أدركه الإنسان عبر مسيرته منذ أن كان إلى يومنا هذا، فإن مثل هذا الانتصار ليس إلغاء للماضي بقدر ما هو تمثل له ومحاولة وضعه في سياق تسلسل تاريخي.
وعلى سبيل المثال إن حضارات الوطن العربي القديمة في مصر وبلاد الرافدين خلفتها حضارات عربية، ربما كانت في الأمكنة ذاتها، كما هو شأن مركز الحيرة في العراق ومركز الإسكندرية في مصر أو في غيرهما من مراكز الحضارة كما في اليمن مثلا وبلاد الشام، وحين ظهرت مراكز حضارية جديدة بعد ظهور الإسلام، مثل دمشق والكوفة والبصرة ومن ثم بغداد وقرطبة والقيروان، فهذه المراكز الحضارية الجديدة ما كانت لتظهر وتكون بكل تلك الحيوية والأهمية والتأثير، لو صدرت عن موقف يتبنى القطيعة مع الماضي، وبخاصة مع الحضارات التي سبقتها، زمنا وإنجازا.
إن ما ذكرته لا يعني أن هذه المسيرة الموضوعية في تاريخ الحضارات، التي تعني أيضا العلاقة بين القديم والجديد، كانت تشكل قناعة عامة لدى الأجيال المتعاقبة، وأن مراحل التحول لم تشهد مواقف تتسم بالتعصب، سواء من قبل ممثلي المراكز الحضارية التي بدأت شمسها بالغروب أم من قبل ممثلي المراكز الحضارية الجديدة والطالعة، بل كان التعصب حاضرا، وهو في كثير من الحالات أنتج آثارا سلبية، حيث يسود الصراع ويتراجع الحوار، لكن في الوقت ذاته شهدت لحظات الافتراق بين القديم والجديد محيطا حواريا ناضجا كشف عن كنوز الماضي وأغنى تطلعات الحاضر وأشار إلى المستقبل.
لكن ممثلي التحولات الجديدة غالبا ما يرون في ما أنجز من قبل قليل الأهمية ولا يستحق التمثل أو الاحترام، ولو تأملنا بعمق في المعنى الذي أشار إليه الرسول العربي محمد بن عبدالله في قوله: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لأدركنا ما كان يرى من علاقة إيجابية بين القديم والجديد، وإن شاعرا مفكرا عميق الثقافة مثل أبي العلاء المعري، وقد عُدَّ من ممثلي النزعات التجديدية في عصره، كان يفصح عن تقدير من سبقه من الأوائل، حسب تعبيره حين يقول:
وإنّي وإن كنت الأخير زمانه
لآت بما لم تستطعه الأوائلُ
ورغم نزعة الفخر الفردية في هذا البيت الشعري، فإنه يفصح عن احترام الماضي وأهله وإن ما أتى به من أفكار ورؤى ليس سوى إضافة إلى إنجازات الماضي الفكرية، إن أجمل ما قرأت عن علاقة القديم بالجديد، قول أندريه جيد “أقول لكل دقيقة تمر، ما أجملك توقفي” ففي قول جيد، يكون الحاضر ماضيا، والدقيقة في الماضي والراهن تتسم بالجمال، أو هكذا رآها، ويشير الدكتور فؤاد زكريا في معرض حديثه عن الموسيقى إلى هذه الفكرة بقوله “إن الذين نعدهم في عصرنا كلاسيكيين، كان بعضهم قد عُدَّ غير مفهوم في عصره، فقد اتهم بتهوفن بالغموض والتعقيد، ولقي فاغنر الكثير من السخرية”.
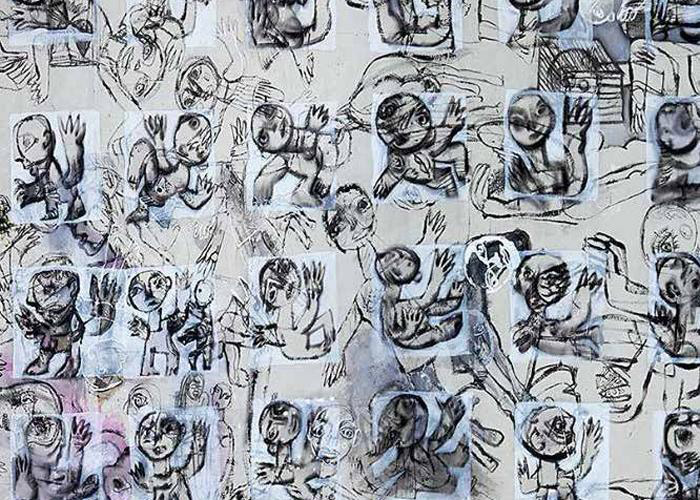
وفي ضوء ما تقدم ينبغي أن ننظر إلى ما هو جديد في الفكر والإبداع، فهو ليس نبتة شيطانية، ولا يمكن أن يكون بلا جذور أو مقطوع الصلة بالماضي وقديمه.
لقد رافقت ظاهرة تبادل التأثير معظم الثقافات الإنسانية، فليس من ثقافة ناضجة وحيوية إلا ونشأت في محيط معرفي تعددي، مُستقبِل ومنفتح، حيث الحوار المتكافئ هو البوتقة والفعل في آن واحد لتحقيق تبادل التأثير.
قال أبوسعيد السيرافي وهو من أبرز مثقفي القرن الرابع الهجري الذي شهد نضج الثقافة العربية الإسلامية “إن عِلم العالم مبثوث بين جميع مَنْ في العالم” فهو لا يستثني من العِلم مكانا أو زمانا أو إنسانا وينسب أبوحيان التوحيدي إلى أحد فلاسفة اليونان قوله “المعرفة تتحقق في التقلب في الأمصار، والتوسط في المجامع، واستماع فنون الأقوال”.
إن الأحادية الثقافية لم تكن في أي مرحلة من المراحل التاريخية بضاعة عربية، بل هي من مخلفات المركزية الغربية التي ما زالت تعتم على تأثير الحضارات القديمة على الحضارة الإغريقية وتتجاهل وثائق هذا التأثير، بعد اكتشافها وترجمتها ونشرها.
أما الحواضر العربية الإسلامية، دمشق وبغداد والمدن الأندلسية فقد كان الانفتاح على معارف الآخرين والسعي إليها، من صفاتها المعروفة، فبغداد مثلا لم تكن حاضنة للحضارة الإسلامية بكل جلالها وازدهارها فحسب، بل كانت أيضا كما تقول الدكتورة سهير القلماوي: بوتقة فعلية، صهرت الكثير من ألوان الحياة الإنسانية، كما صهرت الكثير من الثقافة الإسلامية بكل ما زخرت به من نتاج قرائح عصور طويلة بأسرها.
لقد احتضنت بغداد ثقافات أمم أخرى، واستكنت في رحمها المخصب المفعم بالحياة فولدت حضارة جديدة، نشرتها على المغرب والمشرق بأسرع ما يمكن أن تنشر وتثمر الثقافات.
ولم تكن الحاضنة الثقافية العربية في معاهدها وفي ما تنتج من فكر وأدب مستنكفة عن إعلان تأثرها بالآخرين، فبيت الحكمة ببغداد كان ميدانا حيويا لمواصلة التعرف على ثقافات الآخرين، وترجمة مصادر المعرفة من عدد من اللغات وكان كبار الكتاب يحددون ما يهمهم من المصادر لترجمتها، وكان الجاحظ يأتي من البصرة إلى بغداد فيتفق مع مترجمي بيت الحكمة لترجمة هذا المقال أو ذاك.
أما الثقافة العربية الأندلسية فقد اتسمت بتعدد مصادرها وبقدرتها على تمثل تلك المصادر، ومن هنا جاءت حيويتها وقدرتها على التأثير، وتأكيدا لهذا الموقف يرد خوان غويتسلو على الذين يحاولون فرض فكرة أن الثقافة الإسبانية محض أوروبية بقوله “إن الثقافة لا تبنى ولا توطد إلاّ عبر لقاء المجموعات البشرية المتباينة، وبالمقابل فإنها تذوي وتختنق في الانغلاق والانكفاء نحو الذات”.
وحين أقدمت ماري تريز عبدالمسيح على قراءة “طوق الحمامة في الألفة والألاف” لابن حزم، على أنه حاصل تكامل حضارة الشرق والغرب وهو نموذج لتعددية الحضارة الأندلسية التي مزجت الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية المسيحية في منطقة متشبعة بالحضارتين اليونانية والرومانية، فهي قد رصدت أصداء طوق الحمامة في الشعر الغنائي في أوروبا ومن ثم امتداد هذه الأصداء إلى الرواية الرومانسية، ولم يتوقف هذا التأثير عند حدود الأدب والفنون، بل تجاوزها “فعناصر الحضارة الأندلسية هي التي شكلت عناصر الحضارة الرومانية اللاتينية في ما بعد”.
وهكذا فليس من حضارة عذراء، غير أن المؤثر الأندلسي الذي نشأ في شبه الجزيرة الإيبرية، ثم امتد إلى أوروبا وأميركا اللاتينية ، ما زال حاضرا بهذا القدر أو ذاك.




























