أدب مقموع في العالم العربي يتحاشاه جميع الكتّاب

لأسباب وعوامل معيارية وشخصية وموضوعية وحضارية لا يزال الأدب العربي يفتقر إلى مخزون كاف من الكتابات التي تنقل حياة الكاتب المبدع وتفاصيل حميمة من يومياته بتجرد وشفافية وصراحة، في تجربة غاية في الجرأة والكشف يطلق عليها أدب الاعتراف الذي ذهب الغرب مسافة بعيدة في عرضه أمام القارئ دون عقد ولا إكراهات وخلدت قامات كبيرة في هذا المجال نذكر جان جاك روسو ونيتشه وبودلير، لكنه ظل نادرا عربيا.
على خلاف الغرب فإن الثقافة العربية لا تتحمل أدب الاعتراف الذي يتجرأ على الكشف وتعرية طبقات سميكة من جلد الكاتب والمجتمع الذي يعيش فيه على حد سواء كحاضن ومشكل لتجربة الكاتب.
في التجربة العربية المعاصرة بالخصوص تم تخليد أسماء تفوقت في الاعتراف بصدق وجرأة أدبية لافتة، وهي من الندرة بشكل يصعب معه الركون إلى مقولة وجود أدب اعتراف عربي قائم الذات، لاسيما وأن أعمال كـ”الخبز الحافي” لمحمد شكري شكلت فلتة كبيرة في هذا الصنف من الأدب القائم على المكاشفة والتجرد، مقارنة بالقرون الماضية عندما كان الكاتب العربي آنذاك أكثر جرأة في الاعتراف بما يختلج بداخله على الأقل.
أدب الاعتراف صنعة فردية لتجربة جوانية تساهم في نضجها سياقات ثقافية وسيكولوجية وأيديولوجية ودينية، لا تنظر إلى النجاحات فقط، بل تركز على السقطات دون خجل ولا وجل، الشيء الذي يعطي لقصة الكاتب روحا متجددة تنبعث كل مرة وتساهم في ردم التابوهات وتمديد مساحة الحرية والإبداع والخلق.
كان الاعتراف فرصة للتطهر من النقائص والتحرر من الذنوب كما صاغه قديسون ورواد الكنيسة منهم أغسطين، وكما التقطه كتاب غربيون وعلى رأسهم جان جاك روسو الذي كتب اعترافاته لإراحة ضميره، عكس الثقافة العربية التي تشجع على الستر وعدم اللجوء إلى فضح السلوك الفردي والجمعي.
وبصيغة قاطعة لا يوجد فن “السيرة الاعترافي” في العالم العربي، كما يؤكد الكاتب العراقي علي بدر، فهذا الانكشاف يعرض المرء في الإطار الثقافي والاجتماعي إلى نوع من الإذلال أو الفضيحة، ويتلاقى في هذا الرأي مع الروائي الراحل عبدالوهاب الأسواني الذي نفى أن يكون أي شخص في مجتمعاتنا العربية اعترف بشكل كامل إلا في استثناءات التي لا يقاس عليها بالطبع، ويمكن للكاتب أن يخفي ما اقترفه في شخصيات قصصية متخيلة.
البعد عن الصراحة في اعترافات الكتاب العرب يردها البعض إلى الخوف من بطش المجتمع المحافظ ومؤسساته
ولهذا ستكون استرجاعات الذاكرة البعيدة والحميمة بشكل صادق في أدب الاعتراف الذي يرتكز على البوح والإفصاح عند الكتاب العرب مرتبطة بسياقات وأبعاد نفسية واجتماعية وسياسية وثقافية وحضارية وهوياتية، كان بالإمكان أن تصبح شهادة عميقة قد ترقى بأدب الاعتراف إلى مصاف وثائق ومصفوفات يمكن الاعتماد عليها في الأبحاث الاجتماعية والأنتروبولوجية والتاريخية.
وما دام أدب الاعتراف يعد رافدا مهما يصب في بحر السيرة الذاتيىة دون أن يكون سيرة، فهو كما يقول الكاتب خيري شلبي، جنس أدبي يقرر من خلاله صاحبه البوح والإفصاح حتى يريح ويستريح وهذا الجنس الأدبي مليء بالأشواك ولذلك لم يطرقه سوى قلة من الأدباء العرب رغم أنه شائع في الغرب ويعتبرونه في مقدمة الإبداع الأدبي من ناحية القيمة والمصداقية.
وأدب الاعتراف لم يكن فرديا محضا، عند إيهاب النجدي صاحب “أدب الاعتراف..مقاربات تحليلية من منظور سردي”، خصوصا حين يحلل نقائص المجتمع، ومثالبه التي ليس في مقدور وجوده الجمعي الإقرار بها، فيأتي الاعتراف مصحوبا بسياق عام، تصطرع بداخله نظم الأخلاق والسلوك والتعليم والتربية والأعراف، ويقف عند التكوين النفسيّ للمجتمع، ويسعى للتغلب على معوقات التنشئة القويمة، ومعضلات التربية السليمة.
وحتى لا نسقط في ثنائية الصادق والمدعي من الأدباء الذين كتبوا اعترافات فضائحية فالأهم هو مدى انتشارهم وجودة منتوجهم كون هذا الأدب عربيا لم يأخذ مساره السردي بشكل واضح ونوعي نظرا إلى رد فعل المجتمع بشكل عام الذي دائما ما يكون ساخطا وعنيفا ضد من يتجرأ على فضح مستوره.
بين الحرية والهوية

يمكن إرجاع ندرة أعمال أدبية تفتش في خصوصيات دقيقية من حياة الكاتب إلى ظروف مجتمعية خالصة تسيطر عليها ثقافة الحذر من البوح الذي قد يحطم بعض التابوهات والمتاريس التي صنعتها ظروف سياسية واجتماعية وثقافية جعلت منسوب الحرية منخفضا بدرجة لا يستطيع معها الكاتب العربي أن يكشف عن ذاته للعموم، ثم هناك بعض الكتاب لا يملكون بالفعل تجارب حياتية متنوعة وغاية في العمق والثراء الفكري والحضاري يمكن الارتكاز عليها في صناعة كتابة تمتاز بالتجرؤ على البوح والاعتراف.
الاعتراف كحكي لا يمكن أن يكون ذا فعالية وقوة وتأثير حتى يصبح عامل جذب لأكبر عدد من القراء، وهنا لا بد من استحضار السياقات التاريخية والسياسية والسيكولوجية والاجتماعية المتحكمة في البنية الذهنية للكاتب العربي التي بإمكانها أن تؤهله أو تكبح أفكاره عن الذهاب بعيدا في عملية البوح والاعتراف.
وإذا عدنا إلى روسو رائد الاعتراف بعد القديس أغسطين، فقد أراد أن تكون اعترافاته شيئا فريدا من نوعه لن يأتي أحد بمثلها فها هو يقول في بداية كتابه “الاعترافات”، “إنني أعتزم عملا لم يكن له قط من نظير ولن يقلده أحد أبد الدهر إذ أريد أن أرى أمثالي من الخلق إنسانا على تمام سجيته، ذلك الإنسان هو أنا”. لكن جاء بعده أدباء وكتاب غربيون توسعوا في الحديث عن سيرهم وكشفوا المستور، لكن هل يمكن القول على الأدباء في الثقافة العربية بأنهم كانوا كلهم على سجيتهم مثل روسو؟ لا أعتقد ذلك وبشهادة العديد من المؤرخين وعلماء الاجتماع العرب.
هوية الكاتب هي الرافد والهدف من وراء مغامرة أدب الاعتراف، ولهذا يؤكد الأكاديمي عبدالله إبراهيم في كتابه “السرد والاعتراف والهوية”، أن الهُويّة سواء كانت فرديّة أم جماعيّة، فلا يمكن انتزاع الكاتب من الحاضنة الاجتماعيّة والثقافيّة التي يشتبك بها؛ ذلك أنّ أدبه يقوم بمهمّة تمثيلها، وبيان موقعه فيها، فلا يطرح موضوع الهُويّة في السرد، والاعتراف بها، إلاّ على خلفيّة مركّبة من الأسئلة الشخصيّة والجماعيّة، وتبادل المواقع في ما بينهما؛ فالكاتب منبثق من سياق ثقافيّ، وتجد الإشكاليّات المثارة كافّة في مجتمعه درجة من الحضور في مدوّنته السرديّة.
وعلى هذا الأساس قطعت كتابة محمد شكري شوطا كبيرا في التعبير عن هوية الكاتب المتمردة والتي لم تكن متمركزة فقط على ذات الكاتب بل تعدته إلى جوانب من حياة الآخرين، وإذا فحصنا اعترافاته من خلال بوابة “الخبز الحافي”، الكتاب الذي لاقى شهرة واسعة في الغرب والتضييق بعدم نشره في المغرب والعالم العربي، نجد المتن قد جاء كاشفا صادما معريا للكثير من المكبوتات فضح الكاتب في اعترافاته ما يعتمل داخل المجتمع من تناقضات بلغة سلسة وفاسقة إلى حد كبير.
وهناك من يصنف “الأيام” لطه حسين وكتاب “أنا” للعقاد أو توفيق الحكيم في “سجن العمر”، أو “أوراق العمر” للويس عوض كسير ذاتية منطقت الأشياء والناس حسب تمظهراتهم الحياتية دون الكشف الصريح لدقائق معيشهم وإخفاقاتهم الخفية، وليس بالضرورة أن تكون درسا في الأخلاق أو التربية، ولهذا لم ترق إلى عملية اعتراف صريح كما كتب محمد شكري، الذي تجرأ على الكشف بجمالية ودهشة عن المكبوت إلى جزيئات تعتمل داخل المجتمع والناس. كما أن الالتباس المفزع بين مفهومي الفن والأخلاق قد يعتبر مانعا سيكولوجيا لدى الكاتب يفقده القدرة على البوح ومما يجعل أدب الاعتراف في أزمة مزمنة لدى الكتاب العرب في وقتنا هذا رغم الانفتاح الذي سهلته الثروة البيوتكنولوجية في عصرنا الحالي.
أما اعترافات جان جينيه يمكن اعتبارها صادمة ولا تتماشى مع السائد في مجتمعات عربية كما أنها تتماهى مع تلك السرديات التي تعتبرها لا أخلاقية وتثير الفتنة، وهذا ما ضيق على أدب الاعتراف في السرديات العربية، إلا القليل الذي نجا من مقصلة الرفض ببسالة.
روسو تفاعل مع عصره فأبدع كتابات لازالت تمثل نموذجا جديا في أدب الاعتراف، إذ كان الرقيب الذاتي عند هذا الكاتب في أدنى مستويات عمله، ما ساهم بشكل كبير في خلق هامش كبير من الحرية استثمرها روسو في رصد كل تفاصيل حياته بجرأة كبيرة، عكس ما نجده لدى زمرة من الكتاب العرب الذين طغى عليهم ذلك الرقيب الذاتي منعهم من التمادي في كتابة اعترافاتهم وكبتها إلى الأبد.
أما الروائي والكاتب المصري نجيب محفوظ فقد كان ذكيا عندما قال “لم أفكر في كتابة سيرتي الذاتية ووضعها في كتاب مستقل؛ لأنني كتبت سيرتي في رواياتي وقصصي”، فهو كروائي عربي ينتمي إلى مجتمع محافظ ويعي جيدا القوانين التي تحرك بيئته السياسية والاجتماعية والتربوية فلم يقترب من موقد نار الاعتراف بل ألبس أجزاء من حياته الخاصة لشخصياته الروائية دون أن يتحدى مجتمعه ويتجرأ على إسقاط الأقنعة.
بإجماع متخصصين في الدراسات الأدبية وعلم الاجتماع فإن أدب الاعتراف لن ينتعش في ظل بيئة سياسية واجتماعية وثقافية تنظر للبوح على أنه شبهة وتهديد للتقاليد التي تأسس عليها المجتمع العربي، هذا الأخير الذي طبع منذ زمن بعيد مع المداراة والتستر على السلبيات وإظهار الإيجابيات ولو نفاقا، حتى إذا عرجنا على أسماء كاتبات عربيات نجد أنهن لم يتجرأن كذلك على فضح المستور وعصيان النظام العام داخل المجتمع حتى الشهيرتين نوال السعداوي وغادة السمان لم تكونا صريحتين جدا وكاشفتين للذات إلى حد بعيد في مؤلفيهما على التوالي “أوراق حياتي” و”رسائل غادة السمان وغسان كنفاني”.
أدب منبوذ
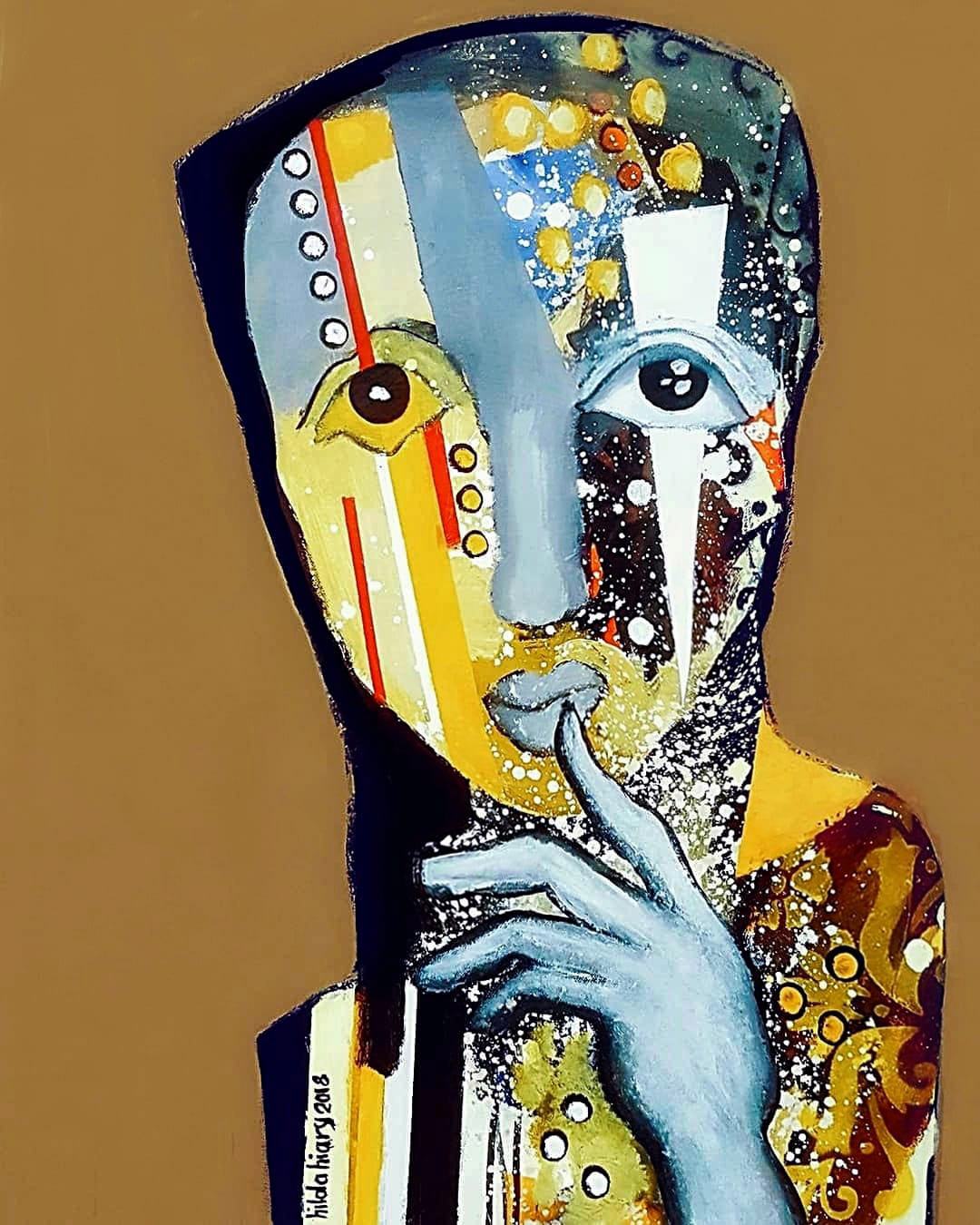
لماذا يعتبر أدب الاعتراف محطّ شبهة وموضوع ارتياب في العالم العربي، سؤال أجاب عليه الناقد العراقي عبدالله إبراهيم، كون الجمهور لم يتمرّس في قبول الحقائق السرديّة والواقعيّة، فيرى في جرأة الكاتب على كشف المستور سلوكا غير مقبول، وإفراطا في فضح المجهول، فالاعتراف محاط بالكثير من ضروب الحذر في مجتمعات تقليديّة تتخيّل أنّها بلا أخطاء، فتبالغ في ذكر نِعَم الله عليها، وكأنّها هبات خُصّت بها دون سواها، وتتحاشى ذكر عيوبها، وتتوهّم أنّها تطهّرت من الآثام التي واظبت على اقترافها مجتمعات أخرى، فتدفع المخاوف كثيرا من الكتّاب إلى اختلاق تواريخ استرضائيّة لمجتمعاتهم، وابتكار صور نقيّة لذواتهم، متجنّبين كشف المناطق السرّيّة في تجاربهم، وإظهار المسكوت عنه في مجتمعاتهم، فصمتوا عمّا ينبغي عليهم قوله أو زيّفوا فيه، وربّما أنكروا وقوعه، يريدون بذلك الحفاظ على الصور الشفّافة لهم ولمجتمعاتهم·
مع محمد شكري، الكاتب المغربي صاحب رواية الخبز الحافي كان الأمر مختلفا إلى أبعد حد، فقد وصف بشكل دقيق أول لقاءاته الجنسية مع المرأة الأولى داخل ماخور، بعدما كان يسرق نقود أمه كي يشتري معجون الحشيش والكيف، والذهاب إلى السينما، واعترف شكري بأن القهر والألم والغضب من أبيه كانت دوافع قادته إلى معرفة كل من له علاقة بالعالم السفلي من مجتمع طنجة شمال المغرب، ففضح بكل ما أوتي من قوة ذلك المجتمع الذي قاده للانحراف، من خلال الكتابة.
حتى الأديب اللبناني سهيل إدريس لم يسلم من سهام نقد لاذع وعنيف من طرف عدد من النقاد بعدما أقدم على نشر “أصابعنا التي تحترق”، عالج فيه مجموعة من الأحداث والتفاصيل يمكن تصنيفها ذات حساسية بالنسبة لمجتمع عربي محافظ ومتستر على نقائصه، رغم أن سهيل إدريس في مغامراته النسائية وعلاقته بوالده باستخدامه
التلميح وسيلة للمداراة، لم يرق إلى إفصاح ومكاشفة محمد شكري الذي ترجمت روايته إلى أكثر من عشرين لغة.
فالاعتراف كما يرى إيهاب النجدي، في مؤلفه “أدب الاعتراف.. مقاربات تحليلية من منظور سردي”، يستقر في أذهان الكثير من الناس في باب المسكوت عنه، ويحاط بالظنون والشبهات، على كل الصعد، ومنها صعيدا الأدب والنقد، وتتحرك هذه المقاربات صوب ثقافة عربية تبجّل الستر، وتميل إلى طي الصفحات الماضية أو السوداء، وتؤثر السلامة، وهي رجع صدى لإرث عريق في المدائح والمفاخرات، تجانب الإفصاح عن الأخطاء، وتتحاشى الكشف عن مرات السقوط في حركة الحياة، فبدت جمهرة السِّيَر -غيرية وذاتية- نقية نقاء الثوب الأبيض في رائعة النهار.
بالتالي فإن رصد الحقيقة عارية فاضحة شفافة يتطلب جرأة كبيرة وهي التي يفتقر إليها الكاتب العربي في سيرته الذاتية كاعترافات، كما أن ربط الواقعي بالمتخيل في عمل الكاتب يقلل من قوة ومصداقية مسيرته الحياتية، حيث يتفنن في تغطية أحداث ووقائع حقيقية بجلد سميك من الخيال حتى لا يتم نبذه مجتمعيا الشيء الذي يجعلنا لا نتحدث عن أدب اعتراف.
بيئة طاردة
البعد عن الصراحة في اعترافات الكتاب العرب يردها البعض إلى الخوف من بطش المجتمع المحافظ ومؤسساته، على اعتبار أن الاعتراف بالأخطاء والسلبيات ومكامن الضعف في حياة هذا الكاتب تنسحب على منظومة تربوية وسياسية واجتماعية وتعليمية ساهمت في تشكيل وعي وذهنية ونفسية ذلك الكاتب، وأي بوح فهو يعري الغطاء عن أسرار كثيرة لا يود الكثير كشفها.
قوبل مؤلف الخبز الحافي بالصد وعدم القبول بعدما تمت ترجمته إلى العربية في سبعينات القرن الماضي، إذ تمت مهاجمته بعنف وضراوة ومنعت في عدد من الدول العربية وتم التضييق على صاحبها كونه كشف جانبا مستورا من حياة الكاتب والمجتمع على حد سواء.
ولهذا نتماهى مع رأي إيهاب النجدي، في هذا النوع من الاعتراف الذي يصفه جدولا يشق طريقا محفوفا بالمخاطر، يتسع ويضيق على قدر ما يمتلك صاحب السيرة من شجاعة الصراحة، والاطمئنان إلى المكاشفة مكاشفة الذات والآخر معا، والاعتصام بالصدق -النسبي بالتأكيد- لا يرده عنه إلا عارض من نسيان، أو إثارة من خوف ومداراة.
ويمكن أن يكون ضمير الغائب عائقا في إيصال الفكرة والتجربة الحياتية للكاتب وهو بمثابة تحايل على سطوة المتلقي والمجتمع، وهو ما جعل أدب الاعتراف عندنا يفتقر إلى التراكم والجدية والتجرد في تناول مسارات حياة الكاتب بنجاحاتها وكبواتها وألمها وآمالها وأوقات ضعفها ونقاط قوتها كشخصية تتفاعل مع أحداث الواقع ومتغيراته وتاريخه، قول الحقيقة مجردة وتكريسها كمبدأ غير قابل للتجزئة في الحياة الشخصية وكخاصية أصيلة في أدب الاعتراف لا يمكن أن تجدها لدى العديد من الكتاب العرب.
الصراحة في تناول حياة الأديب لها ضوابط وقيود لا يمكن التنازل عنها حتى تكون العملية الإبداعية ناضجة ومسؤولة وذات قيمة أدبية، فحياته اليومية تتأثر بظروف عيشه وعلاقاته الشخصية والعامة وتدوينها يتطلب قدرا كافيا من الحس الإبداعي والحرية في تناول بعض الدقائق التي تغيب عن القارئ، وهذا أيضا يرتبط بالنظم السياسية والثقافية والحضارية والاجتماعية التي يمكن أن تكون مشتلا لهذا الصنف من الإبداع كما يمكن أن تكون مقبرة للكاتب نفسه إن هو تجرأ على الاعتراف.




























