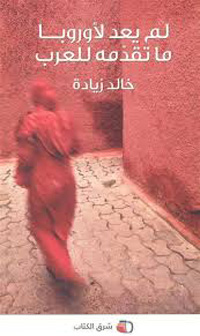خالد زيادة: لا بد من مشروع عربي جامع وعلى العرب صناعة أفكارهم

بعيداً عن السياسةِ وقريباً من التاريخِ والأدب، سنخرُجُ مع ضيفِنا في هذا الحوار عبر صفحاتِ العرب من بوابَةِ سفارةِ دولةِ لبنان في القاهرة حيثُ يُمثِّلُ بلادَهُ بصورةِ الأكاديمي والمثقَّف والأديب، سنغوصُ بعيداً في تاريخِ الحاضر وحاضرِ المستقبل بحثاً عن فهمٍ لما يحدُث من حولِنا، فصاحبُ السعادةِ اليوم نستقبلهُ بثوبِ الأديب وحضور الخبير التاريخي الذي عرَفَ أوجاعَ هذه الأمَّة سبراً في الإصدارات الأكاديمية والبحثية والسردية الروائية، تلكَ الأخيرةُ التي حقَّقت شهرةً واسعةً بثلاثيَّتِهِ التي حكى من خلالها تاريخَ مسقطِ رأسِهِ في طرابلس اللبنانية مُضمِّناً إياها جزءاً من سيرتِهِ الذاتية.
سيرتُهُ التي بدأت في الشمال اللبناني حيثُ وُلِد في طرابلس عام 1952 م، وحصَلَ على إجازة في الفلسفة من الجامعة اللبنانية وليُتابِع مسيرتَهُ العلمية حيثُ حازَ على درجة الدكتوراه في الفلسفة والأدب من جامعة السوربون في باريس، لهُ العديد من الأبحاث والدراسات الأكاديمية والأدبية فضلاً عن انشغاله الأدبي من خلال السرد الروائي، يُعتَبَر الدكتور خالد زيادة مُفكِّراً عربيَّاً لهُ حضورُهُ الأدبي والأكاديمي والسياسي حيثُ يشغل منصب سفير دولة لبنان في جمهورية مصر العربية ومندوب بلاده الدائم في الجامعة العربية منذ عام 2007 م.
رؤية بانورامية
بدايةُ حديثنا أسألُهُ عن سياسيّي العهدِ الأوَّل في الثورة العربية الكبرى، فهل وقعوا في الخطأ حينَ طالبوا بالاستقلال دون الحريَّة فأنتجوا لنا نحنُ الأجيال اللاحقة حياةً معطوبة، ليقول إنَّ الحديث عن الخطأ ممكنٌ حين يتعلق الأمر بقرارات يتخذها فرد أو أفراد في موقع المسؤولية، أما الثورات فإنها تندرج في سياقات ينبغي البحث في مسبّباتها ونتائجها بالنظر إلى الظروف المحيطة بها.
الثورة العربية الكبرى التي انطلقت في الحجاز عام 1916 م تأتي في سياق متصاعد من الأحداث المتسارعة في مطلع القرن العشرين، ففي عام 1908 م حدث ما يعرف باسم الانقلاب الدستوري في إسطنبول والذي أعاد العمل بالدستور الذي عطله السلطان عبدالحميد عام 1877 م، هذا الانقلاب أطلقَ حركات سياسية كان شعارها الحرية والمساواة تأثراً بشعارات الثورة الفرنسية الكبرى، في نفس الوقت الذي أطلق فيه المشاعر الوطنية للشعوب المنضوية حتى ذلك الوقت في الدولة العثمانية.
المشاعر الإسلامية كانت موضع تلاعب واستغلال ومثال ذلك تشجيع الولايات المتحدة الأميركية للاتجاه الإسلامي في تركيا بهدف الوقوف ضد الاتحاد السوفييتي ثم استخدام الدين في أفغانستان في الصراعات الدولية ثم اقتحام رجال الدين في إيران للمجال السياسي وإقامة نظام يستند إلى مرجعية مذهبية
وكان لاندلاع الحرب العالمية أن يسرِّع الأحداث، يتابعُ ضيفُنا بأنَّ الثورة العربية الكبرى هي نتيجة لتنامي الوعي بالعروبة على امتداد عقود سابقة. وقد جاءت الحرب العالمية واشتراك الدولة العثمانية التي كان يحكمها آنذاك حزب الاتحاد والترقي ذو النزعة القومية التركية، مناسبةً لإطلاق شرارة الانفصال عن الدولة العثمانية.
بشكلٍ أو بآخر يقول الدكتور خالد زيادة إن الثورة العربية عام 1916 م لم تحقِّق مشروعها أو حلمها بإقامة مملكة عربية بسبب المطامع الاستعمارية الإنكليزية والفرنسية، ولكنّها أكدت الانتماء العربي لسكان المشرق العربي، وكانت الفاعل في ولادةِ لبنان وسوريا والعراق والأردن وفلسطين.
فكرة الاستقلال عند ضيفنا تنطوي على مفهوم الحرية، إلا أن الحرية تعني تحرير شعب أو أمّة أو جماعة، وليس الحرية الفردية بمفهومِها الذي أطلقته الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان.
أستاذُ الفلسفةِ يدعو إلى تركِ الحقبات التاريخية المغرقة في القِدَم طالباً قراءَةَ التاريخ الأقرب عهداً، في القرن التاسع عشر حينَ بدت كل الشعوب ذات التاريخ العميق عاجزة أمام طغيان الحضارة الأوروبية كما يقول.
لماذا نهضت الصين والهند واليابان وكوريا وماليزيا؟ يطرحُ ضيفُنا هذا السؤال ويتابع المشهد ناظراً إلى المنطقة العربية التي غرِقَت في التأخُّر رغمَ أنَّها عرَفَت النهضَةَ في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر في مصر مع محمد علي باشا، هذا الإخفاق يردُّهُ الدكتور زيادة إلى ما أسماهُ إخفاق القومية العربية الراديكالية، التي عجزت عن تحقيق أيّ من شعاراتها، فلا هي حقّقت الوحدة العربية ولا هي انتصرت على إسرائيل، بل أورثتنا أنظمة فاشلة في الاقتصاد سلبت الشعوب حرياتها ومبادراتها.
|
حكاية فيصل
“التاريخُ لا يُعيدُ نفسَهُ” هكذا يؤمنُ السفيرُ اللبناني في القاهرة، هوَ الذي تناولَ التاريخ كعامل موضوعي وبنيوي في روايتِهِ “حكاية فيصل” التي تتحدَّثُ عن الثورة العربية الكبرى، الروايةُ كما يراها اليوم تعيش ازدهاراً عالمياً واسع النطاق.
رواية طرابلس
حديثُهُ عن السرد الروائي دفعني لسؤالِهِ عن تحوُّلات المكان تاريخياً وسياسياً في مدينتِهِ طربلس التي تناوَلَها أدبياً في ثلاثيَّتِهِ “يوم الجمعة يوم الأحد، حارات الأهل، بوابات المدينة” ليقول إنَّهُ اختارَ الكتابةَ عن المدينة بمادةٍ سوسيولوجية وأنثربولوجية. المادة السوسيولوجية تتعلّق بالتحوّلات تحت تأثير الحداثة العمرانية. والجدلية بين القديم والحديث، أما الأنثربولوجية فهي تتعلق بالثنائيات مثل تأرجح المدينة بين النهر والبحر، والعلاقة بين المسلم والمسيحي، وعلاقة الحداثة بالأوقات كيوم الجمعة يوم الأحد، وبالليل والنهار.
بالانتقال إلى موضوعٍ آخر يتناولُ ضيفُنا في الكثير من أبحاثِهِ فكرةً تقوم على ضرورةِ مواجهةِ التطرُّف بالفكر، أسألُهُ عن فهمِهِ لآليَّةِ المواجهة ليقول إنَّ الحركات المتطرفة على تنوعها تدَّعي أنها تمتلك مشروعاً يستند إلى مرجعية فكرية هي الشريعة.
ومن هنا تكمنُ الحاجةُ -والحديثُ لأستاذ الفلسفة- إلى أفكار لمجابهة هذا التطرف، بل تحتاج إلى قاعدة نظرية، على غرار التجارب الإنسانية في العصر الحديث، فرنسا على سبيل المثال تستند إلى مبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والمساواة، ومبدأ الجمهورية هو الذي يحكم الحياة السياسية. والولايات المتحدة الأميركية تستند إلى المبادئ الليبرالية والدستور الذي صاغه الآباء المؤسسون، متابعاً إنَّ العرب صاغوا فكرة القومية العربية بين الأربعينات والستينات من القرن الماضي، تلكَ الفكرةُ مستندة إلى مبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة.
|
مشروع نهضوي
يؤكِّدُ ضيفنا أنَّهُ في تلك المراحل كان للأفكار الأوروبية تأثيرها الواضح على تطور الفكر العربي. لكننا اليوم نشهد انحسارا للتيارات الفكرية الكبرى على المستوى الإنساني الشامل، ومن هنا تبرُزُ الحاجة لضرورة أن يُنتِجَ العربُ أفكارَهُم فما يدعو إليهِ الدكتور زيادة هو استعادة تراث النهضة والإصلاح والبناء عليه من أجل صياغة أفكار تناسب واقعنا وعصرنا، ضرورةُ العودةِ إلى تراث النهضة لأن النهضويين صاغوا ما يمكن اعتبارَهُ برنامجاً يتأسس على مبادئ وأفكار الحرية والدستور والتربية وتحرير المرأة، وهي أمور لم ننجح في إنجازها -بحسبِ ضيفنا- فلا بد من وضع تصورات وبرامج تستند إلى هذه الأفكار.
في ظلِّ ضرورةِ هذا المشروع النهضوي الشامل أسألُ ضيفُنا الأكاديمي والسياسي والأديب عن دور المثقف ووظيفته ظلّ ما يحدث لنا ومن حولنا، ليقول إنَّ وظيفةَ المثقَّفِ تتلخّص بأن يؤدي عمله بكل ما يتطلبه الأمر من إتقان، فنحن بحاجة إلى الكاتب المبدع والأستاذ الجامعي الذي يعلي شأن العلم والإعلامي الذي يقدم الحقيقة إلى الجمهور بينما على ذات السياق فإنَّ مهمةً كبيرةً تقعُ على كاهلِ رجال الفكر من المشتغلين بالفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ بالإسهامِ في إنتاج الأفكار التي تشكل أساساً لرؤيتنا لذاتنا ومستقبلنا.
كاتب من سوريا