العدو الثقافي
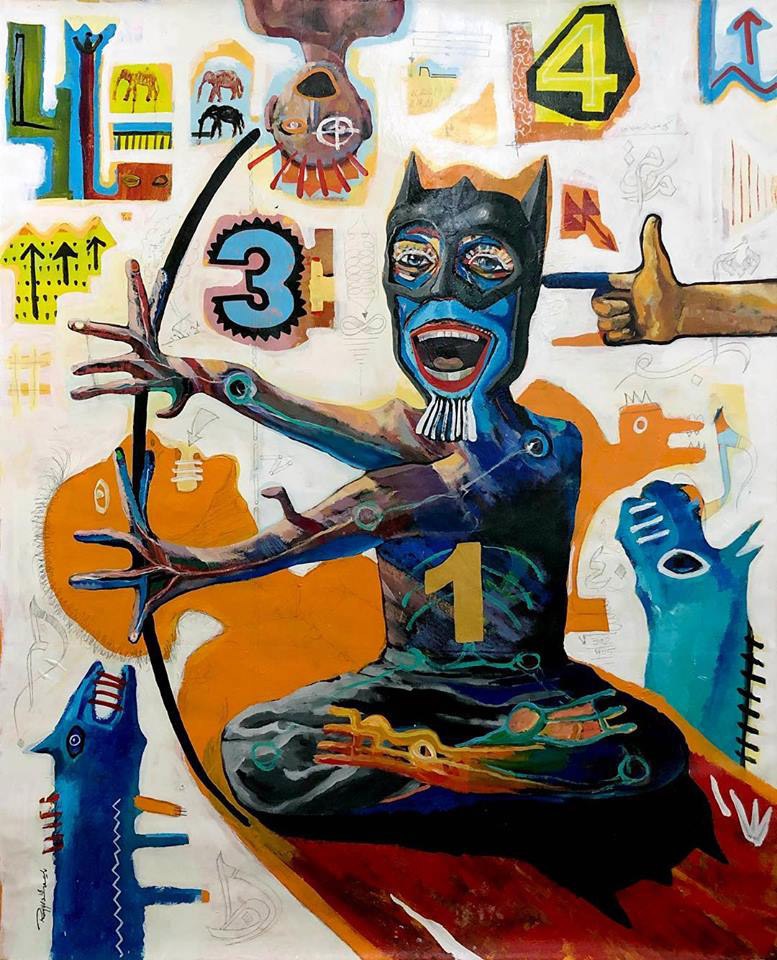
الآخر في غالب الأحيان هو النقيض الذي يحملُ من الصفات ما لا تحمِله الذات، فقد يتشكل الآخر من قلب الثقافة الأم، وقد يكون عابراً للأوطان والجغرافيا بصفته الاستعمارية أو الاستيطانية، فحضور الآخر في ذاتنا يضعنا وإياه في مواجهة مباشرة؛ تكون لمرة واحدة في بعض الأحيان وقد تدفع -هذه المواجهة- بأحدنا نحو مربَّعٍ مختلف فإما يحدث التقارب وإما يقع التنافر الذي تعزِّزهُ النقائض التي يدَّعي كل طرف عدم وجودها لديه.
فكيف يُخلَقُ العدو الثقافي الذي هو الآخر في أحد تجلياته؟ أعتقد أن الآخر وُلِد في اللغة مع استخدام الضمير ومقابله، فعندما نقول “نحن” نُضمِر فوراً أنَّ على الطرف الآخر هناك “هم”، وعندما نقول “هم” فإن الإشارة الخفية تكون إلى “نحن”، ومن هنا هل يمكن القول إن أيّ ثقافة “وطنية” تبحث عن عدو حتى تضمن استمرارها؟ فهل يتغير العدو الثقافي مع تقادم الأيام، إذا كان التاريخ ليس فقط وحدات زمنية متتالية تتوالد من بعضها، وإنما الحاضر اليوم الذي سيغدو تاريخاً غدأ يتأثر بجملة من العوامل التي ترسِّخ وجود “العدو الثقافي” الذي يٌستَعادُ نشاطهُ دائماً في الحاضر المُتَأثِّر بشكل مباشر بما مضى في التاريخ، كيف ممكن أن نفهم مثلاً وجود العدو الثقافي “التركي” بشكل دائم في روايات نيكوس كازانتزاكيس الذي وُلِد وعاش ودُفِنَ في جزيرة كريت اليونانية التي حمَل مطارُها الرئيسي اسمه، واحتفت به كما يليق بكاتِبٍ أعادَ وضع الجزيرة على خارطة الذهنية العالمية بعد أن نقل جغرافيتها من المحلية إلى العالمية.
بناء على هذه الصورة العامة للتأثيرات التاريخية على صناعة العدو الثقافي في المرويات سواء كانت مدوَّنة مكتوبة أم شفوية منقولة عبر الحكايات الشعبية، وبالنظر إلى الحالة العربية أستطيع القول إن صورة العدو الثقافي ظهرت بشكل واضح في المرويات الشعبية، وتحديداً عندما صار اليهودي في الذهنية العربية مرتبطاً بالإسرائيلي الذي استخدم النص الديني اليهودي للاستيلاء على الأرض العربية، ثم تأثّر شكلُ هذا “العدو الثقافي” بكثير من التصورات التاريخية والآنية والمُفترَضة مستقبلاً.
تحمل صورة الآخر غالباً مخاوف بعضها حقيقي وبعضها مُتخيَّل، وهذه تمثِّل المعادلة الصارمة لتشكُّل ثنائية "نحن، هم"، فكُل ما يأتي من الآخر سواءً كان إنتاجاً ثقافياً أو معرفياً إنسانياً، هو خاضعٌ بالضرورة لمسافة التوتر الموجودة أصلاً عند المتلقي الذي يقف على الضفة الأخرى
تحمل غالباً صورة الآخر مخاوف بعضها حقيقي وبعضها مُتخيَّل، وهذه تمثِّل المعادلة الصارمة لتشكُّل ثنائية “نحن، هم”، فكُل ما يأتي من الآخر سواءً كان إنتاجاً ثقافياً أو معرفياً إنسانياً، هو خاضعٌ بالضرورة لمسافة التوتر الموجودة أصلاً عند المتلقي الذي يقف على الضفة الأخرى دائماً، وهذه المسافة تقتلُ الوهجَ المُفتَرَض حدوثه عند وقوع الاتصال مع الحكاية، فإذا كانت نظرية الاتصال في علوم اللسانيات قائمة على عناصر متنوعة أبرزها اتفاق المرسل والمستقبل على رموز فك الشيفرة الناقلة للرسالة ضمن وسطٍ متجانس بين الطرفين، فإن الرسالة التي تنتقل بين ثنائية “نحن، هم” يصطدم وسطها الناقل بكثير من العقابيل التي تفرِضُ إعادة الرسالة إلى مرجعيات كل طرف سواء في تصديرها أو تلقيها.
يلجأ “العدو الثقافي” دائماً إلى الإقصاء من خلال تغييب الطرف الآخر وتسخيف روايته أو تجاوز وجودها بالمطلق، كما حدث مثلاً في الأندلس عام 1502 حين فرض القشتاليون ثقافتهم باعتبارها ثقافة المكان الأصلية، متجاوزين أكثر من 800 عام من الثقافة التي أضحت -حتى اليوم- جزءاً رئيسياً من المكان، وبإمكان الزائر تلمُّسَها في نواحي الجغرافيا بمجرد زيارته هناك، هذا الحال ينطبق على الطرفين فمسألة تكوين الآخر خاضعة بشكل مباشر لجملة من حسابات القوة والتفوُّق والاختلاف المُسنَد إلى قيمة معيارية غالباً ما تصنعها الثقافة الشعبية بدفعٍ أساسي من آلة دعائية إعلامية أو توجيه سياسي أو تغذية دينية والأمثلة كثيرةٌ في الوطن العربي على هذه الحالات.
إن نشوء “العدو الثقافي” أو “الآخر” هي حاجةٌ متأصِّلةٌ في كل ثقافةٍ حتى تتجاوز أزماتها الداخلية، والآخر قد يكون خارج الحدود وعابراً للجغرافيا السياسية كما في حالات الاجتياحات العسكرية أو الاستعمار أو الاستيطان، وقد يكون داخلياً تحتاجُهُ الذات لتعزيز إحساسها بالتميُّز والتفوُّق ضمن دائرة الانهيار العام التي تعيشها كما يخبرنا التاريخ عن آخر عهد الإمبراطورية العثمانية.
العدو الثقافي “الآخر” الذي يعيش مع نقيضه في ذات الجغرافية يخضع لمفهوم التنميط في السلوك والمظهر وأسلوب الحياة من “الآخر” الذي يشكِّلُ النسبة الغالبة بمعايير العدد والقوة، فيقوم “القويُّ” بربط الآخر “الضعيف” بجهاتٍ خارجية عابرة للحدود عبر مرويات شعبية أو أدبية، بهدف تقزيمه وإخراجِه من دائرة التأثير حتى يغدو عدوّاً حقيقياً عند العامة، وبالتالي فإن الذات الجمعية تحتاجُ آخراً قد تحوِّلهُ إلى عدوٍّ ثقافي تضع فيه كل الصفات التي تتبرأ منها، وحين يكسر المجتمع بفعل قواه المختلفة “السياسية، الاقتصادية، الدينية” فكرة العدو الثقافي مع حفاظه على معاني وضرورة وجود الآخر المختلف غير العدو، حينها فقط يبدأ بصناعة تاريخ جديد.




























