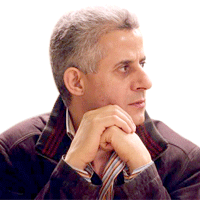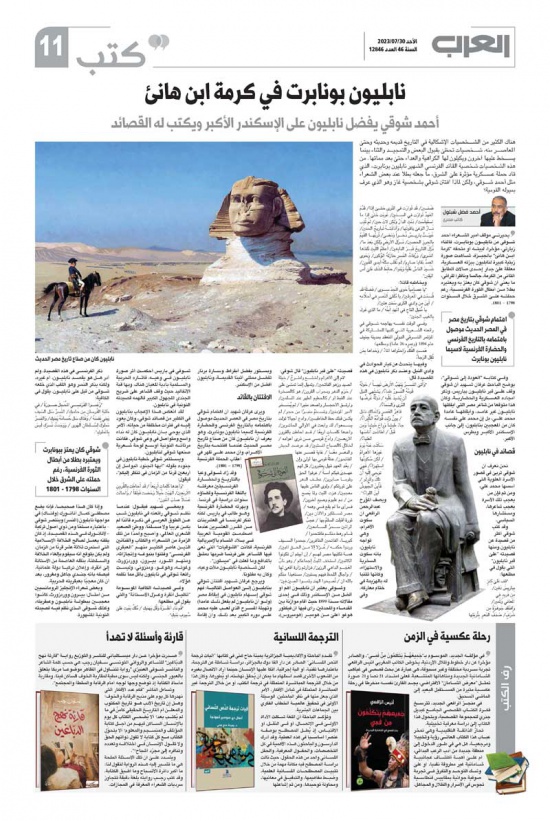مصر تشهد تبديد أكبر مقبرة أثرية في العالم

مفارقة كبرى أن يكوّن المصريون أبرز الحضارات التي تقدس الموتى وتحتفي بالمقابر التي تحولت إلى علامات حضارية إنسانية. لكنها اليوم، وتحت ما يسمى تطوير القاهرة، تتجه مصر إلى هدم مقابر تاريخية تعود إلى قرون خلت. وهو ما يحتاج إلى إعادة تفكير، خاصة لتعارضه مع الاحترام الذي يكنه المصريون للأموات ووعيهم التاريخي بقيمة المدافن.
بعد تبديد أقدم وأكبر جبانة أثرية في العالم، يصير كتاب “مرشد الزوار إلى قبور الأبرار المسمى الدرّ المنظَّم في زيارة الجبل المقطَّم” وثيقة نادرة لمقابر دفن فيها صحابة وتابعون وحكام وأولياء وأعلام. والكتاب يؤرخ لما كان يسمى مدينة الموتى بالقاهرة، ويدين استباحة ما ظل المصريون حريصين على صونه، ورفعه إلى مكانة تتجاوز الهيبة إلى القداسة. ومن أسماء مصر، أو القاهرة، “المحروسة”، لاعتقاد المصريين أنها محروسة بأرواح الأولياء، امتدادا لعقيدة تمثلّها “ماعت” إلهة العدل في مصر القديمة، وأمامها يتبرأ المتوفى من 42 خطيئة، إحداها تلويث ماء النيل، وأشدّها القتل. ويقول القسَم التاسع والثلاثون: “أنا لم أنبش القبور ولم أسئ إلى الموتى”.
كنزٌ أثري روحي، لو تمت رعايته بالترميم والاحترام الكافي لكان منبع إلهام ومصدرا للدخل من عائد السياحة. العائد المادي المباشر هو هدف إدارة تفتقد الكفاءة، وتستسهل تسوّل الأموال والتفريط في ميراث تاريخي. كنزٌ عمراني ومعماري يضم الآلاف من المقابر والشواهد الأثرية، منها أكثر من ألف ضريح بناها الفاطميون وحدهم لآل البيت، وبخاصة سلالة السيدة فاطمة الزهراء والإمام علي بن أبي طالب. ويتيح الكتاب جوانب من سير أصحاب القبور وكراماتهم، وإشارات تاريخية كالنهاية المأساوية للبعض، وأولهم محمد بن أبي بكر الصديق. الكتاب أصدرته الدار المصرية اللبنانية في القاهرة عام 1995، ومؤلفه هو موفّق الدين بن عثمان المتوفى سنة 615 هجرية (1218 ميلادية).
موفق الدين بن عثمان كان فقيها، ونسبه ينتهي إلى الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري، وعاصر شمس الدين بن خلكان مؤلف “وفيات الأعيان”، وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، والقاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي ومستشاره. والكتاب يقع في 783 صفحة، وحققه وعلق عليه ووضع فهارسه المحقق المصري محمد فتحي أبوبكر. وفي نسبة كتاب “مرشد الزوار..” لابن عثمان، استند المحقق إلى ما ذكره مؤرخون استشهدوا بالكتاب. على سبيل المثال أشار تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، المتوفى سنة 845 هجرية، في الخطط المقريزية إلى نسبة قبر الإمام الليث بن سعد إلى صاحبه، بما جاء “في كتاب مرشد الزوار للموفق بن عثمان”.
تاريخ وروايات

وفي كتابه “النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة” كتب أبوالمحاسن جمال الدين بن تغري بردي، المتوفى سنة 874 هجرية، عند حديثه عن قبر الصحابي عقبة بن عامر “وقال الشيخ موفق بن عثمان في تاريخه المرشد: إن البقعة التي دفن فيها عقبة، بها قبر عمرو بن العاص”. وذكر محمد فتحي أبوبكر أن للكتاب صورتين لمخطوطتين مختلفتين. الأولى بمكتبة آيا صوفيا، ونسخها سنة 849 هجرية أحمد بن محمد بن عثمان. والثانية في مجلدين بالمتحف البريطاني في لندن، ونسخت سنة 1015 هجرية، وتخلو من اسم الناسخ. وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة صورتان طبق الأصل من مخطوطة المتحف البريطاني إحداهما غير مكتملة.
وتم تحقيق الكتاب على نسختين مودعتين بمكتبة جامعة القاهرة، مصورتين من نسخة المتحف البريطاني ونسخة مكتبة آيا صوفيا. ومحقق الكتاب ألف كتابا آخر عنوانه “ذيل كتاب مرشد الزوار..”. ليس ذيلا، الأدق أنه جزء ثان لقبور أعلام لم يدركهم موفق بن عثمان، أمثال العز بن عبدالسلام وابن عطاءالله السكندري. الجزء الثاني “الذيل”، مصحوب بصور فوتوغرافية لأوضاع أماكن أثرية وأضرحة ومزارات “بعضها قد قارب على الاندثار” في القرافة الكبرى والقرافة الصغرى. وقارئ الكتاب لا يخطئ جهد المحقق أبوبكر. نسخَ الكتابَ بيده، وضبط نصه وسياقه، وزوده بالهوامش والشروح، وأكمل الفراغات من مصادر استقى منها ابن عثمان مادة كتابه.
الأستاذ الراحل محمد فتحي أبوبكر نموذج نادر لإخلاص المحققين. قابلته مرة في مكتب الناشر محمد رشاد. كان يستعد لتحقيق كتاب عبدالرحمن الكواكبي “طبائع الاستبداد”. أعرته طبعة قديمة، ليعمل عليها. وبعد قراءتي كتاب “مرشد الزوار..” الذي “يُحقّق للمرة الأولى، بعد أن ظل أكثر من سبعة قرون بدون أن يقوم أحد بتحقيقه”، أشعرُ بالأسى لفراغ مجال تحقيق التراث من كبار يمثلون أوتادا للخيمة. فالرجل تعهد مخطوطات هذا الكتاب، حتى بوضع علامات الترقيم، وهمزات القطع والوصل، وتقسيم النص إلى فقرات، وخصص نحو مئة وعشرين صفحة في نهايته للفهارس التفصيلية: الآيات، الأحاديث، القوافي، الأعلام، الأماكن والبلاد والبقاع، الجماعات والقبائل والأمم والطوائف، مراجع التحقيق.
يبدأ “الإمام العارف” ابن عثمان كتابه “مرشد الزوار” بذكر فضل جبل المُقطّم. المقطّم من القَطْم وهو القطع؛ لخلّوه من الشجر والنبات. ويُروى أن المقطم كان أكثر الجبال أشجار ونبتا وفاكهة، حتى الليلة التي كلم الله فيها موسى، وأوحى إلى الجبال “أني مكلم عليكِ نبيا”. سَمَت الجبال وارتفعت إلا جبل الطور، فسأله الله عن السبب فأجاب: “إجلالا لك يا رب”، فأمر الجبال أن تهبه مما عليها من الزرع، “وجاد له المقطم بكل ما عليه”، فعوضه الله بشجر الجنة “أو غرس الجنة، يعني المؤمنين”. وقال عمرو بن العاص للمقوقس: “ما بال جبلك أقرع، ليس عليه نبات ولا شجر، على نحو جبل الشام؟”.

ردّ المقوقس بأن الله أغنى أهله بالنيل: “ولكنا نجد تحته ما هو خير.. يُدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم”. طلب المقوقس أن يبيعه عمرو سفح المقطم بسبعين ألف دينار. عجب عمرو، وأخبر عمر بن الخطاب الذي سأل عن عرض المقوقس الباذخ لشراء مكان لا يُزرع. أجاب المقوقس بأن في هذه البقعة “غِراس الجنة”. هكذا، منذ دخل العرب مصر، بدأ الاستئثار بالله، إذ كتب عمر إلى عمرو: “إنا لا نعلم غِراس الجنة إلا للمؤمنين، فاقْبر بها من مات من قِبَلك من المسلمين، ولا تبعه بشيء”. وكان أول من دفن فيها رجل يمنيّ اسمه عامر، فقيل “عمرت الجبّانة”.
وفي سفح المقطم دفن خمسة من الصحابة: عمرو بن العاص، وعبدالله بن الحارث الزبيدي، وعبدالله بن حذافة، وأبوبصرة الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني. كان عمرو أول أمير على مصر في الإسلام حتى قتل عمر بن الخطاب. وولي في عهديْ عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان. وينتهي كتاب “مرشد الزوار” بذكر ضريح محمد بن أبي بكر الصديق. أمه أسماء بنت عُميس التي تزوجها جعفر بن أبي طالب وأنجبت ثلاثة أولاد. وتزوجها أبوبكر فأنجبت محمدا. ثم تزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت يحيى. ونشأ محمد عند الإمام علي الذي ولاه مصر، فدخلها في رمضان سنة 37 هجرية.
معاوية بن أبي سفيان أرسل ابن العاص ومعاوية بن حُديْج في صفر سنة 28 هجرية إلى مصر لقتال محمد بن أبي بكر، فهزموه. جرّه الجنود على الأرض، وجاءوا به إلى ابن حديْج. قال له: “احفظني لأبي بكر”، فقتله وأمر بأن يجرّوه في الطريق، “وأمر به فأُحرق بالنار في جيفة حمار، ودفن في الموضع الذي قتل فيه. فلما كان بعد سنة جاء زمامٌ غلامه فحفر عليه، فلم يجد سوى رأسه”، فدفنه في مسجد زمام الذي أنشأه وحمل اسمه. وكانت ولاية محمد خمسة أشهر، وكانت أخته عائشة قد أرسلت أخاها عبدالرحمن إلى عمرو بن العاص “فاعتذر بأن الأمر لمعاوية بن حديْج”.
بعد مأساة القتل والحرق بدأت شماتة بني أمية بآل أبي بكر. وصل الخبر إلى المدينة، فأمرت أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوجة النبي، بشواء كبش، وأرسلته إلى عائشة زوجة النبي، وقالت: “هكذا شُوي أخوك بمصر”، فلم تأكل عائشة “الشّوِيّ حتى ماتت”. ولما بلغ أسماء بنت عميس خبر قتل ولدها وإحراقه “قامت إلى مسجدها وجلست فيه، وكظمت الغيظ حتى شخبت ثدياها دما”. الإمام عليّ جزع على محمد، بكاه وقال: “كان ربيبا لي، وكنت أعده ولدا… لا أحد بايعني على ما في نفسه إلا محمد بن أبي بكر، فإنه بايعني على ما في نفسي”. وبهذه المأساة ينتهي الكتاب المخصص لتوثيق مقابر الأبرار.
مدافن مصر

عودٌ إلى بداية الكتاب. بعد ذكر الصحابة الخمسة، استعرض أشراف آل البيت الذين جاؤوا إلى مصر، أو دفنوا فيها. وأجلّ الأشراف الحُسيْنيون والحَسَنيون، والجعافرة من نسل جعفر الطيار بن أبي طالب. أما الزينبيون فنسبوا إلى عبدالله الجواد بن جعفر الطيار، لزواجه بفاطمة بنت زينب أو زينب بنت فاطمة بنت الرسول، على إحدى الروايتين، فأنجبت محمد بن عبدالله بن جعفر الطيار، وله ذرية بالقرافة. وأما الأشراف الحنفية (المحمديون) فينسبون إلى محمد بن الحنفية، ابن الإمام علي. وتوجد أيضا مقابر خاصة بالعباسيين من نسل عبدالله بن العباس بن أبي طالب وأخيه الفضل. فمن أول من دخل مصر من آل البيت؟
إنها سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وكانت “سيدة نساء عصرها وأجملهن، وأحسنهن أخلاقا”. حُمِلت إلى الأصْبَغ بن عبدالعزيز بن مروان ليدخل بها، ففاجأتها وفاته، ورجعت إلى المدينة. وممن دخل مصر الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط بن الإمام علي، وابنته نفيسة. وهي “السيدة الرئيسة” الزاهدة، المجتهدة “صاحبة الكرامات المتنوعة، نجيبة دهرها، وفريدة عصرها”. وجاءت إلى مصر سنة 193 هجرية، مع زوجها إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين. ولما سمع أهل مصر بقدومها “وكان لها ذكر شائع عندهم”، انتظروها “بالهوادج من العريش” حتى دخلت مصر (القاهرة).

كثر الخلق على باب السيدة نفيسة، فقررت الرحيل إلى الحجاز “فشقّ ذلك على أهل مصر”، وناشدوا أمير مصر السّريّ بن الحكم، فأرسل إليها كتابا ورسولا، فأبت. جاءها يرجوها البقاء، وبقيت، وتزاحم الناس على بابها يسألونها الدعاء، فطلب زوجها أن ترحل إلى أهلها بالحجاز، فقالت إنها لا تستطيع، إذ رأت الرسول في المنام يقول لها: “لا ترحلي من مصر، فإن الله سبحانه وتعالى متوفيك بها”. وتعددت كراماتها. وكان الإمام الشافعي إذا مرض يرسل إليها أحد تلاميذه، لتدعو للشافعي؛ فيعافى. وفي مرض الموت قالت للقاصد: “متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم”. سمع الشافعي الرسالة “فعلم أنه ميت، فأوصى أن تصلي على جسده”.
بعد أربع سنين على موت الإمام الشافعي، توفيت السيدة نفيسة سنة 208 هجرية في حجر ابنة أخيها زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الإمام الحسن. وأوقد المصريون الشموع “وسُمع البكاء من كل دار بمصر”. وأعد لها زوجها إسحاق المؤتمن تابوتا، لنقلها إلى البقيع “فتعلق بها أهل مصر وسألوه بالله أن يدفنها عندهم، فأبى، فاجتمعوا وجاءوا إلى أمير البلد وتوسلوا به إليه ليدفنها عندهم وليرجع عما أراده”. رفض زوجها، فجمعوا له حمل بعير من المال، وتركوا المال عنده، وعادوا يتألمون. وفي الصباح أبلغهم أنه رأى الرسول في المنام يقول له: “رُدّ على الناس أموالهم وادفنها عندهم”.
ودفنت السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج “في البيت الذي كانت قاطنة به”. وفي مصر دفنت السيدة نفيسة (الكبرى) بنت زيد الأبلج بن الحسن السبط، عمة السيدة نفيسة (الصغرى) بنت الحسن الأنور. السيدة نفيسة الكبرى كانت زوجة الوليد بن عبدالملك بن مروان، قبل توليه الخلافة بالشام. وقيل إن السيدة نفيسة الصغرى حفرت قبرها بيدها، في بيتها بمنطقة درب السباع، وكان تتعبد فيه. وحرص الأولياء والعلماء والفقهاء على زيارة قبرها، وكان كافور الإخشيدي أمير مصر وصاحب المتنبي “لا يدع زيارة السيدة نفيسة، رضي الله عنها في كل خميس.. يترجل حين ينظر الباب الأول من بعيد، ويدخل حاسر الرأس”.
يوجد أيضا ضريح يحيى بن زيد الأبلج شقيق نفيسة الكبرى. وضريح القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين. وكذلك ضريح يحيى الشبيه بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، وسمي بذلك لأنه “كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أوصافه”. والضريح الأشهر، وملحق به مسجد، هو “مشهد آل طباطبا”. تم فكّه في فبراير 2021 لترميمه ونقله قريبا من المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط. والضريح لأبي الحسن علي بن الحسن بن إبراهيم “طباطبا” بن إسماعيل الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن.
ظواهر تحتاج البحث

“المشهد” في الدلالة المصرية يعني “الضريح”. يقول المؤلف إن ضريح طباطبا “مشهد عظيم مبارك شريف. بهذا المسجد طائفة من بني طباطبا”. لُقّب بذلك أبوإسحاق إبراهيم بن إسماعيل؛ لعجمة في لسانه. كان إبراهيم قد قدم بغداد، فاستدعاه الرشيد، وخشي أن يكون أحد وشى به. لكن الرشيد استقبله وأجلسه إلى جانبه، وأحس أن إبراهيم خائف، فسأله: “ما بك يا أبا إسحاق؟"، قال: “روّعني صاحب الطَّبَا”، يقصد الذي دعاه وكان يرتدي “القَباء”، وهو ثوب يلبس فوق الثياب. أراد إبراهيم القول “صاحب القبا”، فقلب القاف طاءً. وقيل إنه طلب ثيابا من الغلام، قائلا: “طباطبا”، يعني “قباقبا”. وإليه ينسب اللقب، وهو أول من حمله.
الحمولة الرمزية لمشهد طباطبا لأبي الحسن علي بن الحسن بن طباطبا، فضلا عن أثريته الجاذبة لكاميرا السينما، أنه يضم أولاده وكرماء ونقباء الطالبيين بمصر. ويوجد مشهد رأس زيد الشهيد بن علي زين العابدين، قتل في الكوفة سنة 122 هجرية، وحملوا رأسه، فنصب على باب دمشق، ثم إلى مصر "فنُصب بالجامع، فسرقه أهل مصر ودفنوه”. ويوجد مشهد رأس إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي. وقد استولى على البصرة، وسير الجموع إلى ما حولها، “فكانت بينه وبين المنصور وقائع هائلة"، وقتل سنة 145 هجرية، وأرسلوا رأسه إلى المنصور. وكذلك قبر الشريفة فاطمة بنت محمد بن الحسن المتوفاة سنة 383 هجرية.
لا تحظى ظاهرتان مصريتان بدراسات كافية: الأولى هي الرؤوس المدفونة، منها رأس خمارويه بن أحمد بن طولون، حاكم مصر والشام بين عامي 884 و896 ميلادي، “وقتل بالشام، وجيء برأسه. وقيل: بل جيء به ودُفن”. والثانية هي إقامة فقهاء مغاربة أدوا فريضة الحج. منهم “القفصي” المدفون بالقاهرة، وقد رفض الرجوع إلى المغرب، قائلا “والدي كان قاضيا فأخاف أن يقال لي: كن موضع أبيك”. والمقال، الذي طال، لا يتسع لذكر سير فقهاء وزاهدين دفنوا بمصر: الليث بن سعد، الإمام الشافعي، الإمام ورش المدني صاحب الرواية، ابن خلكان، الإمام الشاطبي، ذو النون المصري، القاضي الفاضل، القاضي ابن دقيق العيد، وغيرهم من “حرّاس المحروسة”.