هل تمثل السينما خطرا على فن الرواية

تبدو العلاقة بين السينما وفن الرواية وثيقة جدا، حيث استفاد أحدهما من خصوصيات الآخر، وقدّمت العديد من الأعمال السينمائية الكبيرة المستوحاة من الروايات، فيما نالت روايات أخرى مكتوبة بأساليب سينمائية نجاحا باهرا في مقروئيتها. لكن هذه العلاقة لم تعد هادئة ومنسجمة كما كانت في السنوات الأخيرة، بل تحولت إلى علاقة سلبية. “العرب” استطلعت آراء بعض الكتاب المصريين في علاقة الرواية بالسينما.
تختلف العلاقة بين الرواية والسينما، وبين الروائيين والسينما، الآن عن ذي قبل، اختلافا واضحا وجليا، أثر بشكل مباشر على الرواية وتطورها، وهذا الأمر يمكن رصده في أعمال روائية حققت رواجا كبيرا عند تحويلها إلى أعمال سينمائية، على الرغم من تواضعها كروايات، وروايات أقرب للسيناريو والحوار السينمائي منها إلى العمل الفني الروائي، بشكل عام يمكن للقارئ المتابع للمشهد الروائي أن يرى ملمح كتابة الكثير من الروائيين وعيونهم متجهة إلى السينما.
العرب فتحت تحقيقا حول هذه القضية بشأن كتابة الكثير من الروائيين المصريين أعمالهم وعيونهم على السينما. وتساءلت هل أضر ذلك بالرواية المصرية وحدّ من قدرتها على التجريب؟
العين على السينما

يقول الروائي محمد صالح البحر “في الوقت الذي استفادت فيه السينما من درامية الرواية لتتخلص من طبيعتها التسجيلية، استفادت الرواية من التقنيات المتعددة لطرائق الحكي في السينما، مثل الفلاش باك، وتجاور الأحداث، والبنية الدائرية، ساعدت على تعميق الفن الروائي، وتطويره من حيث الشكل وقدرته على تقديم موضوعاته بطرائق شيقة وأكثر جذبا، على أن يبقي بناء المشهد من أهم التقنيات التي استفادت فيها الرواية من السينما، حيث يشكل المشهد الوحدة الأولية للبناء في كل منهما، رغم شكله المحدد الصارم في السينما، واتساعه اللامحدود في الحكي، فاللغة أسرع من الصورة من حيث حرية الحركة والانتقال في الزمن والمكان، لكن الصورة أكثر قدرة على التجسيد والرؤية وبعث الروح من داخل الصمت”.
ويضيف “لم يلتفت أحد ـ وسط هذا الازدهار الفني ـ إلى ما يمكن أن يصل إليه أمر هذا التأثير، ولم ينتبه أحد إلى إمكانية خروجه من الحيز الفني لاستعارة التقنيات، إلى الحيز الخارجي الذي يُحدد طبيعة وجود كلٍ منهما في الواقع، لكنني أعتقد أن هذا هو ما حدث بالفعل، ولأن الصورة أسهل ـ فهما واستيعابا ـ من الكلمة بدت السينما أكثر قدرة في التأثير على المتلقي، وأكثر قدرة في الوصول إلى الفئات الاجتماعية الأقل إدراكا، والتي لا تسطيع الرواية الوصول إليها بأي حال من الأحوال، لاستحالة قدرتها على فهمها، لذلك استمر أمر التأثير المتبادل بين السينما والرواية لصالح السينما دائما، وراحت الرواية تلهث من خلفها، مستعيرة كل ما يميزها في سبيل الوصول إلى أكبر كم ممكن من الجماهير”.
ويشير إلى أنه في “مرور الوقت” بدا أمر تبعية الرواية للسينما طبيعيا، وفي “تعب اللهاث” كفَّتْ الرواية عن التفكير في طبيعة الأشياء التي تستعيرها من السينما، حتى أصابها داء الطابع التجاري الحديث للسينما، كأداة رأسمالية مهمتها الربح، وطبيعتها الاستهلاك السريع من قِبل المتلقي كضامن أساسي لاستمرار هذا الربح، فلم تنتبه إلى المنزلق الحاد الذي وقعت فيه السينما وهي تلهث خلف تلبية رغبات الجماهير، ثم تلبية غرائزه من بعد.

ويتابع البحر “مثلما ظهرت الرواية الجنسية في سبعينات القرن الماضي متواكبة مع انتشار أفلام الإباحية، ظهرت الآن رواية العنف والحركة والفانتازيا والخيال العلمي والتاريخ، مع تعدد أساليب السينما الحديثة في اقتناص الجماهير إليها، وبعدما قطعتْ الرواية شوطا هائلا من التطور الشكلي بفضل نظريات الحداثة وما بعدها، أصبحتْ تُصنف بحسب مضمونها فقط، وبعدما كان هذا المضمون الروائي يستمد عمقه من الفلسفة والتراث والأسطورة وعلم النفس والسياسة، ابتغاء العمق الفكري كمكون جمالي أصيل فيه، صار الشارع بعشوائيته وتناقضه وسطحيته المفرطة منبعا أصيلا له“.
ويشدد الروائي على أنه كثيرا ما رُفعت راية البُعد عن العمق من الأساس، إرضاء للجماهير التي تنتظر التسلية، وتزجية فراغها الذي لا ينتهي، وراحت اللغة الروائية أيضا تستميت في تقليد الصورة في وضوحها المخل، وسهولتها المباشرة، ومعناها القريب، وركاكتها المستمدة من قاع المجتمع، بحكاياته الضحلة، ونماذجه الرَّثة، أما على مستوى السوق فقد راح الناشر أيضا يلعب دور المنتج الذي لا يهمه غير الربح، ولا يرى سوى متطلبات السوق الذي يسير فيه من البضاعة التي يريدها، فصار يتحكم في نوع السلعة وصاحبها وشكلها، وشكلت المسابقات الأدبية ومعارض الكتاب ووسائل الإعلام بكل مفرداتها، سوقا صاخبا لترويج بضاعته.
لذلك يقر البحر أننا بتنا نجد الآن الكثير من الروائيين الذين يكتبون أعمالهم وعيونهم معلقة على السينما، ليس فقط لاستعارة تقنياتها الفنية العالية، بل من أجل كل الأشياء فيها، وأهمها المال والشهرة والوجود ولو على حساب كل الأشياء أيضا، وهو الأمر الذي نرى أنه أضر بالرواية، وحَدَّ من قدرتها على التجريب باتجاه التطور في الوقت الحالي.

وتقول الروائية مي التلمساني “أكتب وعيني على السينما بحكم النشأة في بيت يعمل أهله في المجال السينمائي هو بيت الإخوة كامل وحسن وعبدالقادر التلمساني، وكنت في زمن مضى أجهز نفسي للتخصص في مجال كتابة السيناريو. لكن سرعان ما تراجعت تلك الضرورة، ضرورة التعبير بالصورة لأني أنتمي لتاريخ عائلي ثري في هذا المجال، لصالح الشغف بالأدب والكتابة الأدبية خاصة في مجال القصة والرواية، وقد حدث هذا في بداية التسعينات حين شرعت في نشر كتابتي في المجلات المصرية والعربية واتضحت لي علامات الطريق المؤدية إلى عالم الرواية الثري”.
وتتساءل الكاتبة “هل تنازلت عن رافد من روافد الخيال وهو السينما لصالح الأدب الخالص؟ وما الأدب الخالص لو لم يصهر بداخله خبرات وتجارب فنية أخرى كالسينما والفن التشكيلي والموسيقى والمسرح”؟
وتجيب “أتصور أن تلاقح الفنون عملية لا غنى عنها وأن الفصل التعسفي بين أدوات التعبير بالفن قد عفا عليه الزمن، خاصة لو كانت تلك الفنون قريبة الصلة بفعل الكتابة وفنون الحكي. السينما بالنسبة إلي كمرجع بصري وكمنهج في الكتابة وغزل الحكايات مصدر لا غنى عنه للقصة والرواية التي أكتبها. قد تكون السينما موضوعا لنص أدبي كما حدث في مجموعتي ‘عين سحرية’ وقد تلهمني أسلوبا محددا في تركيب الفقرات وتوليفها كما يبدو في روايتي ‘اكابيللا’ التي تحولت إلى فيلم سينمائي”.

وتضيف “قد تكون السينما مرجعا كذلك بإشارات تثري النص وتفتحه على تاريخ آخر للفن كما حدث في كل ما نشرت حتى الآن من أعمال حيث تعيش الشخصيات في واقع مواز أحيانا ما تكون مرجعيته الأساسية هي الأفلام العربية والأجنبية اللافتة. إذن لا غنى عن السينما في كتابة الأدب اليوم. قد نرى أن محاولات بعض الكتاب جذب انتباه المخرجين لأعمالهم كي تتحول إلى أفلام أو دراما تلفزيونية محاولات بائسة، لكني أتذكر مقولة شهيرة للمخرج الكبير الفريد هيتشكوك يقول فيها ما معناه أن الأدب المتواضع ينتج أفلاما عظيمة ويشير إلى أن الأدب العظيم قد لا يصلح موضوعا للسينما. المعيار الرئيس والحال هذه أن يقف كل فن بذاته على مسافة من الفن المجاور له، يستقي منه منابع الإلهام كما هو حال الأدب لكنه يظل وفيا لقيمه ومعاييره الخاصة، الكلاسيكي منها والطليعي”.
وتضيف التلمساني “تظهر بعض الروايات الرائجة وكأنها سلسلة من الحكايات السينمائية والمشاهد والمواقف الدرامية التي حفظها المشاهدون وتكررت عبر تاريخ السينما والفيديو حد الغثيان، وتظهر بعض الأعمال الأدبية الأقل رواجا وكأنها تتكئ على معرفة أو رؤية للفن السينمائي تستثمر أعمال كبار المخرجين أو نجوم هذا الفن الشعبيين، وفي الحالتين هناك مشروعية لوجود تلك الأعمال الرائحة في سوق الكتاب. الأدب في رأيي يقع على مسافة كبيرة من تلك المحاولات البائسة طالما أنه يسعى للتجريب والتجويد في مجاله الخاص، مجال اللغة والحكي والأسلوب، حتى وإن كانت السينما واحدة من مراجعه”.
ترى الروائية زينب عفيفي أن السينما تطرح سؤال ماهية الكتابة الإبداعية؟ وسؤالا آخر لماذا نكتب؟ هل نكتب من أجل المال، أو الشهرة، أو السينما، أو الجوائز؟ وتقول “لا أحد يريد أن يكون كاتبا أو روائيا إلا لو كان لديه رغبة ملحة لا تهدأ في الكتابة، ولا يستطيع فعل شيء آخر غير الكتابة، وإذا كتب رواية أو قصة لا يفكر بأي هدف من الكسب التجاري، وإنما يكتب لأن الكتابة فعل حياة. هناك العشرات من الروائيين في العالم أجابوا على سؤال الكتابة، ربما ليكون الإنسان أفضل، أو أن الكتابة تخلصه من متاعبه، وربما تشفيه من أوجاعه”.
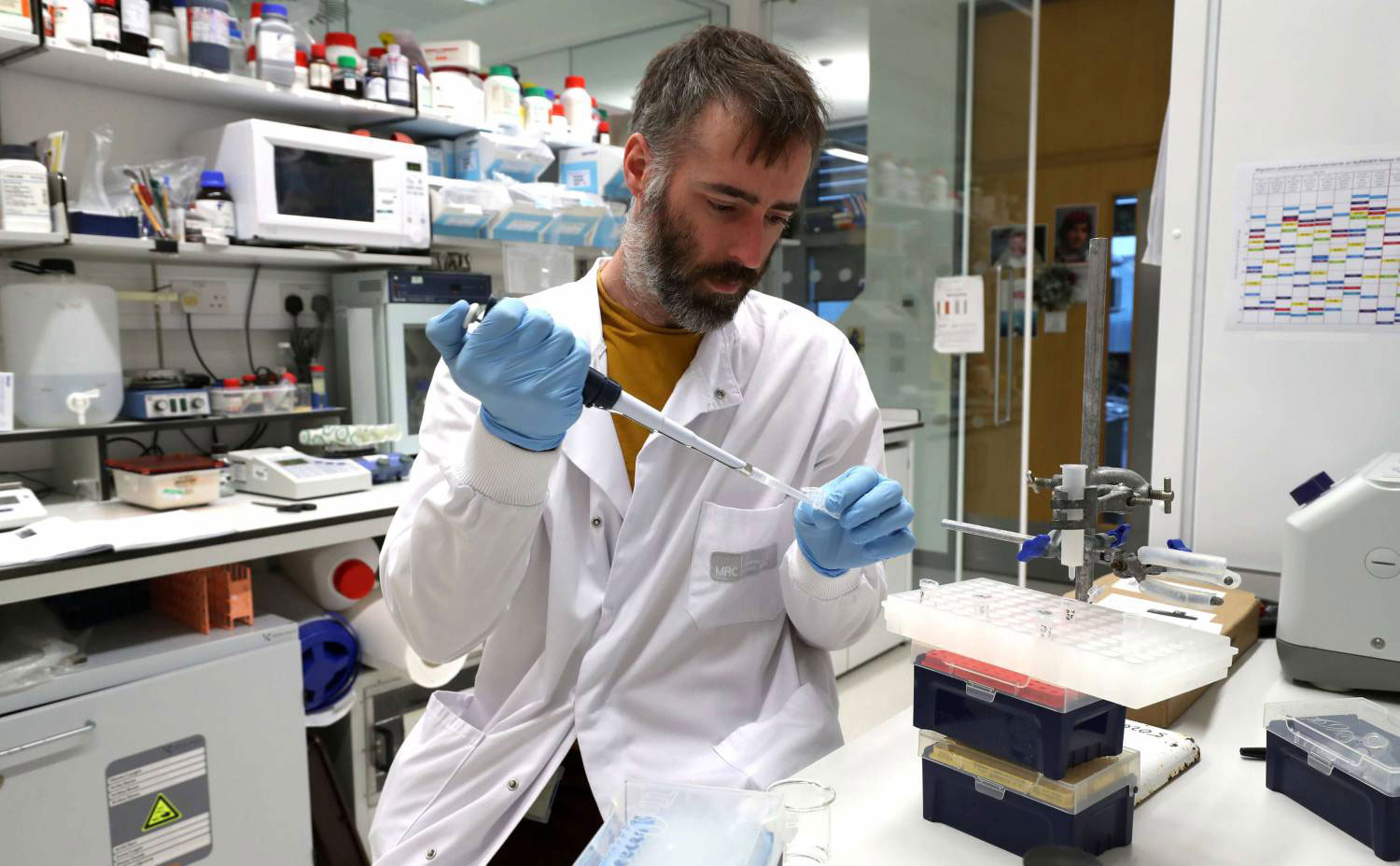
وتضيف “الكتابة حين تحمل غرضا في طياتها تفقد قيمتها بلا شك، لأن عين الروائي هنا تكون مشغولة بما ليس له قيمة إبداعية، وإذا نظرنا إلى أعمال نجيب محفوظ ، نرى أنه لم يكتبها من أجل السينما كروايات، وإنما السينما هي التي جاءت إليه، وبالطبع تختلف الروايات عن كتابة السيناريوهات المرصودة في الأصل للسينما، ونجد أيضا في الأعمال الأدبية التي تحولت للسينما أمثال أعمال يحيى حقي وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي ويوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس وطه حسين وعلي أحمد باكثير وغيرهم لم يكتبوا رواياتهم للسينما. وإنما السينما هي التي سعت إليهم”.
وتتابع عفيفي “الكتابة بهدف تجاري مسبق مثل السينما أو الحصول على جائزة مالية ضخمة أو الحصول على المال أو حتى الشهرة التي يحلم بها كل المبدعين، تفقد العمل قيمته الإبداعية وتحوله إلى سلعة تجارية وليست قيمة لتبقى طويلا”.
وهذا لا ينفي، في رأيها، علاقة الأدب بالسينما، فهناك عمل مشروع لتحويل الأعمال الأدبية إلى سينما، فالرواية لها مواصفات وكتابة السيناريو له تفاصيل، وكلاهما مختلف وأن اشتركا في نبع واحد هو الإبداع.
وفي اعتقادها أن الفصل بين منهجي الكتابة السينمائية المكتوب خصيصاً، أو المكتوبة اقتباساً، لا يعني أن أحدهما هو أفضل من الآخر. فالعلاقة بينهما تأثير وتأثر، وهذا لا يحق أن تكتب رواية من أجل تحويلها إلى فيلم سينمائي بهدف تجاري. أما فعل التجريب في الكتابة فهو حق مشروع في مكانه إذا كان رواية، أو قصة، أو قصيدة أو سيناريو فيلم، لكن الخلط بينها في المسميات والمضمون هو ما يفسد العمل الإبداعي في ذاته.
علاقة مثيرة للجدل
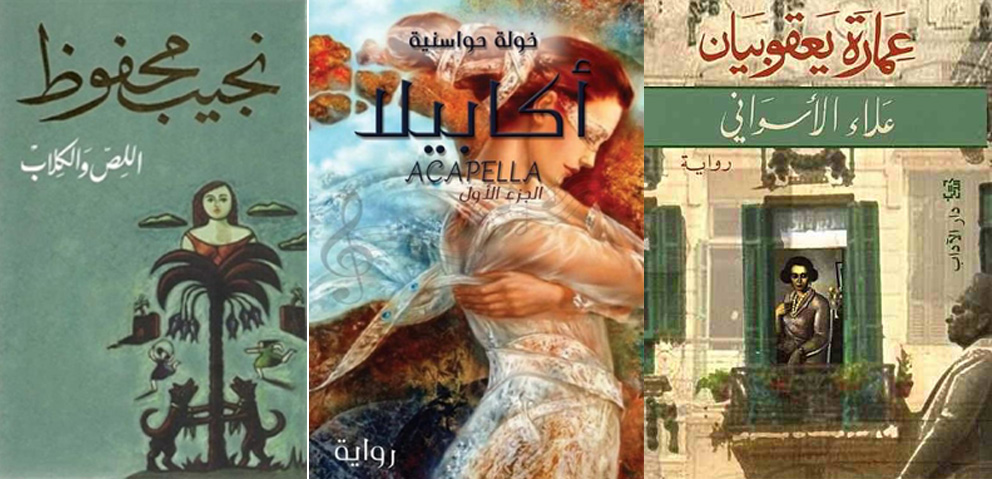
يؤكد الروائي صبحي موسى أن العلاقة بين الأدب والسينما علاقة طبيعية ومقبولة، وإن كانت علاقتها بالمسرح أكثر متانة وقوة، فالكاتب المسرحي مؤهل بحكم حرفيته لوصف المشهد وإدارة الحوار بأن يكتب السيناريو، لكن المسرحيات نفسها ليست مؤهلة بقدر الروايات لأن تتحول إلى عمل سينمائي، نظرا إلى تعدد الأماكن والشخوص والأزمنة، فضلا عن البعد الدرامي، وعادة ما تقوم السينما بتحقيق انتشار كبير للكاتب الذي يكتب لها أو يتم تحول أي من أعماله للعرض على شاشتها، ومن ثم فالجميع يحلم بأن يتم تحويل أي من أعماله للسينما، كي تنقله من فئة الألف نسخة إلى فئة الملايين التي تذهب إلى دور العرض أو تجلس أمام شاشات التلفزيون، ومن ثم أصبحت السينما أو الدراما التلفزيونية حلما.

يضيف “حتى الآن لا يمكن القول إن هذا الحلم ترك آثاره السيئة على كتابة الرواية، بل أحيانا ساعد في دخول تقنيات جديدة إلى الكتابة، وأحيانا موضوعات جديدة مثل الخيال العلمي وغيره، وربما كان تأثير البيست سيلر أكبر وأكثر انتشارا وتسطيحا للكتابة الروائية، بل وتدميرا لعقول الشباب الذين يتصورون أن هذا النوع من الكتابة هو الرواية الحقيقية، وربما كان ضرر الجوائز والترجمة أكبر أثرا من السينما، فقد صارت الجوائز تنمط خيال القراء وفقا لنموذج الفائز، وكأنه موضة العام، أما الترجمة فإنها تحدد موضوعات وأنماطا محددة من الكتابة كي يلتفت إليها المترجم أو تقبل بها دار النشر الغربية.
ويتابع “هذا الثالوث ‘المبيعات والجوائز والترجمة’ هي الثالوث الأخطر على كتابة الرواية، أما الخوف من السينما فيأتي من خلال استقطابها هي والدرامة التلفزيونية للعديد من الروائيين أو الكتاب بشكل عام ليكونوا من كتاب السيناريو أو السينما التسجيلية أو البرامج الإذاعية وغيرها، لأنها تستنزف قدراتهم وتخطفهم إلى عوالم أخرى، ولا ينافسها في هذا إلا عمل الكاتب كمترجم، فدائما ما تأخذ الترجمة جل طاقة الكاتب، ودائما يصبحون مترجمين كبار وكتاب عاديين وربما أقل من العاديين”.
ويؤكد الروائي والكاتب أشرف الصباغ أن الإصرار على كتابة روايات من أجل السينما يجعل “الرواية” خادمة لسيد لديه بدائل أخرى غيرها. بمعنى أنها لن تكون الأولى أو الأثيرة لدى هذا السيد “النزق” الذي يمتلك العديد من الأدوات والإمكانيات الخاصة به وبتطويره هو لنفسه. هكذا يحط الروائي والأديب من شأن جنس أدبي بسبب الغزل غير المقدس، ومن أجل الشهرة.
ويعتقد أن تجربة علاء الأسواني في “عمارة يعقوبيان” مثيرة لخيال وطموحات العديد من الكتاب لكي يسيروا على نفس الطريق ويقابلوا الحظ والشهرة والمجد. للأسف الشديد، إن حشر الرواية في هذه الزاوية الضيقة ينعكس سلبا، سواء على الرواية أو على السينما، لأننا ببساطة في مأزق إبداعي تاريخي على مستوى هذين الجنسين الفنيين، مهما أقمنا من مهرجانات ومهما منحنا من جوائز ودبجنا المقالات والأخبار للاحتفاء بأعمال هزيلة ومتواضعة تتناسب بشكل مذهل مع وضعنا السيء وتركيبتنا الثقافية والشللية.
حضور السرد المكتوب بعين تنظر إلى السينما أضعف كلا من الأدب والسينما وأنعش حالة التردي والخداع
ويشير إلى أن السينما مرتبطة بالسرد بطريقة أو بأخرى. والسرد سابق على السينما شئنا أم أبينا. فكيف حدث وافترقت السينما عن السرد بشكله الكلاسيكي وابتكرت سردا نوعيا (السيناريو) وتطورت وسبقت السرد؟ كيف حدث هذا في وجود روايات جيدة نسبيا، سواء كانت محلية أو عالمية؟ يبدو أننا أمام مأزق المعالجة السيمائية للأعمال السردية. الأمر الذي يحتم علينا تناول علاقة السرد والسينما كخطوة أولى للدخول إلى أزمة كتابة الأدب من أجل السينما، أو بالأحرى من أجل الشهرة والحصول على الحظوة والجوائز والأموال، بصرف النظر عن مغامرة الكتابة، ومغامرة التجريب، ومغامرات الفشل والنجاح الأدبيين..
ويعتقد الصباغ أن علاقة الإبداع الروائي والقصصي بالسينما ستظل تصنف في إطار العلاقات المعقدة بين الأشكال الفنية. وهي علاقة مركبة وجدلية من حيث قراءة العمل الفني ضمن شكله المطروح. بمعنى القراءة النقدية الأدبية للعمل المكتوب والقراءة النقدية الفنية للعمل المعروض على شاشة السينما بعد مروره بكل المراحل التقنية والإبداعية. قراءات مختلفة للنوع أو الشكل الفني كل حسب القواعد والقوانين والمدارس النقدية الخاصة به.

يقول “إن السرد يمثل بلا أي شك أحد المصادر الخصبة للسينما، ولكنه ليس الوحيد وليس الأساس أو الأصل، لأن القضية هنا معقدة وترتكز إلى عدة نقاط جوهرية، من ضمنها إعادة تشكيل النوع الأدبي (قصة أو رواية) وفقا لمتطلبات السينما (السيناريو). ومجرد نقل السرد من إطار إلى إطار آخر، فهذا يعني، شئنا أم أبينا، قراءة، حتى قبل الدخول إلى أي من المراحل الفنية المقبلة لصنع العمل الفني. وبالتالي يمكن ألا نحزن كثيرا أو نجلد أنفسنا بسبب غياب العلاقة ‘الحقيقية البنَّاءة والمنتجة’ بين السرد والسينما، لأننا لا نرى إلا علاقات هشة”.
ويتابع “هناك أعمال أدبية كتبها مؤلفوها وعينهم على السينما وليس على الطريق العام للخيال الروائي والتحليق السردي والصور الإبداعية الروائية. إن مثل هذه الأعمال لا يعول عليها أبدا، حتى وإن كان يتم الترويج لها لاعتبارات لا علاقة لها بالإبداع سواء في السينما أو في الأدب. إننا في مأزق وفي أزمة، وفي حاجة إلى فك طلاسم الوضع المحيط بنا”.
ويتصور الصباغ أن حضور السرد المكتوب بعين تنظر إلى السينما هو الوجه الآخر لغياب الإبداع السردي “الحقيقي والبنَّاء والمنتج” عن السينما، الأمر الذي أثر بدرجات متفاوتة في المشهد السينمائي المصري. ولكن الفائدة الكبرى التي منحها غياب الإبداع السردي هي ظهور نمط آخر من الرؤى تجسد في أعمال يوسف شاهين ومجموعة الواقعية الجديدة.
وفي اعتقاده لا يمكن أن نتجاهل أنه من بداية النصف الثاني من السبعينات حتى بداية التسعينات كان هناك مخرجون يتناولون أعمالا سردية لكتاب كثيرين على رأسهم نجيب محفوظ. ولكنها كانت ضعيفة وسياحية ومهلهلة بالمعنى الفني. بل ويمكن أن نصفها بالسيئة والرديئة التي شوهت الأعمال السردية ولم تقدم لها ولا للمشاهد أي فائدة تذكر. أما حضور السرد المكتوب بعين تنظر إلى السينما فقد عمل على إضعاف كل من الأدب والسينما، وأنعش حالة التردي والخداع وانتشار الأوهام التي تؤكد للجميع بأنه وكأننا لدينا أدب وسينما.
فن السرد الفيلمي

يقول الروائي والناقد نذير جعفر إن الرواية فن كلامي سردي تخييلي منفتح على التجديد والتجريب المستمرين، قوامه اللغة وحدها وما تحيل عليه من حكايات وموضوعات وأفكار ومعان ودلالات يتوقف مستوى تلقيها وتأويلها على ثقافة القارئ. أمّا السينما فهي فن السرد الفيلمي بالصورة في المقام الأول وما يتطلبه سياق تتاليها وحبكتها من سيناريو وحوار تستند إليهما سواء كانا مستمدين من عمل روائي أم كتبا خصيصا للسينما.
وتأسيسا على ذلك فالرواية، في رأيه، فن فردي قائم على التخييل منفتح على التأويل يعود إلى مؤلفه وحده، أما السينما فهي فن جماعي قائم على الصورة ومحكوم بشرطها وانغلاقها على ما تحيل عليه، ويعود إلى فريق عمل من السيناريست إلى المصور والممثل والمخرج…إلخ.
ويضيف “لذلك فأن يكتب الروائي روايته وعينه مسبقا على إنتاجها للسينما فذلك يعني تقييده بشروط الفيلم السينمائي وأدوات تعبيره المختلفة عن العمل الروائي، وأي تقييد مسبق يحدّ من الجرأة على التجريب ويحدُّ من جنوح المخيلة وحرية التعبير وأدواته والمجالات التي يمكن الخوض فيها سواء كانت فلسفية أم نفسية أم سياسية أم اجتماعية. والصحيح أن يضع السيناريست عينه على عدد من الروايات حين يشرع بكتابة أي سيناريو ويختار منها ما يمكن تحويله إلى السينما، وبذلك لا يخسر الروائي نفسه على حساب السينمائي، ويبقى لديه أفق التخييل والتجريب مفتوحا على مداه”.

ويلفت جعفر إلى أنه في السينما العالمية ثمة تجارب كثيرة اتكأت على روايات لم تكتب في الأصل للسينما ومع ذلك تحولت إلى أفلام عظيمة شاهدها الملايين وحصدت جوائز عدة في مهرجانات السينما. ويكفي أن نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما قدمته السينما المصرية من أعمال روائية لنجيب محفوظ، والسينما السورية وما قدمته من روايات حنا مينه، والسينما الروسية وما قدمته من أعمال دوستويفسكي وتولستوي وغوركي.
ويؤكد الروائي نشأت المصري أن السينما أثرت بالسلب على تطور الرواية جزئيا في المرحلة الأخيرة، حيث ضاقت فرص النشر والتوزيع أمام الرواية بتأثير الميديا، إذ صارت السينما والتلفاز البديل الأفضل للرواية بعد تحويلها إلى فيلم أو مسلسل، وكذلك لتحقيق الكسب المادي إلى جانب الانتشار، بينما كانت الرواية في زمن نجيب محفوظ هي صاحبة اليد العليا لاختلاف المناخ الثقافي والسياسي أيضا.
ويرى أن الأكثر إضرارا بالرواية، وعصفا بالتجريب يتمثل في تلبية الهوى السياسي وسلطان الجوائز. والوجه الآخر للمشكلة هو الفقر الثقافي والتعليمي لدى شريحة كبيرة من الجمهور فضلا عن القهر الإعلامي. ومن آثار ذلك تشجيع الأفكار النمطية والهابطة، وبالتالي اتجاه الإنتاج إلى تلك الأعمال البعيدة عن التجريب وتراجع الابتكار الأدبي والفني. والمأمول النهوض من هذه الوهاد والكبوات بسياسة تعليمية طامحة، مع اهتمام الإعلام بالثقافة وإطلاق حرية الرأي.
ويقول الشاعر والروائي ياسر شعبان “منذ نشأة السينما وهناك علاقة وطيدة بين الصورة السينمائية والنصوص المكتوبة بأشكالها المختلفة؛ علاقة ذات أبعاد مختلفة من بينها ما هو تجاري وما هو جمالي وفني”.
ويضيف “تجاريا أسهم تحويل بعض الروايات لأعمال سينمائية في شهرة غير مسبوقة لفن الرواية والمشتغلين بالرواية بين قطاعات كانت مقطوعة الصلة عن هذا المجال من الإبداع، وترددت أسماء المشتغلين بالرواية تدريجيا بداية من مقدمة الفيلم، ثم المقال المكتوب عن الفيلم ثم الاشتباك النقدي بين المشتغلين بالرواية ونقدها، وبين المشتغلين بالسينما ونقدها حول مساحة الحرية الإبداعية عند تحويل نص مكتوب إلى فيلم، وتأثير الوسيط وأدواته ليس فقط على شكل المنتج ولكن على جوهره ومحتواه. وبدأت تتبلور لدى كلا الجانبين الرؤى المتعلقة بالاستفادة المتبادلة بينهما، وظهرت مصطلحات مثل السرد السينمائي وتيار الوعي.. الخ. هذه هي العلاقة بين الفنون“.




























