حركة الجسد المسرحي تكشف الهوية الثقافية

يعتبر الفعل المسرحي خطابا شاملا يجمع أشكالا خطابية متنوعة، حيث يستعمل في ذلك الجسد والحركة والسكون والصورة والصوت والصمت والضوء وغيرها، لذا فإن الخطاب المسرحي عجين متكامل من عناصر متنوعة تمثل نقطة قوة للفعل المسرحي ليكون الأكثر تأثيرا في المتلقي الذي يخاطبه بأكثر من طريقة وشكل ومعنى.
تطبيقا على الأعمال المسرحية للمخرج والمؤلف المسرحي غنام غنام يحلل كتاب “الخطاب المؤسساتي في مسرح غنام غنام دراسة ونصوص” للناقدة المسرحية أسماء بسام، الكيفية التي يقوم بها الخطاب بتقنين وإنتاج ومقاومة اعتداءات السلطة المؤسساتية وهيمنتها ولا مساواتها.
وتعتمد الناقدة على منهج التحليل النقدي للخطاب ونظرية الاتصال، للإجابة على نمط معين من الأسئلة المتعلقة بالسلطة المؤسساتية، مستعملة في ذلك الخطاب الذي وضعه فوكو والذي يتبلور حول السلطة المؤسساتية وهيمنتها على الذات وهدم الآخر وكل مقدرات الذات.
خطاب مؤسساتي
جاء اختيار الباحثة لمسرحيات غنام غنام كونها لاحظت أن خطابه المعرفي من أفصح الأمثلة التي تطبق هذا المنهج، حيثُ أوضحت أنه مع كثرة تداخل المصطلحات الأدبية، والتخبط في مفاهيم النقد الأدبي المختلفة وربطها بالمفاهيم الفلسفية، أدركنا أننا في حالة اغتراب للذات واهتزاز للهوية، ومن ثمَّ أصبحنا نبحث عن لغة لإثبات تلك الهوية عن طريق إثبات “اللكنة – العرف – الدين – العرق – السياسة”، وتطور الأمر إلى أن أصبح بحثا عن مواضع هذه الهوية وإبرازها في الجسد البشري بوصفه منتجا للمعنى الذي بدوره يستبدل أماكن الضعف بالمقاومة مع الذات ضد الآخر عن طريق الجسد الثقافي أو بمعنى أدق جسد العمل الدرامي.
كما أوضحت بسام أن المسرح من أنسب الأنواع الأدبية لنقد ثقافة المجتمع، من حيث إنه وليد نسق ثقافي ذي طبيعة اتصالية بالمؤسسات المختلفة، وقالت “يعتبر المسرح في حد ذاته خطابا معرفيا يجسد الخطاب المؤسساتي المنطوق وغير المنطوق من فعل وردّ فعل، وينخرط الخطاب المؤسساتي بالحقل السياسي بشكل مباشر، عن طريق نقش الأحداث وطبعها كليّا بالتاريخ”.
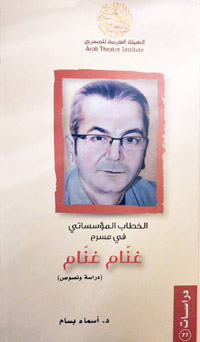
وقد وقع اختيار الناقدة على عدد من النصوص المسرحية المخطوطة والتي تم عرضها مثل “ليلك ضحى” و”الموت في زمن داعش”، و”البحث عن نوفان”، و”السياب يعيش مرتين”، و”صباح ومساء.. عن خمس دمى وامرأة” وغيرها.
وتحدثت بسام عن المقصود بالخطاب المؤسساتي موضحة العلاقة بين الخطاب والمؤسساتية، وأن إجراءات الاستبعاد والمنع هي إجراءات تحد من سلطة الخطاب ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل؛ حيث أن الفرد لا يستطيع البوح بكل شيء، من هنا تصبح السلطة والخطاب منتجين للمعرفة التي تعتبر قوة مهيمنة على السلطة المؤسساتية، والنسق الفكري في حد ذاته هو نسق يحمل العديد من الأفكار والمعتقدات والأيديولوجيات المختلفة التي بدورها تعبر عن ذات المؤلف وتعتبر تشريحا قويا للعقل والذهن بل والجسد.
واهتمت الناقدة بدراسة الكيفية التي يقوم بها الخطاب بتقنين وإنتاج ومقاومة اعتداءات السلطة الاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية وهيمنتها ولا مساواتها، معتمدة بذلك على منهج التحليل النقدي للخطاب ونظرية الاتصال؛ للإجابة على نمط معين من الأسئلة المتعلقة بالسلطة. واعتمدت في ذلك على الخطاب الذي وضعه فوكو، والذي يتبلور حول السلطة المؤسساتية وهيمنتها على الذات، وهدم الآخر كل مقدرات الذات؛ فحيثُ تكون السلطة تتكوّن المعرفة، وتُنتج اللغة، والعلامات والأفكار مرورا بالجسد المعرفي الذي ينقش على الورق كما كان يُطبع على الجسد أشكال التعذيب المختلفة التي تتلاحم مع التاريخ لتجسد هذه المعرفة.
وأوضحت بسام بما أن هناك مبدعا/ مرسلا، لديه رسالة يريد إيصالها إلى المتلقي عبر وسيط هي اللغة بكل أشكال الخطابات التي تعبر عنها فلا يمكننا أن نغفل في دراستنا نظرية الاتصال، ودورها في تلقي المعرفة وتحديد نوعية الخطاب المضاد للسلطة، وتحليل هذا الخطاب الذي يشكل حقلا معرفيا تشترك فيه اللغة والسيميوطيقا، وعلوم السياسة، والعلوم المعرفية، من هنا يمكننا الاعتراف بأن الخطاب اللامنطوق يشارك الخطاب المنطوق، والأداء الحركي المعرفي يلعب دورا بارزا في تحديد خصوصية إنجاز القول المعرفي.
الثورة والتمرد
قسمت بسام كتابها، الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، إلى قسمين القسم الأول الخطاب المؤسساتي في مسرح غنام غنام في ضوء نظرية التواصل وتحليل الخطاب الذي انقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: استراتيجية خطاب العنوان، الخطاب غير المنطوق “إرشادات”، أيديولوجيا الفكرة والفكرة المضادة. والقسم الثاني مسرحيات الكاتب غنام غنام المخطوطة، عينة الدراسة وهي “ليلك ضحى”، “الموت في زمن داعش”، “المنافي”، “البحث عن نوفان”، “السياب يعيش مرتين” وغيرها.
وقد رأت بسام أن المسرحي غنام غنام اهتم بالخطاب المؤسساتي الذي أنتج كلماته وأفعاله من نموذج السجن والمستشفى، والمنزل القيد والمصحة النفسية والمدرسة، ومؤسسة الإعلام، والقبر، والمنفى، كما اهتم بخطاب المراقب والمعاقب في داخل هذه المؤسسات، وخطاب المحتل، متأثرا بذلك بخطاب فوكو المؤسساتي.
وأكدت على استخدام غنام لنظرية الاتصال قصد إيصال خطابه المعرفي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المتلقي بهدف إقناعه بضرورة القيام بثورة احتجاجية ضد الأوضاع القائمة من احتلال واختلال وذلك عن طريق تغريب الحدث المسرحي بوسائل تغريبية، فتارة يستخدم الخطاب الثوري وتارة أخرى يصدر الحلم الذي ينبغي أن يكون، وتارة ثالثة يصدر خطاب التهجير والنفي ليعبُر بالمتلقي عبر سلسلة تواصلية بينه وبين أحداث الطرد والتهجير للفلسطينيين.
المسرح في حد ذاته يعتبر خطابا معرفيا يجسد الخطاب المؤسساتي المنطوق وغير المنطوق من فعل وردّ فعل
قالت أسماء بسام “استخدم غنام استراتيجية تواصلية لخطاب العنوان جعلت خطابه المعرفي يؤثر على المتلقي، باعتبار العنوان أول اتصال نوعي سيميائي يشير إلى أنظمة دلالية تحمل أيديولوجيا ثقافية ومعرفية”.
وكشفت بسام أن الخطاب المؤسساتي انقسم عند غنام إلى نوعين: الأول خطاب مكتوب غير منطوق “إرشاداتي” يجعل المتلقي من خلاله يستنتج مجموعة من المدلولات التي تعبر عن ثقافة وأيديولوجيا الجسد، وكأن الجسد أيقونة أيديولوجية ديناميكية تعبر عن التشريح المعرفي والثقافي لخطاب المقاومة وإثبات الهوية ضد المؤسسات المختلفة. أما الخطاب الثاني فهو خطاب منطوق يعبر عن أيديولوجيا الفكرة والفكرة المضادة باعتبار أن الفكرة التي تحاول الذات إيصالها إلى المتلقي تعبر عن الخطاب الثوري الاحتجاجي عن طريق التغريب يقابله خطاب مؤسساتي يتخذه الآخر لقهر خطاب المقاومة عند الذات، وإبعادها قسرا عن منتوج عملها.
وتابعت أسماء بسام أن غنام اتخذ من الوقائع الاحتلالية أداة يجب إيصالها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المتلقي عن طريق الأفعال والتغريب للحث على التمرد، والتفكير المستمر، وإقناع المتلقي بضرورة تغيير الوضع القائم. وختمت أن غنام استخدم أيضا مفردات وأفعال تشير إلى الخطاب المؤسساتي والمراقبة والمعاقبة وحفريات المعرفة ملتزما بذلك بفلسفة فوكو المؤسساتية التي ظهرت في مؤلفاته مثل “المراقبة والمعاقبة – ولادة السجن”، وغيرها.




























