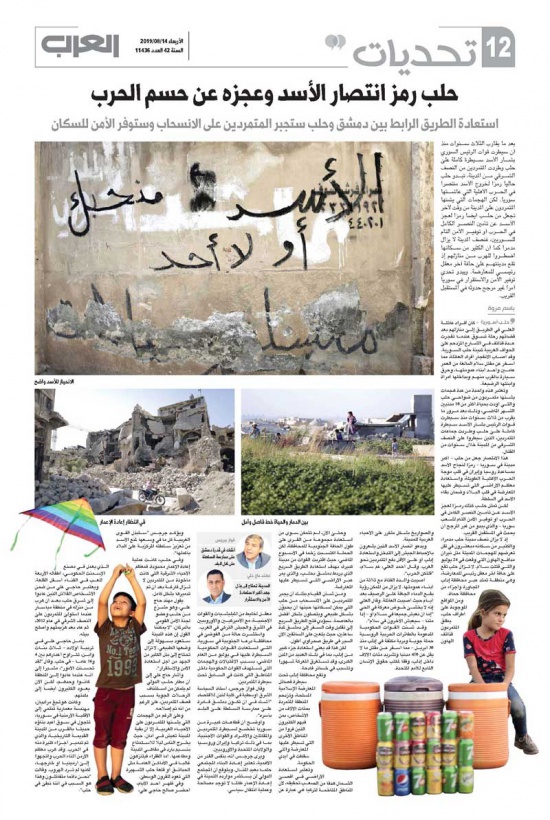حين يستكمل الموت تجاورات حياتية

تجاورت لحظتا وفاة الفنان الفلسطيني كمال بلاطة والروائية الأفرو- أميركية طوني موريسون، في يومين متتاليين، من الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، رحلا معا، بعد ما عاشا جوارا فكريا وإبداعيا ونضاليا. كانا معا تجسيدا لامعا لاختصار أفراد لقضايا وهويات ومصائر شعوب وأعراق وثقافات.
لا تعني المجاورة هنا إلاّ المجاز الذي تنوب فيه الأمثولة الفردية عن الحكاية الجماعية، والانتقال من المكابدة الحسية إلى التخييل، بالألوان والضياء، والمفردات والرموز… في الرياضيات يعرّف الجوار بوصفه “المجموعة التي تحتوي النقطة”؛ بحيث أنها تكون محاطَة ومحتضَنة، ذاك بالضبط كان وضع كمال بلاطة مع مدن وذاكرة انتزعت، وهوية فلسطينية أريد لها أن تمّحي. مثلما كان حال طوني موريسون مع عذابات السود ولوعاتهم وتوقهم في محيط أميركي عات.
تبدو المجاورة، في هذا السياق، مولدة للنّديد الإنساني المتناسخ أبدا، عبر أصقاع متباعدة، لكنها مجاورة مؤبدة أيضا بين المرئي والمكتوب، بين روايات “العين الأكثر زرقة” و”المحبوبة” و”صولا” و”نشيد سليمان” لطوني موريسون، وكاتالوغات “سرة الأرض” و”بلقيس” والعشرات من الأعمال الأخرى التي احتضنت اشتغال كمال بلاطة الفني.
إنها القرابة المجردة التي حدت ذات يوم بالشاعر الفرنسي روني شار لكتابة ديوان “في جوار فان غوخ”، مخترقا عين الرسام، محوّلا حدوسه العصية على القول، المشعة عبر شموس وحقول وطبقات أصباغ، إلى مفردات وسطور، حوار تخييلي ينبـَهقُ من عمق الجوار، الممتنع في الزمن، والفضاء. لم يكن فان غوخ إلاّ كائنا ضوئيا عصيا على الخصومة التي يشعلها قدر وجود الكائن “إلى جنب” آخرين.

قبل سنوات وأنا أودّع الروائي المرحوم إدمون عمران المليح في باب شقته، منتشيا بالعمق الطفولي المبهج الذي لم يبرح كلامه وحركاته، وهو في العقد العاشر، بادر سيدة صاعدة بتؤدة سلم العمارة، بتحية تخللتها دعابات ناعمة، قال لي “طبعا تعرف الحاجة فاطمة المرنسي، هي جارتي بالعمارة”، لم أقل شيئا، سارعت إلى معانقتها بحرارة، فقد سبق لي لقاؤها في مناسبات عدة، قبل أن يردف قائلا “شقتها فوق شقتي طبعا.. تراتب المقامات يقتضي ذلك”، لم تمح الدعابة دلالة ذلك العمق الذي منحه الروائي لوجوده البيتي مجاورا المفكرة المغربية الشهيرة، كان قدرا ظاهره حسي وباطنه أحاسيس ورؤى وانحيازات عصية على الابتذال اليومي.
وفي الفصل الخامس من رواية “طائر الحوم” لحليم بركات يتحدث السارد عن جوار في الطائرة مع سيدة عجوز إسرائيلية، تكره الجالس بجانبها لأنه عربي، كان التخاطب بينهما أشبه ما يكون بمأزق، بدا الحوار مقدمة لوضع السماعتين على الآذان والإنصات للداخل، ونفي الجوار القدري، على آلة تغافل الموت.
في هذا المشهد، يرد المقطع الآتي “نزعتُ السماعة وسألت جارتي: هل تحبين فاغنر؟، -أكرهه. – لماذا؟ -لأنه نازي. –تعرفين متى عاش؟ -لا يهمني. –يجب أن يهمك. توفي عام 1883، ست سنوات قبل أن يولد هتلر”، أستحضر هذا الحوار دوما حين تعترضني عبارة “الجوار العربي” في الأدبيات الغربية عن الكيان المحتل، حيث تستنبت المجاورة القهرية بمصادرة ذهنية بلهاء.
ويوضع كمال بلاطة وجبرا إبراهيم جبرا وإدوارد سعيد ومريد البرغوثي وناجي العلي، بجوار يافا وعكا والجليل والناصرة والقدس، لا في قلبها. ولعل من مفارقات اللغة أن لفظ جوار لا يختلف عن لفظ حوار إلاّ بنقطة، شبيهة بتلك التي تحوم حولها المجموعة في تعريف الرياضيات، فهي القطب المولّد لركام من الالتباسات..
قبل سنوات أصدر الكاتب المغربي عبدالقادر الشاوي كتابا نقديا أسماه “جوارات” ضمنه مقالاته عن مجموعة من الوقائع والشخصيات: ميغيل دي سرفاتس وغيبرائيل غارسيا ماركيز وفريديريكو غارسيا لوركا وإدريس الشرايبي وإبراهيم الخطيب وهند التعارجي ورفائيل ألبيرتي وفيرناندو بيسوا.. وكثيرين غيرهم من الكتاب الأثيرين لديه، أو ممّن جمعته بهم جوارات فكرية موحية، حيث كان يتحدث بنفس حواري “متذاوت” عن تلك الشخصيات ومواقفها وسيرها في الحياة وفي الكتابة، غير أن ما أثارني هو إحساسي بأن الكاتب يبدو في أحسن أحوال تدفقه، حين يكون بصدد الحديث عن شخص لا يعرفه، ولم يلتق به يوما، كفيرناندو بيسوا ورافائيل ألبيرتي وغيبرائيل غارسيا ماركيز..
إذ تنتصب النصوص كتعلة للتأويل والتخييل واستدعاء الأبعاد والظلال، وتتحوّل بالتدريج إلى مرافئ تفيء إليها الذاكرة بين الحين والحين، متحفزة دوما لمعاودة الإبحار في الفضاء اللامحدود لحدوسها ومجازاتها.
والحق أني أوردت هذا المثال لكتاب “جوارات” لتعيين القصد الذي رميت إلى تمثيله في هذه التأملات حول “الجوار الفكري”، فقد كنت متأكدا أن كمال بلاطة كان بعيدا عن مدار طوني موريسون الشخصي، ويعرفها عبر أقنعتها وضمائرها وبدائلها السردية، وأنه كان على صلة وطيدة بذاتها ككيان ذهني، قبل أن يختلق الموت ذريعة لجوار زمني لا تعقبه خصومة يوما.