ألبير كامو وأبوالقاسم الشابي يتكلمان باللهجة التونسية

مازالت قضية الكتابة باللهجة العاميّة/ الدارجة تثير الجدل في الأوساط الثقافيّة، وخصوصا أنها تهدد “أوهام العروبة”، وتطرح تساؤلات عن الهوية الثقافيّة والأدبيّة للكاتب وللنص، كما أنها تحمل أبعادا سياسيّة تتعلق بالهيمنة وخلق تجانس بين المكونات العربيّة أو بين الناطقين باللغة العربيّة مهما كانت جنسياتهم. “العرب” التقت الكاتب التونسي الشاب ضياء بوسالمي، الذي صدر له ديوان شعر بعنوان “أقف وحيدا أمام الجدار“، والذي نقل مذكرات أبوالقاسم الشابي إلى الدارجة التونسيّة.
قام الكاتب التونسي ضياء بوسالمي بمشروع أدبي جريء تمثل بداية بترجمة مذكرات الشاعر أبوالقاسم الشابي إلى الدارجة التونسيّة في كتاب حمل عنوان “أقف وحيدا أمام الجدار”، وقريبا تصدر له ترجمة بالدارجة لرواية “الغريب” لألبير كامو، والتي حاز إثرها على جائزة رامبورغ للفن والثقافة عام 2018، حاولنا في هذا اللقاء أن نفهم موقفه من الدارجة، وعلاقتها بالإنتاج الأدبي والموقف السياسي، إلى جانب سبب اهتمام الجيل الشاب بها، وخصوصاً أن البعض يرى في استخدام الدارجة تهديدا جوهريا للغة العربيّة وتاريخها الديني والثقافي.
التونسيون وكامو
السؤال الأول الذي لا بد من طرحه على بوسالمي هو لمَ الدارجة التونسيّة؟ وكيف سيكون رأي كامو من هذه الترجمة لو كان حيا؟ وهنا يعقب بوسالمي بأنه لا يعلم إن كان كامو سيوافق على ما قام به، أو كان هو نفسه سيكتب بالعامية إن كان مجيدا لها، فرأي كامو غير مهم بالنسبة إليه، كونه بصدد التعامل مع عمل أدبي، فرواية “الغريب” التي قرأها بوسالمي عشرات المرات، لا يمكن له إلا تخيّلها بالعاميّة، وخصوصا أن الجملة الأولى الشهيرة “اليوم توفيّت والدتي..” لم يكن لها وقع عليه، كما كان للدارجة التونسيّة إن قيلت بها.
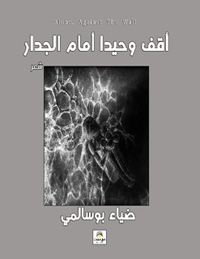
ويضيف “تأتي مسألة اختيار العاميّة، لأنني تونسي، أحلم بالتونسي وأتعامل في اليومي بالتونسي، فاستبطان الصور والأحداث وتمثّلها وإعادة التفكير فيها من جديد هو عمليّة معقّدة أشبّهها باللحظات الحميميّة، أقصد تلك اللحظة التي نتلقّف فيها النص لنحاول فهمه في ما بعد على طريقتنا الخاصّة. هكذا كان الأمر مع غريب كامو، أخرجته من الإطار المعتاد وأنزلته إلى أرض تونسيّة خالصة. أنا حاولت إعادة خلق مارسو جديد يتكلّم بالتونسي. وهو مشروع محليّ وسيبقى محليا (لعقود طويلة) لأننا لم نحسم أمرنا بعد مع اللغة العربيّة، إذ ثمّة من يرفضون العاميّة ويحتكرون الفضاء الفصيح لأنفسهم، فالعربيّة في وضعها الحالي، لغة ‘زومبي‘ لأنّها لغة حيّة وميّتة في نفس الوقت. هي تتأرجح بين العالمين بسبب ربطها بالمقدّس، لذلك وأعتقد أنّ محاولات الترجمة التي أنجزها هي نبش في جبل التطرف الديني/ اللغويّ ولو بإبرة دقيقة”.
الدارجة هي المنقذ
لا يمكن تجاهل حقيقة أن الكتاب منتج ثقافيّ ذو خصائص جماليّة وسياسيّة، وحين سألنا بوسالمي عن هذه الخصائص وعلاقتها بالغريب، وماهية الاختلاف بين النسخة الفصيحة والنسخة الدارجة من الرواية يجيب بأن الرواية تكمن قيمتها لا في الأحداث فقط بل في العوالم التي تصوّرها وقدرة اللغة على إيصال ملامح الشخصيات وأدقّ تفاصيل حياتهم، ومن هنا برأيه يكمن الاختلاف الجوهري بين النسخة الفصيحة والنسخة الدارجة، فالهواجس التي تقض مضجع مارسو، وحيرته أمام عالم متغيّر وفاقد للمعنى هي فعلا بالنسبة إلى التونسي، أعمق وأكثر قربا ووضوحا إن قرأها بلهجته التي يستعملها يوميا.
ويضيف “أصبح التونسي بعد الثورة في حالة من الضياع، فوضى عارمة وتمرّن على الديمقراطيّة، حتى على المستوى المعجمي، إذ لاحظنا ورود كلمات جديدة لم نعهدها من قبل (اعتصام، إضراب، شهيد، محاسبة، إلخ)، كل تونسي هو مارسو يحاول إيجاد المعنى لما يحيط به، وهو من الأسباب التي دفعتني إلى أن أختار رواية الغريب كأوّل رواية أترجمها ضمن هذا المشروع. ألخّص فأقول، إنّه كان خيارا جماليا وسياسيا في نفس الوقت”.

يرى بوسالمي أن الهدف من الكتابة بالدارجة هو التوجّه بالخطاب لأبناء الوطن، فالكتابة بها أو الترجمة إليها مرتبطة بمشروع يهدف إلى إضفاء طابع محليّ بالضرورة على العمل الإبداعي/ الأدبي. وقد تتفاوت التجارب من بلد إلى آخر، فمثلا في مصر تساعد السينما في انتشار اللهجة وبالتالي يصل المنتوج الثقافي إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، ما يحقق انتشارا عربيا. لكنّ الهدف الرئيسي بالنسبة إليه هو “تونسة” الأدب والفلسفة.
ويتابع الكاتب “ما دامت الفكرة هي التي تتسيّد فإنّ الوعاء الذي يحملها هو مجرّد زخرف أو بشكل أدقّ صلصال، نشكّله كيفما نشاء طالما أنّ المتلقي يفقه ما نقول ويرى فيه مرآة عاكسة لشيء منه، كما يمكن أن أتفهم رفض البعض نقل كتبهم إلى الفصحى كما في حالة الشعر، كقصيدة في الضحضاح (غرض شعري موجود في الجنوب التونسي) أو شعر الطيب بوعلاّق (شاعر تونسي) أو شعر أحمد فؤاد نجم، فكلّها نصوص كتبت بالعاميّة ولا يمكن أن تنقل إلى الفصحى وإن نقلت، فستفقد شيئا من بريقها”.
نعرف تاريخيا هيمنة لهجة قريش على اللغة العربيّة بسبب التدوين، الذي كوّن الفصحى وتاريخ تقعيدها، لكن غياب تدوين رسمي أو شبه رسمي للهجات الدارجة، هو ما يكسبها حيويتها وتجددها، وهنا يختلف معنا بوسالمي الذي لا يعتقد أنّ غياب التدوين عن الدارجة أمر سلبي، وربما إن حصل، فلن يغيّر شيئاً، لأنّ الدارجة تتطوّر يوميا لا بل إنّها ومع تنامي ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تتطور كل ساعة، لذلك هي لهجة نمارسها ووسيلة نتخاطب بها، ما يجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بهويتنا، أما التدوين وعدمه فلن يغيّرا في الأمر شيئا كبيرا.
ويضيف “التدوين عمليّة يتمّ بموجبها التقنين وهو أمر لم تخضع له اللهجة التونسيّة من قبل، والدارجة حسب رأيي هي كالمنقذ الذي يأتي من الخلف، لينتشلنا وينير أذهاننا لحظة انزلاق، لذلك فانّ كلمة تدوين تحيل إلى قواعد، والقواعد تحيل إلى ما يسميه ميشيل فوكو المؤسسات التي تعتبر كالسجن، فلا أرغب أن تتحوّل اللهجة إلى مجموعة من القواعد الصارمة، فقوتّها وجمالها في ديناميكيتها والقول بالقواعد فيه إقصاء للآخر، لكن سنتحدّث إن وجدت القاعدة في اللهجة، عن شخص مُجيد لها ومتمكّن منها وعن شخص أقل تمكنّا، وهو ما يفقدها بريقها وخصوصيّتها”.




























