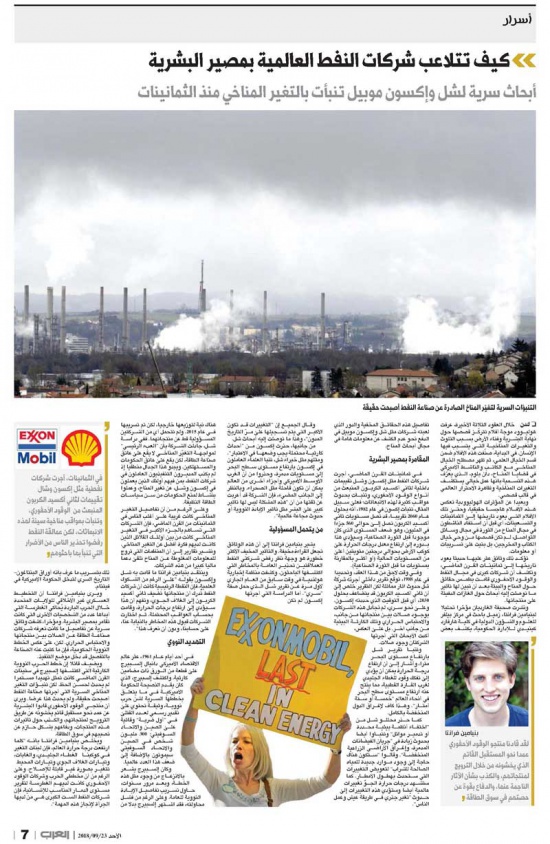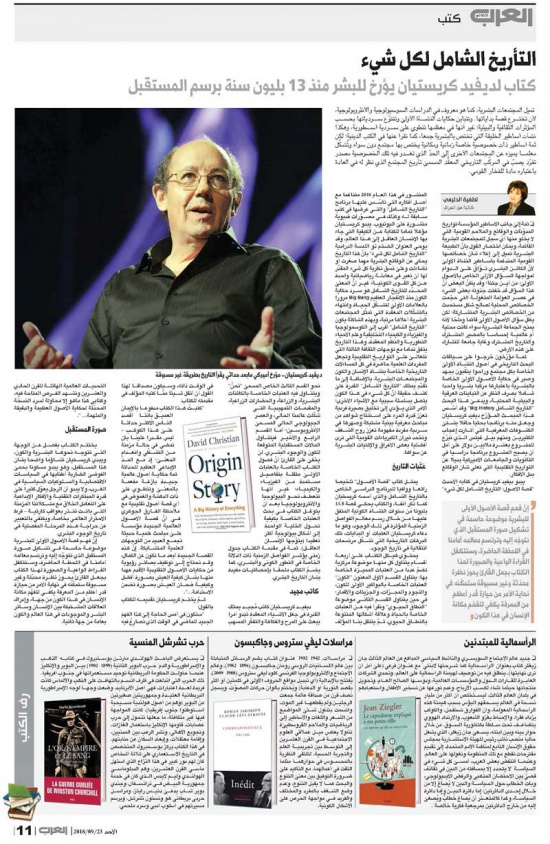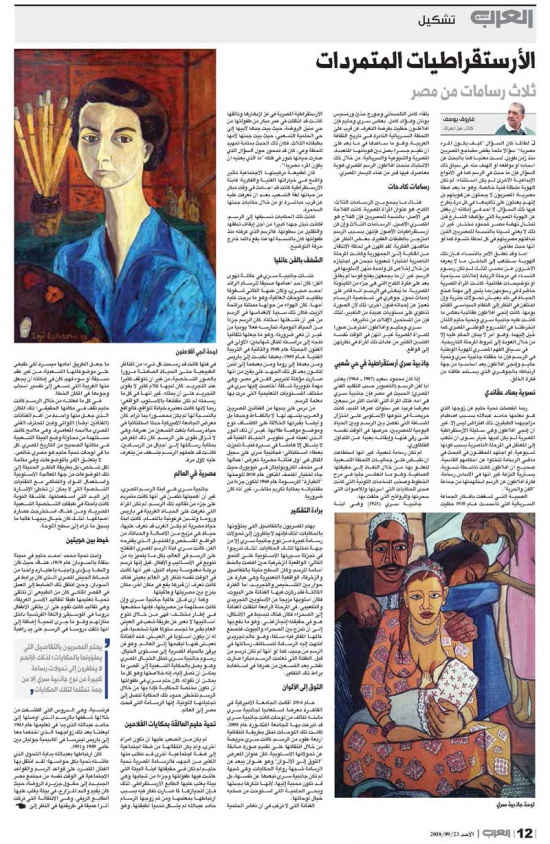ما علاقة تكيّف المرأة مع العالم بعد اكتشاف ذاتها بإقدامها على الانفصال

المرأة العربية المطلقة ليست مجرد ظاهرة اجتماعيّة منبوذة، هي أعمق بكثير من ذلك، فهي تحمل دوافع مشحونة بمتطلّبات نفسية وجسدية مهمّشة، وأسباب طلبها للانفصال متشعبة أحدها يفضي إلى الآخر، تنطلق شرارتها الأولى منذ أن تسمح لنفسها بأن ترى حياتها بمنظور الآخرين وفق منظومة فكريّة متكونة من مزيج من التقاليد الاجتماعية والدينية تملي عليها أن تختار في دائرة من يختارونها من الرجال.
تستدعي ظاهرة إقدام المرأة على الانفصال عن شريكها، أو فسخ عقد الزواج، لأسباب قد يراها البعض غير موجبة، وقفة تأمّل في المضمر من الدّوافع، والمكبوت من المشاعر، وفي ما يأباه الأنا الأعلى الجمعي من صعود ما استقر في اللاوعي ليتظهّر في السلوك. تورد المرأة حججا في سبيل دعم موقفها توصف بالواهية، كما ينعت قرارها بالمجحف بحق الزوج الذي لا يشينه أي سلوك يبدو للعيان.
قبل الحكم على النهاية، أو محاكمة من اتهمت بتسببها محاكمة عقليّة، ووفق معايير أخلاقية، لا بد من العودة إلى البدايات، وطرح الأسئلة عن دوافع الزّواج، وإمكانية الاختيار، وتاليا عن مفهوم الحب. لعلّ أغنية لبنانية شعبيّة غنّتها فيروز تنطوي على الكثير من الدلالات، وتجيب عن جزء من التساؤلات، مطلعها “بحبّك، ما بعرف، هنّ قالولي… لا تشدني بإيدي.. عنهر بدنية هَنا جديدة. اتركني بعد بكير..”.
تشير الأغنية إلى قلب فتاة لم تختبر الحب من قبل، ولم تختر هذا الحبّ، بل تأثّرت برأي الآخرين. وهو الحبّ غير العارف، نقلها إلى عالم من السعادة والهناء لم تحتمله، ولم تحلم به؛ فما زالت صغيرة، غير قادرة على الاستيعاب، وليست قابلة لفهم هذه الدنيا الجديدة والتكيّف معها. إنّها البراءة المطلقة، والدّهشة التي ترى في كل شيء موضوع حبّ، وفي أيّ همسة يهمسها هذا الرجل، الكائن الغريب عنها، والذي اقتحم حياتها من طريق وشوشة أو “وسوسة” منهنّ، ترى العالم بأسره. يتولّد السؤال عن إمكانيّة تصنيف هذه المشاعر الطازجة ضمن إطار الحبّ. وإن قُيّض لها أن ترقى إلى مستواه، فما الذي يحدث بعد اجتياز مرحلة زمنيّة من التّحابّ، ولِمَ التحوّل في المشاعر الحميمة إلى نقيضها؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، وفهم البعد السيكولوجي لمطلع الأغنية “بحبك ما بعرف، هن قالولي”، نعود إلى صادق جلال العظم الذي قوّض مفاهيم مغلوطة عمّا يسمّى “بالحبّ العذري”؛ لنجد ما يضيء درب الفهم.
يرى المفكّر أنّ الإنسان الذي يعاني الحرمان الجنسي الطويل عاجز، في الحقيقة، عن التمييز بين حالات الشعور بمجرد الانجذاب الجنسي، وبين الحب بوصفه حالة تتخطى حالة الانجذاب الأولى.
وكثيرا ما يقع هذا الشخص في هيام أول إنسان يصادفه يبدي نحوه اهتماما عاطفيا حتى لو كان ذلك من باب المداعبة العابرة. إنّما ما يظنّه حبا ليس إلّا رغبة مكبوتة كانت ستضعه في حالة مشابهة تجاه أيّ شخص آخر يعترض طريقه على نحو مماثل. إذن، الباعث على هذه الحالة ليس الحب، وهو لم يبلغ مرتبته بعد، بل رغبات مكبوتة رأت فجأة بعضا من الأمل، للتنفيس عن ضيقها. فلا يُنتظر من إنسان يعاني الجوع أن يميّز بين أصناف المآكل والمشارب.
المرأة تعيش تجربة صوفية تحملها في رحلة روحيّة تبحث من خلالها عن فهم ذاتها وعقد تصالح مع العالم، والاندماج مع مجتمع عانت الانفصال عنه من قبل
واستكمالا للمنظور السيكواجتماعي، فإنّ المرأة في الأغلب مقيّدة الحركة، دائما ما ترى حياتها بمنظور الآخرين، ومن خلال منظومة قيميّة، الغلبة فيها للذكورة، حتّى باتت لا تعرف ذاتها إلّا من خلالهم. هذه الحالة يطلق عليها تسمية “التماهي مع السلطة” حينما يرى المقهور كيانه بعين القاهر.
المنظومة الفكريّة من مجموع التقاليد الاجتماعية والدينية الصارمة أملت على المرأة أن تختار في دائرة من يختارونها من الرجال، وأظهروا رغبتهم في التقرّب منها، إذ لم توفّر بيئة مناسبة للاختيار الحقيقي؛ فليس أمامها إلا أن تستجيب بالرفض أو القبول. ماذا عمّن لم يبدوا نحوها حماسة تشعرها بأنّها مرغوب فيها؟ قلّما تستطيع أخذ زمام المبادرة العاطفيّة لإبداء ميلها نحو من تريد.
ثمّة مثال عن اللا اختيار، أو اللا معرفة من المرويّات الذاتيّة تبوح به الكاتبة النسويّة كارول بي كريست؛ حيث تسرد “في المدرسة، كنت أحصل على درجات متقدمة إذا فعلت ما يطلب مني أن أفعله. وحينما التحقت بالجامعة، لم تكن لديّ أيّ خلفيّة عن أي شيء يطلب مني دراسته”.
لكن، متى تفكّر المرأة في أن تتمرّد على انغلاقها في الصمت؟ ومتى تقرّر الغوص في أعماقها لتخرج بالتجربة إلى السطح في بوح سرديّ، أو انتفاضة على واقع معيش؟ وكيف تتمظهر هذه الانتفاضة، إذا صحّت لنا تسميتها بذلك؟
إنّما تصفها كريست “بالصوفيّة النّسويّة”، موضّحة اختلاف الهدف من الرحلة الروحيّة لدى المرأة عمّا هو لدى الصّوفي؛ فتجربة المرأة مع ذاتها وتاريخها ومجتمعها تختلف مساراتها عن تجربة الرجل. تكمن رغبتها في فهم ذاتها وعقد تصالح مع العالم، والاندماج مع مجتمع عانت الانفصال عنه من قبل؛ في حين يبتغي الصّوفي الانفصال عن جموع البشر والانعزال مؤقتا بحثا عن إمكانيّة التوحّد مع الذات العليا، أو التشفّف.
هكذا، يطفو السؤال التالي: ما علاقة تكيّف المرأة مع العالم بعد اكتشافه، وتكشّف ذاتها، وتفتّح مشاعرها، بإقدامها على فكّ ارتباطها بزوج أو شريك؟
حين تكون المرأة قد عاشت طويلا في جو ثقافة بعينها، بالإمكان أن تشعر بفضول يدعوها إلى التساؤل عمّا سيكونه مصير هذه الثقافة، والتحوّلات التي لا بدّ من أن تصيبها.
ربما يكون الأمر كما ألمح إليه سيغموند فرويد، لكنّ شجاعة التمرّد على وضع قائم غير مرغوب فيه لا تأتي إلّا من معاناة متجذّرة في الوجدان، وتاريخ طويل من القيود المفروضة على مشاعرها. حينما فجأة، تفتح صندوقا أورته زمنا، كبتت فيه رغباتها، لتبدأ رحلتها في اكتشاف ذاتها من منظورها الخاص، وبالتجربة المعيشة للحب الحقيقي.
هذا الصندوق يحاكي، بمسار معكوس، صندوق باندورا الأسطوري، والذي بسبب الفضول البشريّ، خرجت منه كل الشرور التي تصيب الإنسان، ليبقى اليأس محبوسا في داخله؛ فتمتّع الإنسان بنعمة الأمل. غير أنّ نسيج صندوق المرأة حيك من اليأس، والغربة عن خبرات النفس العميقة؛ وبانفتاح بابه خروج من عزلتها، وانكشاف درب رحلتها في تفكيك خيوط اليأس، سعيا للقبض على معنى وجودها.
ليس باستطاعتنا فهم المعادلة بغير إضاءة “مفارقة الحبّ الكبرى”، كما وصفها جلال العظم، مبيّنا اتّجاهين متعارضين للحبّ في طبيعته الأصليّة، ما يجعله مفهوما إشكاليا، حيث ينزع نزعتين متضاربتين، ولا يمكن إشباع الأولى إلا على حساب الثانية، ولا يتحقّق الاكتفاء بالرغبة الثانية إلا بالتضحية الأليمة بمتطلبات النزعة الأولى وحرمانها من الشعور بالرضا.
والبعدان اللذان يشكّلان عاطفة الحبّ هما: الامتداد في الزمن، أي دوام الحالة العاطفيّة وتجانسها، والاشتداد، وهو يدلّ على مدى عنف الحالة العاطفيّة وحدّتها في لحظة ما في الزمان.

العلاقة بين الامتداد والاشتداد ليست بالبساطة التي نتصوّرها. الواقع يكشف أنه كلما طالت مدة الحبّ خفّت حدّته وتناقص اشتداده، وقد يقترب من درجة الصفر.
العلاقات الغرامية التي تنزع إلى الاستمرار تفقد عنفها وزخمها بمرور الزمن لتتحول إلى علاقة ودّ وألفة بين متحابّين. تبدو علاقة كهذه شاحبة غير قادرة على إثارة أي اختلاج أو انخطاف في أعماق الإنسان. أمّا تجربة العشق فغنيّة ومكثّفة ومضغوطة في لحظة مطلقة لا امتداد لها أبدا. هي تجربة عميقة في تغلغلها إلى خفايا الروح لتهزّها وتثيرها وتوتّرها.
ثمة صراع بين نزعتي الامتداد والاشتداد في عاطفة الحبّ، بوصفهما قوّتين تتجاذبان الإنسان بين طلب الاستقرار أو المغامرة؛ حيث تتجسّد نزعته الامتداديّة في مؤسسة الزواج والأسرة التي يفترض بها أن توفر الطمأنينة والسكينة للطرفين، وفي الوقت نفسه ثمة ضريبة الرّتابة يدفعانها.
وهي تشكّل جزءا لا يتجزّأ من حياة البيئة الاجتماعيّة التي تحيط بالفرد وتنزع نزعة محافظة غايتها صيانة نفسها بمراعاة الأوضاع القائمة حولها. لذلك تنظر نظرة ريبة وقلق إلى نزعة الاشتداد بوصفها قوّة لو أتيحت لها فرصة الانطلاق لعصفت بما هو قائم وهدّدت استقرار الحياة.
العشق الذي يمثّل نزعة الاشتداد هو الحاضر الغائب، حيث لا يذكر في اسمه وكأنّه الحضور الكثيف العصيّ على الامتلاك، ويشكّل قطبا في الصراع الذي تعيشه المرأة بين حياتها الرّتيبة والتزاماتها الاجتماعيّة من جهة، وشعورها بأنّ لها حقًّا في الحياة والحبّ والعشق. قد تنتفض في ثورة عارمة تستغني بها عن عمر لا حياة فيه، من أجل لحظة كمال واكتمال هي الحياة بأسرها في أبهى تجلياتها.
لم تكن غاية هذا المقال الحكم على ظاهرة اجتماعيّة، لا سيّما من منظور أخلاقي عقلاني، إنّما هي محاولة لملمة للدّوافع النفسيّة الممكنة خلف الالتفات إلى متطلّبات النفس والجسد المهمّشة، ومن زاوية محددة ليس إلّا. قد يعلن قائل أنّ الفتور في العلاقة الزّوجية، وطلب الانعتاق تاليا، يصيب الرّجل أضعاف ما يصيب المرأة، وأنّ ثمة تفاصيل أخرى، وأسبابا عقليّة واجتماعيّة تدفع أحد الطرفين إلى الانفصال.
البحث يطول، وللقارئ حريّة التفكّر وتأويل التجربة. فمعالجة مواضيع زئبقيّة كهذه، ينجدل فيها الذاتي والموضوعي، الفردي والجماعيّ انجدالا لا فكاك منه، تبقى عصيّة على الإحاطة بجوانبها كافّة، وعلى التوصّل إلى نتيجة حاسمة جامعة لآراء ومشاعر متباينة تنبثق من منابع ثقافيّة وتاريخيّة شتّى، تتأرجح بين الإدانة الأخلاقيّة والتعاطف الإنساني.
فكما أنّ الفلسفة بماهيّتها تثير الأسئلة، وبطبيعتها عدوانيّة ولا بدّ أن تحزن أحدا، فإنّ أي موضوع سيكواجتماعي لا يحدّه أفق، ويحتمل تنظيرات وتعليلات متعدّدة؛ والحقائق في البحوث الإنسانيّة تبقى وجهتها الإمكان وليس الإطلاق.