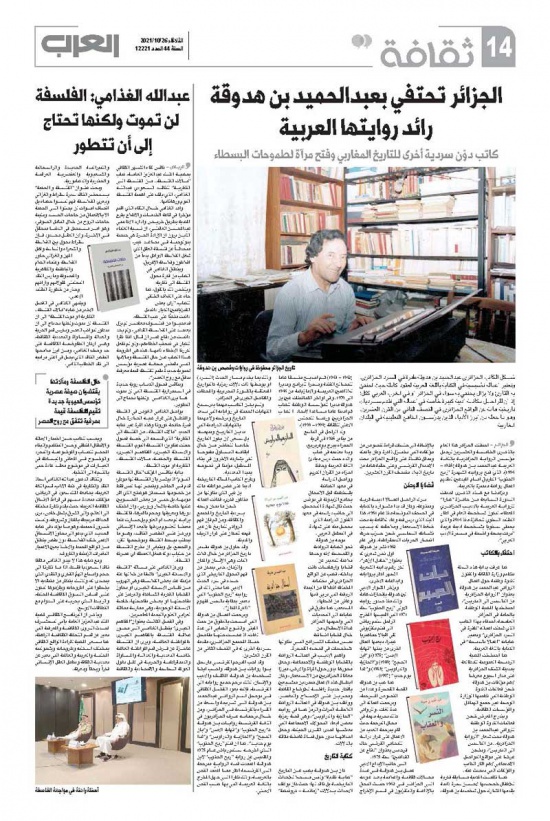هل تستطيع تونس أن تكون دولة ديمقراطية دون أحزاب؟

في عام 1796، انتقد الرئيس الأميركي جورج واشنطن، الأحزاب السياسية لكونها أتاحت الفرصة لرجال “مخادعين وطموحين وبلا مبادئ لتقويض سلطة الشعب”.
بدأت الفصائل أو الأحزاب السياسية في التكون أثناء الصراع على التصديق على الدستور الفيدرالي لعام 1787. وزاد الخلاف بينها مع تحول الاهتمام من إنشاء حكومة فيدرالية جديدة إلى مسألة مدى قوة تلك الحكومة الفيدرالية. فقد أراد الفيدراليون بقيادة وزير الخزانة ألكسندر هاميلتون، حكومة مركزية قوية، بينما دعا المناهضون للفيدرالية، بقيادة وزير الخارجية توماس جيفرسون، إلى حقوق الدول بدلا من السلطة المركزية. اجتمع الفيدراليون حول القطاع التجاري للبلاد بينما استمد خصومهم قوتهم من أولئك الذين يفضلون المجتمع الزراعي. دفعت المعارك الحزبية التي تلت ذلك بجورج واشنطن إلى التحذير من “الآثار المهينة لروح الحزب” في خطاب الوداع الذي ألقاه كرئيس للولايات المتحدة.
رأى واشنطن حينذاك أن أحد المخاطر الرئيسية للسماح للولاءات الإقليمية بالسيطرة على الولاء للأمة ككل. وعندما صوّت الأميركيون وفقا للولاء الحزبي، بدلا من المصلحة المشتركة للأمة، كان واشنطن يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز روح الانتقام، وإلى ظهور “الرجال الماكرين والطموحين وغير المبدئيين” الذين “يغتصبون لأنفسهم مقاليد الحكم بعد ذلك، ثم يدمرون المحركات ذاتها، الأمر الذي يدفعهم إلى الهيمنة الظالمة”.
في خطاب الوداع في 19 سبتمبر 1796، قال واشنطن “اسمحوا لي الآن أن ألقي نظرة أكثر شمولا، وأحذركم بأشد الأساليب جدية من الآثار المدمرة لروح الحزب بشكل عام”.
وبقطع النظر عن مزايا دور الأحزاب في الحياة السياسية، إلا أن لا أحد يستطيع أن يتجاهل مساوئها، ومن ذلك الدعاية الأنانية أو الارتباطات العقائدية التي قد تضرّ بالمصالح الوطنية، أو بالمناخ السياسي العام، وإمكانية خلق الشقاق والترويج للعداوة بين الأفراد والجماعات، أو تدمير خصوصية الفرد وطمس رؤيته الخاصة تحت غطاء الهيمنة الجماعية التي عادة ما تكون لمصلحة العناصر القيادية دون غيرها، وحرمان البلاد من الكفاءات والمواهب حيث أن أحزاب المعارضة عادة ما تكون خارج السلطة بمن فيها من أشخاص قد تكون لهم قدرات مذهلة على التغيير، بالإضافة إلى إمكانية تورّط الأحزاب في الفساد، سواء بشراء الأصوات والولاءات أو بتوزيع المكافآت على المحسوبين عليها، أو بترويج الوعود الانتخابية دون الوفاء بها، وجعل من يرى الحزب أنه سيستفيد منهم في مرتبة مهمة من السلطة دون اعتبار لمبادئ الكفاءة والخبرة.
هذا الواقع ليس بعيدا عن تونس التي واجهت خلال السنوات العشر الماضية، عددا من الأزمات كادت أن تدفع بها إلى انهيار الدولة وإفلاسها وتقسيم المجتمع، وإذا كانت الدول الغنية والقوية وذات الديمقراطيات الراسخة باتت توجه انتقادات واسعة للأحزاب، فإن الفرق بينها وبين الدول الفقيرة والضعيفة وذات الديمقراطية الناشئة أن الأولى تتميز بمؤسسات قادرة على حماية مقومات الدولة، في حين الثانية تتحول فيها الأحزاب إلى أجهزة تحاول أن تضع نفسها مكان المؤسسات، أو تسعى لاختراقها والسيطرة عليها عبر تحالفات مشبوهة كما حدث في تونس.
وإذا كانت غالبية التونسيين أصبحت تعلن عداءها الواضح لدور الأحزاب، فإن أي محاولة لفرض نظام سياسي جديد يقطع مع مكونات الديمقراطية الغربية بشكلها السائد، سيدفع بالبلاد نحو عزلة حقيقية في محيطها الجغرافي وبين شركائها التقليديين، وقد يكون نظام الحزب الواحد على علاّته، أهون من نظام لا يعترف بالأحزاب جملة وتفصيلا.
لا شك أن الرئيس قيس سعيّد يحظى بدعم شعبي جارف، ولكن ذلك غير كافٍ، فالجموع عادة ما تحكمها العواطف الجيّاشة، وعلى القائد المحنّك أن يستفيد من تلك العواطف بتحويلها إلى طاقة إنتاج لفائدة المشروع الذي يؤمن به، فيكون الشعار آنذاك هو “الشعب يستطيع” لا “الشعب يريد” حتى لا نسقط في دائرة الشعبوية المقيتة.
الشعب يريد الثروة والسلطة والرفاه دون بذل أي جهد يذكر، والشعب يريد الرواتب العالية والإسكان الجيّد والخدمات الممتازة، ولكن من أين نأتي بذلك إذا كانت خزينة الدولة خاوية؟ والشعب يريد مكافحة الفساد وهو الذي يساهم في نشره بتحويله إلى نمط حياة، فالمواطن الذي يلعن الفساد والفاسدين وهو جالس على ناصية مقهى سرعان ما يصبح فاسدا عندما يجد الفرصة الملائمة، والنماذج كثيرة في المجتمع، حيث هناك فاسدون باسم الدين، وفاسدون باسم الديمقراطية، وفاسدون باسم الوطنية، وفاسدون باسم مكافحة الفساد، وهناك فساد عشوائي يمارسه العامّة ضد بعضهم البعض.
هذا يعني أن المشكلة الأساسية ليست في الأحزاب ذاتها، وإنما في الثقافة الطاغية على مجتمع يعاني من ندرة الموارد المالية والاقتصادية، وهو ما يجعل من الفساد موردا سهلا لمن يركب صهوة السياسة، ولمن يمارس العمل الوظيفي في أي مجال، ومن يشتغل في التجارة والزراعة والثقافة والإعلام والخدمات وأي مجال آخر.
أكدت أغلب التقارير المحلية والأجنبية أن الفساد في تونس ضرب كل القطاعات بما في ذلك الأمن والقضاء والتعليم والبرلمان، وألمح الرئيس سعيّد إلى مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين عبثوا بمبالغ ضخمة من المال العام، وشهدت الأشهر الماضية توجيه اتهامات إلى قضاة مرموقين ورجال أعمال من ذوي الفعل السياسي المؤثر بالتورط في الفساد.
عندما وصل زين العابدين بن على إلى الحكم في العام 1987 كانت نسبة كبيرة من التونسيين تتهم النظام السابق بالفساد، في 2011 برّأت تلك الجموع العهد البورقيبي ووضعت كل وزر الفساد على نظام بن علي، ثم تبيّن أن من جاءت بهم صناديق الاقتراع إلى الحكم لاحقا كان أغلبهم من الفاسدين الذي لم تر البلاد لهم مثيلا خلال السنوات الستين السابقة. وإلى اليوم، هناك فاسدون في كل المجالات يواصلون ممارساتهم المشينة، ويستهدفون قوت المواطن البسيط، الرئيس سعيّد ذاته أشار إلى ذلك في مناسبات عدة، ولا أحد يضمن أن من سيأتون لاحقا سيكونون مثالا للنزاهة ونظافة اليد، فالمسألة لا علاقة لها بالأشخاص، وإنما ترتبط أساسا بالقانون ونفاذه وبوعي المواطن ودفاعه عن مصلحته في وطن يخضع لحوكمة رشيدة ولا مجال فيه للعبث بالمال العام وبقوت الفقراء.
إن قضية الفساد، وإن كانت أساسية في تونس، لا يمكن تحميلها للأحزاب وحدها، ولذلك فإن الحديث عن حوار وطني دون أحزاب أو منظمات وطنية سيزيد من تعقيد الوضع في البلاد، فإذا كان السبب هو الفساد فإن المجتمع كله مخترق بهذه الآفة، وإذا كان الهدف هو استبعاد الأحزاب من الصراع الطبيعي والتقليدي على السلطة، فإن ذلك يعني حلّها، وقد يكون حلّ الأحزاب والنقابات منطلقا لحين تجاوز الأزمة قبل السماح لها بالعودة إلى النشاط مع استقامة الأوضاع، أما وجود الأحزاب كديكور بلا روح ولا دور فإنه يعني تحويلها إلى عدوّ في معركة طاحنة لن تقف عند حد.
أما إذا كان الأمر يتعلق بما يتحدث به المحسوبون على الحملات التفسيرية لمشروع الرئيس من خيار الديمقراطية الشعبية أو “المجالسية” أو القاعدة، أو مبدأ سلطة الشعب، فإن تونس لا تحتمل مثل هذه المغامرة، لاسيما أنه لا يوجد نظام جمهوري أو ملكي دستوري في العالم من دون أحزاب، بما في ذلك الدولة المحكومة بنظام الحزب الواحد. وقد يكون من الأفضل لو أن أنصار الرئيس يشكلون حزبا سياسيا يخوضون به الانتخابات التشريعية ويستغلون المد الشعبي الكبير للسيطرة على البرلمان القادم، ومن هناك يستطيعون إدخال تعديلات على الدستور، وتنفيذ ما يرونه صالحا، ولكن في ظل الممكن الذي لا يمثل استفزازا لأي طرف.
عندما وصل معمر القذافي إلى الحكم في العام 1969 لم يجد أحزابا نشطة في ليبيا يحلّها أو يلغيها، وإنما كان النشاط الحزبي محظورا من قبل النظام الملكي منذ العام 1952، وهو ما فسح أمامه المجال لتطبيق نظرية سلطة الشعب بداية من مارس 1977 ومن مبادئها أن “من تحزب خان”، وقد جاء ذلك في سياقات تاريخية مختلفة تماما عن السياقات الحالية، ولاسيما من حيث صراعات المحاور في ظل الحرب الباردة، كما أن ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية التي ساعدت القذافي على توفير الحد الأدنى من حاجيات شعبه.
إن ما ورد على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي من أن لا ديمقراطية بلا أحزاب، هو كلام بديهي، ولكنه يكشف عن بوادر تصعيد تبدو تونس غير محتاجة إليها في الوقت الحالي، ولا شك أن حكمة الرئيس سعيّد تتفهم ذلك جيدا وتضعه في محل الدراسة والتمحيص.