ما فائدة وزارة الثقافة.. تعالوا نطرح السؤال
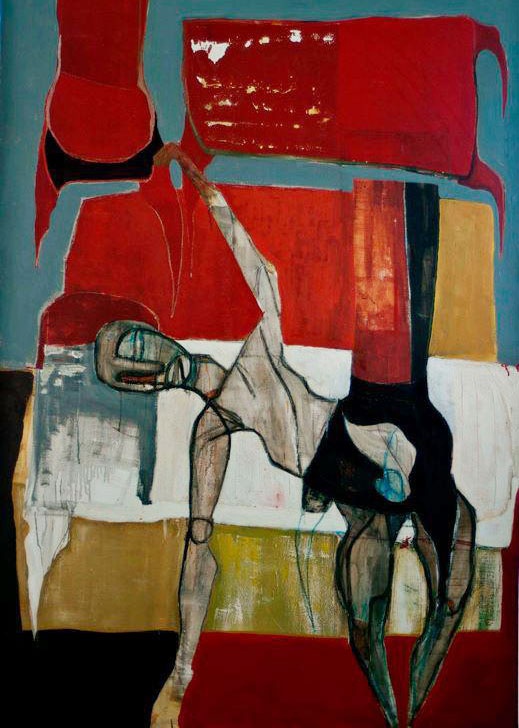
تتجدد في كل مرة في تونس على غرار أقطار عربية أخرى جدوى تركيز وزارة للثقافة تتوجه جل ميزانيتها لأجور موظفين مكتبيين ولتظاهرات مناسباتية ودعم بعض الأعمال الفنية بشكل يشبه المساعدات الاجتماعية للمبدعين ولا يرقى بالفعل الإبداعي. أسئلة كثيرة طرحت ومازالت تطرح إلى اليوم لتغيير الواقع الثقافي الذي لا يتوقف عن الانحدار.
أكثر من تساؤل مشروع يدور في خلد المنشغلين بالثقافة في تونس (كي لا نقول المثقفين) وهو يقرأ بلاغ وزارة الشؤون الثقافية منذ أيام، عن “إطلاق مناظرة لتصميم شعار لها احتفالا بمرور 60 سنة على إحداثها (1961)”.
تبدأ هذه التساؤلات بالسؤال عن جدوى منصب وزير الثقافة الذي بقي شاغرا لأشهر، والذي شغله بالنيابة وزير السياحة السابق الحبيب عمار بعد أن أعفي سلفه وليد الزيدي من منصبه على إثر “تمرده” على رئيس الحكومة السابق في ما يخص استئناف النشاطات الثقافية أثناء أزمة كورونا، وتصريحه الشهير بأن “وزارة الثقافة ليست وزارة تنفيذ بلاغات الحكومة”.
البقرة الحلوب
هي جملة قضايا مستطرقة تتعلق أولا بماهية وجود وزارة للثقافة التي يقع التعامل معها عادة كقطاع استهلاكي يرتبط بسلطة إشراف، وتوجيه مركزي يتم من خلاله تقنين الثقافة وإدارة أزماتها الهيكلية إن وجدت.. تماما مثل وزارات النفط والكهرباء، وكذلك الموز والسمك وغير ذلك من الثروات في بعض البلدان.
بناء على ما تقدم، نفهم أن الحكومة لا تجد مانعا من تكليف وزير آخر بإدارة الشأن الثقافي المتمثل في توقيع العقود والاتفاقيات وصرف الرواتب والمنح والمكافآت، وكذلك التعيينات والعقوبات، مثلها مثل أي قطاع تشرف عليه الدولة كتوزيع الماء والغاز والكهرباء.
وزارة الثقافة في بلد مثل تونس، أصبحت أشبه بالبقرة الحلوب لبعض من يتربعون على ما يعرف بصناديق الدعم
هذه الوصاية من الدولة على الشأن الثقافي في تونس يشبه نفس الوصاية على الإعلام عندما كانت له وزارة تشرف وتوجه وتمنع وتلغي كل ما لا يتفق مع مزاج الحاكم بأمره في دولة يحكمها نظام شمولي.
الانفتاح الديمقراطي جعل تونس تلغي وزارة الإعلام على اعتبار أنه من غير اللائق التحكم ووضع اليد على ” السلطة الرابعة”، إذ لا بد من أن يكون لكل مؤسسة مكتبها الإعلامي الخاص بها وفق ضوابط تضمنها وتشرف عليها هيئات متخصصة.
لماذا لا تُعامل وزارة الثقافة بنفس ما عوملت به وزارة الإعلام أي إلغاؤها بشكل غير مأسوف عليه، والاكتفاء بإنشاء هيئات إشراف في ما يتعلّق بالقضايا السيادية وشبه السيادية التي تتصل بالتراث المتحفي والفولكلوري؟
أما تلك البنى التحتية المتهالكة كالمراكز الثقافية وغيرها، والتي يؤمها الخواء، ويديرها موظفون يتثاءبون ويرتشون في غالبيتهم، فالأجدر تسليمها إلى مستثمرين أكفاء ينفضون عنها الغبار وينشطونها عبر الاستعانة بمؤسسات خاصة ورؤوس أموال وطنية.
ماذا يفعل جيش هائل من الموظفين وراء المكاتب وفي الممرات والمستودعات أمام آلة إنتاج متعطلة، وإن فعلوا شيئا فبدافع المحسوبية والسرقة وتوزيع الغنائم، ومنح الامتيازات إلى من لا يستحقها.
أليس الأولى أن يذهب هذا المال العام المهدور إلى مشاريع تنموية حقيقية، وليس لأعمال خلبية ومزعومة تنهش من لحم البلاد باسم الثقافة.
ربما أدّت هذه المؤسسات دورها في السابق، وخدمت مشاريع وخططا ثقافية كانت قد رسمتها دولة الاستقلال، لكنها اليوم تمثل عبئا إضافيا على الحكومات، ومرتعا يعمه الفساد.
أصبحت وزارة الثقافة في بلد مثل تونس، أشبه بالبقرة الحلوب لبعض المتنفذين من الفاسدين، يتربعون على ما يعرف بصناديق الدعم ويمنحون المال العام إلى أصحاب مشاريع وهمية. والنتيجة هي إنتاج المزيد من الرداءة على حساب من يستحق الدعم من المبدعين الحقيقيين.
وفي أحسن حالاتها، وإذا ما غلّبنا النوايا الطيبة، فإن وزارة الثقافة تحولت إلى تكية تغض الطرف عن الإنتاج الإبداعي وتمنح المساعدات الاجتماعية تحت تسميات “مهذبة” كالمساعدات الإنتاجية وغيرها متناسية أن هذا النشاط ليس من مشمولات ولا من صميم مهماتها.
بلا وزارة للثقافة
ثقافة الكسل والتواكل أدت إلى إنتاج الرداءة وجعلت العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة في سوق الإنتاج الثقافي
كرامة المثقف والفنان في حالات المرض والعجز والكوارث الطبيعية ينبغي أن تتكفل بها مؤسسات وصناديق اجتماعية مقوننة وفق الأصول، وليس وزارة جعلت للإشراف على المشاريع الثقافية ووضع الخطط الإنتاجية.
هذا التخبط في الاضطلاع بالأدوار شجع على الفساد وغذى ثقافة الكسل والتواكل فأدى إلى إنتاج الرداءة وجعل العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة في سوق الإنتاج الثقافي، ذلك أن الجميع صار يوضع في سلة واحدة مثل ما يعرف ببطاقات الاحتراف التي تمنح للبعض دون الآخر، وتمكّن حامليها من غير الموهوبين أن ينالوا حصة غيرهم من المحسوبين على الهواة كتصنيف متدن في نظر بعضهم.
الخلل في مجمله هو هيكلي يتعلق بوجوب إعادة النظر في آليات عمل مؤسسات الدولة، ذلك أن الثقافة وإن ارتبطت بـ”خطوط حمراء” تمس الهوية والسيادة الوطنية، وما يعرف بالأمن الثقافي، فإنها ليست مخزن أسلحة أو مستودع أدوية وتلاقيح على الدولة أن تكفل وصولها إلى مستحقيها، بل هي جملة نشاطات بشرية لها منتجون ومستهلكون لا أكثر ولا أقل.
وبالنظر إلى بلدان متقدمة في إنتاجاتها الثقافية، نجد أن معظم المشاريع التي يقع ترويجها واستهلاكها تتعلق بصناديق ومؤسسات إنمائية وشركات إنتاجية خارجة عن نطاق موازنة مخصصة تحديدا لتلك المشاريع.
منطق الإنتاجات الضخمة التي تمولها وزارة الثقافة سقط مع سقوط جدار برلين، وولى مع مرحلة الدعاية للدولة الوطنية والبروباغندا السياسية، فحتى مسرح البولشوي الشهير الذي يمثل تاريخ روسيا الفني منذ القياصرة، لم يعد الصرف عليه من المال العام محل ترحيب من طرف المواطن الروسي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى”الكوميدي فرانسيز” لدى المواطن الفرنسي.
الدولة تلعب دور الوصاية على الثقافة، والمواطن، سواء كان منتجا أو مستهلكا، تورط في هذه الاتكالية واستسلم للكسل، لا بل صارت تسول له نفسه نوعا من النهب والسرقة حتى في اعتياده دخول قاعات العرض دون تذكرة. وهكذا يصدق المثل الشعبي القائل “المال الداشر يعلم على السرقة”.
قديما قال حكيم الصين كونفوشيوس “المثقفون لديهم مشكلة: عليهم تبرير وجودهم”، وهذه العبارة تأخذنا إلى استنتاج مفاده أن غالبية من المثقفين العرب، مشكلتهم أن ليست لهم مشكلة غير المنافع الخاصة فطوعوا الأنظمة والقوانين في صالحهم، سواء كانوا منتجين للثقافة أم مشرفين عليها أو حتى مستهلكين لها.
أعتقد أن بلادا بلا وزارة للثقافة هي بلاد بأقل قدر ممكن من الفساد والرداءة.
























