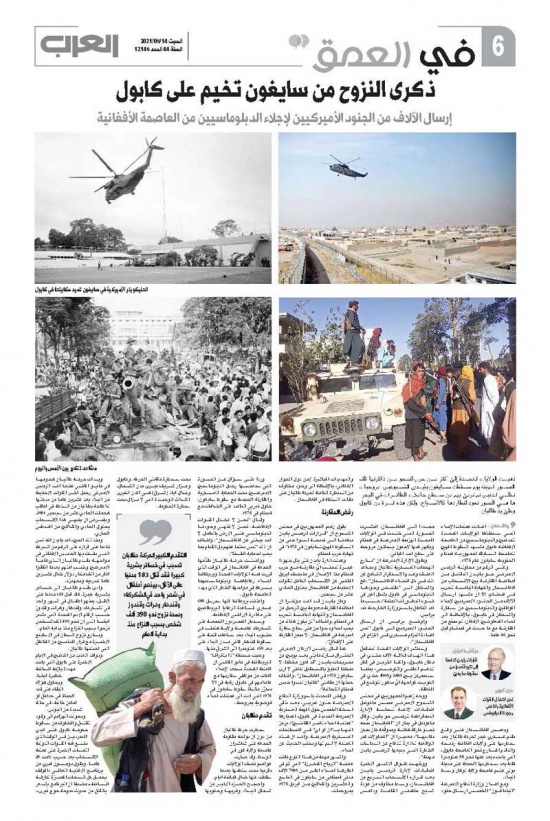كيف ترى الروايات والأفلام نهاية العالم والإنسان

تزخر السينما وأدب الخيال العلمي بأعمال تهتم بنهاية العالم، نتيجة كارثة بيئية أو نووية أو وبائية، وتستبق ما قد ينجر عنها من زوال الحياة كلها أو بعضها على وجه الأرض، بما في ذلك حياة الإنسان. فهل أن غاية تلك الأعمال تحذير الإنسان أم تخويفه، أم أنها نقد تسلطه بأشكال فنية على الواقع الراهن، بكل تجلياته؟
لم تكن الثورة الصناعية علامة تطور وتقدم ورخاء فقط، بل كانت أيضا مصدر تخوّف من المصير الذي قد تؤدي إليه الآلة ومتطلباتها، فمنذ بدايتها شُغل الأدب الغربي، في جانب منه على الأقل، بتصور نهاية العالم، هذه النهاية التي كانت من قبل تُعزى في المخيال الجمعي إلى غضب الآلهة أو الظواهر الطبيعية الخارقة، ثم صارت ناجمة عن فعل الإنسان ومخترعاته، وسعيه المحموم للسيطرة على الأرض ومواردها.
فمنذ نهاية القرن التاسع عشر ظهرت نصوص تحذر من إمكانية زوال الوجود الإنساني على الأرض في يوم ما، بسبب هذا التقدّم الذي جاء به. يمكن أن نذكر رواية الفرنسي جان باتيست كوزان دو غرانفيل “آخر البشر” التي صدرت عام 1805، وقصة الأميركي نثانييل هاوثورن “آدم وحواء الجديدان”، الصادرة عام 1843، أو رواية الإنجليزي رتشارد جيفريس “بعد لندن” التي نشرها عام 1885.
المخيال القيامي

الكتاب يتناول بعمق تخيلات نهاية العالم في الأدب والسينما ويحلل ما يسميه بـ"ما بعد الإنسان"
بمرور الزمن وتطور التكنولوجيا، لم تعد تلك المخاوف مجرد شطحات أدبية، حيث لاحت في الأفق مخاطر حقيقية كالحرب النووية، والتغير المناخي، والأسلحة الكيميائية أو البكتيرية، ما جعل الثيمة القيامية حاضرة في أعمال بعض الأدباء وكتّاب السيناريو، تلك التي تستثمر وتغذي الشعور بنهاية كارثية ممكنة مثل شريطي “اليوم التالي” و“2012” للألماني رولاند إيمريش، وحاضرة أيضا في أذهان العلماء أنفسهم، حتى أن بعضهم وضع “ساعة كارثية” كاستعارة عن وشك تدمير البشريةِ ذاتَها بسبب الأسلحة النووية والتغير المناخي، وعقارب تلك الساعة تعدّلها “نشرية علماء الذرة”، وهي مجموعة مؤلفة من علماء مشروع منهاتن بجامعة شيكاغو كانوا قد ساهموا في صنع القنبلة النووية، ولكنهم احتجّوا على استعمالها ضدّ البشر.
هذه الساعة تقول إن البشر باتوا على شفا مئة ثانية من منتصف الليل، أي أن الوقت أمامهم لتدارك الكارثة لا يني ينحسر باطّراد.
حول تخيل نهاية العالم في الأدب والسينما، صدر مؤخرا كتاب بعنوان “الإيهام بنهاية العالم – القوة النقدية للسرديات القيامية” لجان بول أنجيليبير، وهو باحث في الأدب المقارن، ركز فيه على عدد من الأعمال الفنية، أدبية وسينمائية، تشترك في كونها لا تتعامل مع تدمير الكوكب كمشهد فرجوي، بل تحاول أن تقدم طريقة أخرى للتفكير في الحاضر، وتجنُّبِ رؤية مستقبل بلا أمل.
إن المخيال القيامي، كما في مثال “الساعة الكارثية”، يطرح الزمن في الغالب بوصفه تطورا خطّيّا، لا محيد عنه، يسير من الحاضر إلى المستقبل؛ بيد أن السرديات القيامية تندرج في أزمنة أخرى، خارج هذه الكرونولوجيا، فهي تفتح ثغرة في الحاضر لتضع الحدث في أثناء الكارثة أو بعدها. من ذلك مثلا ثلاثية “آدم المجنون” التي صدرت للكندية مارغريت أتوود عام 2015، وتصوّر الحياة قبل أن تعمّ جائحة أهلكت السواد الأعظم من البشر، وما تلاها.
الرواية تخلق حدثا خالصا، بشكل يسمح بتحديد الزمن بين كايروس (الزمن الملائم) وكرونوس (الزمن الخطي أو المتواصل)، وإحلال الأحداث حسب ذلك البُعد. وغاية الكاتبة لم تكن التنبؤ بجائحة مدمّرة (لم يكن العالم قد أصيب بالكورونا وقتها) بل تستعين بتلك الفكرة لتبين أننا نعيش الآن نوعا من القيامة. فالقيامة في رأيها ليست وشيكة بل كامنة، والناس يعيشونها كل يوم، ولكنهم يتظاهرون بأنهم لا يرونها، وهو ما سبق أن تعرض له جوزي ساراماغو في رواية “العمى” حين صوّر وباء أصاب بلدا كاملا بفقدان البصر، باستثناء امرأة واحدة، ستحاول قيادتهم خارج تلك الظلمات.
في اختياره للأفلام القيامية ركز الكاتب على أفق جديد للزمن بهدف الخروج من نمط التاريخية الراهنيّة (أي التي لا تقيم وزنا إلا للحظة الراهنة)، من خلال أفلام مثل “مالنخوليا” للدانماركي لارس فون ترير، و”على الشاطئ” للأميركي ستانلي كرامر، و”آخر يوم على الأرض” للأميركي أبيل فيريرا، ليستخلص أن انتظار القيامة هو الذي يخلق المعنى، ما يسمح بنسج روابط صداقة وحب بين الأفراد وهم ينتظرون النهاية المحتومة، وتعويض صور الدمار والحدث الجلل بتجربة المهلة التي تسم كل فترة، كي تقطع تدفّق الزمن. هذه النظرة إلى زمن المهلة يُولّد وعدا بشيء آخر، بملاذ مثلا كما في “مالنخوليا” أو إمكانية علاقة عاطفية.
ما بعد الإنسان

إن الهوس بالسيناريوهات القيامية قد يجلب نوعا من النيهيلية، ورفضا معطّلا قد يلغي كل خلق سياسي، ففي حالة الاحتباس الحراري مثلا، عادة ما يعاب على الخطاب البيئي شعور بعجز يبدو محتوما وكارثيّا بالضرورة. وبدل أن يقابل أنجيليبير تلك الحتمية بتفاؤل ساذج، يستعيد مبدأ “طاقة اليأس” التي جاء بها الشاعر الفرنسي ميشيل دوغي، وكان دوغي قد أكّد أن الوعي الإيكولوجي يمكن أن يقود إلى التزام جديد في هذه الفانية، فلا يكون دور الأدب إنقاذنا من الأزمة البيئية، وتجاوزها، بل إعادة شروط الأدب بوصفه تمثّلا.
ولكي يبيّن أنجيليبير كيف تعمل تلك الطاقة، استحضر ثلاث روايات هي “الملائكة الصغار” لأنطوان فولودين، و”الطريق” لكورماك ماكارتي، و”آخر عالَم” لسيلين مينار. في كل رواية تكون نهاية العالَم منطلقا نحو عالَم آخر ممكن وغير ممكن، ففي رواية فولودين يظل الناجون من الكارثة هائمين في عالم معادٍ، غير أن الأثر لا يجنح إلى النيهيلية، بل يولّد طاقة خلق لساني، ويحلّل السلطة الأدبية للالتباس والمأزق السياسي للقيامة. وفي رأيه أن “التخييل هنا لا يفتح أبواب الأمل، حتى يمنح الحالم طاقة البقاء، وفي الأقل لا ينتزعها منه”.

القيامة ليست وشيكة بل كامنة والناس يعيشونها كل يوم، ولكنهم يتظاهرون بأنهم لا يرونها لذا يذكرهم بها الفن
ويلاحظ الكاتب أيضا أن تصوير العوالم البديلة بعد الحدث الكارثي يطغى عليه عنف شديد مروّع، ينبغي وضعه في سياق خروج ضروري ممّا بعد الحداثة، وفي سياق “كارثة حضارية” بعبارة الفيلسوف جان كلود نانسي، فأعمال العنف في بعض الروايات يمكن أن تزيل مجتمعات بحالها، خاضعة للتقدم ورأس المال، ما يسمح بإعادة تشكيل مجتمعات بشرية وغير بشرية.
من ذلك مثلا رواية “مالفيل” لروبير ميرل التي تخلق ظروف وضع طبيعي تحاول فيه مجموعة من الناجين خلق مجتمع تسوده المساواة، أو سلسلة “المُهمَلون” التلفزيونية التي تكشف عن مجتمع غير متسامح يتألف من مجموعات صغرى تحاول فيه كل واحدة أن تفسر الاختفاء الفجئي لعدد من البشر.
هذان المثالان اللذان يطرحان مسألة إعادة البناء الاجتماعي يظلان ملتصقين بمركزية الأنثروبوسين (المرحلة الجيولوجية الحالية)، بينما تسعى “آدم المجنون” إلى العمل التفاوضي والترجمي بين مختلف المجموعات الهجينة التي تضم البشر والحيوان والبيوتكنولوجيا، ما يعني أن أنموذج الذات البشرية المستقلة تترك مكانها للفكرة القائلة إن الحياة تنسجها بالضرورة روابط هشاشة وتكافل وتكامل.
في تحليله لما يمكن تسميته بـ”ما بعد الإنسان”، يؤكد أنجيليبير على استمرارية السرديات القيامية منذ نقد غرانفيل للتقدم وفلسفة الأنوار، وتقطّعاتها المتعددة في الوقت نفسه، ما يضعها خارج أي تاريخية بسيطة أو خطّيّة فهي، بما فيها من تنوع سياسي، ترفض الخطاب الذي يجعل من الأنثروبوسين ناتجا عن ميول كونية وتلقائية للأنثروبوس (أي الإنسان في مفهومه النوعي).
إن تلك السرديات هي في الواقع مقاومةٌ لميثولوجيا التقدم عبر نمو رأس المال، تسمح لنا بأن نتنزّل في السلبي كي نتخيل مستقبلا آخر، وهي إلى ذلك نقدٌ واعٍ لما يعيشه العالم اليوم، لكونها تفكك التصورات المعتادة. وبالرغم من أنها لا يمكن أن تنقذ البشرية من “الخطر الداهم”، فإن فضلها تنبيه الناس إلى أخذ رسائلها على محمل الجدّ.