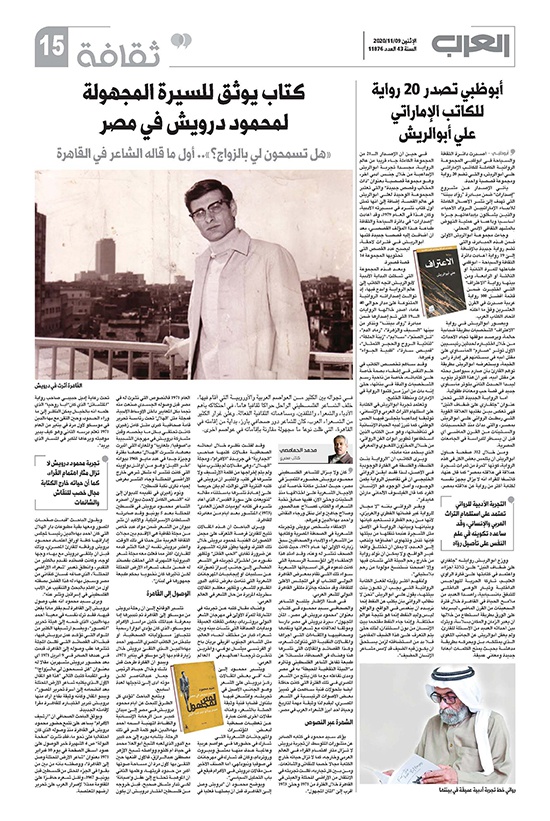قصّة حبّ مَدارُها المسرح والسينما والموسيقى

“لا نريد أن ننتهي مثل روميو وجولييت” مسرحية امتزجت فيها فنون شتى، وخاصة السينما والموسيقى، ولم تحتفظ من مسرحية شكسبير إلّا بلقاء فتى وفتاة، لتروي قصة حب معاصرة نسجت خيوطها بعيدا عن الأنظار.
بعد “دون كيخوته” و”الثلجة البيضاء”، أقبلت فرقة “لاكوردونوري” على أثر كلاسيكي آخر هو “روميو وجولييت” لشكسبير، وأضفت عليه عناصر من “الرجل الخفيّ” لهربرت جورج ويلز، لتعالجه بطريقة سينمائية موسيقية ليست غايتها الإبهار بقدر ما هي معالجة لثيمة التنافر الاجتماعي الذي قد يبلغ مبلغ العداء والعدوان، نتيجة أحكام مسبقة تعشّش في أذهان بعض الناس.
استوحى صامويل هركول وميتيلد فييرغان عملهما الجديد من مسرحية شكسبير إذن، ولكنهما لم يحتفظا بغير علاقة حبّ بين رجل وامرأة ما كان لهما أن يلتقيا، ولا أن يتحابّا.
في مدينة ما، في مكان ما، يعيش رجال ونساء هم كسائر البشر، ولكن خارج تلك المدينة، يوجد مجتمع مختلف، سكانه لامرئيون، أي أنهم لا يملكون مظهرا ماديا، بل يحملون كلهم نفس القناع.
في ما مضى، تقول الخرافة، كانوا يعيشون جنبا إلى جنب، ثم حدث شيء لا أحد يتذكّره، فانفصل كل فريق عن الآخر، واختار كل واحد أن يعيش بمعزل عن الطرف المقابل، وقد جسّد هذا الانفصالَ جسرٌ يفصل بين المجتمعين.
كانت رومي، وهي بطلة في كرة الصولجان تنتمي إلى المجتمع اللامرئي، تعتني بأبيها المريض، هذا الأب الذي لم يعد يشغله غير ندم وحيد: أنه ترك المدينة وجاء ليعيش في هذه الضاحية.
المسرحية تستعرض حكاية بصدد الإنجاز يُدعى المشاهد من خلالها إلى متابعة عملية الخلق والابتكار على الخشبة
بعد وفاته، حملت ابنته رومي رماد جثته لتنثرها في الجهة الأخرى، وفاء لرغبته في العودة إلى المدينة، فعبرت الجسر وجعلت تطوف في أرجاء المدينة تنثر رماد والدها، حتى التقت صدفة ببيير، وهو كاتب غريب الأطوار يعيش وحيدا في شقّة لا يقاسمه فيها غير قِطّه عطيل. وخلافا لرومي فهو من جنس المرئيين، أي أن له جسدا وملامحَ. وقع أحدهما في هوى الآخر. ومنذ تلك اللحظة، نشأت بينهما علاقة عشق، غيّرت حياتهما.
إن الجسر الذي يقسم المدينة إلى جهتين، جهة يعيش فيها بشر واقعيون عيشة الناس المعتادة، وجهة يسكنها بشر لا يُرَون بالعين المجردة، هو حاجز استعاري بطبيعة الحال، غايته الإشارة إلى الحواجز التي تفرّق المجتمعات، وحتى المجتمع الواحد، لكونها حواجز ذهنية قبل كلّ شيء، ولكنها تتبدى أكثر صلابة من الحواجز المادية والأسلاك الشائكة.
وما حصل بين الشابين فيه اجتياز للحدود الممنوعة، وخرق للقوانين السائدة، وهتك للمحظور الذي تفرضه التقاليد، لأن الحب بطبعه متمرّد، يكسر القيود ويرفض الخضوع، ويتحدّى حتى النيران المندلعة.
هما كائنان، ما كان لهما أن يلتقيا، ولا أن يعشق أحدهما الآخر، ولا أن يتحدّيا وحيدين نظاما يلغي الآخر ويقصيه، ولكن بلقائهما وانصهار روحيهما سوف يزعزعان الأحكام المسبقة والمعتقدات التي جعلتهما، مثلما جعل مجتمعيهما، متنافرين يرفض كلاهما الآخر. هكذا، دون أن يعلم أحد السبب.
وعلى غرار التراجيديا الشكسبيرية، تروي هذه القصة أيضا مصير كائنين، يحيدان عن خط حياتهما المستقيم، ليسيرا معا في طريق مشترك، قيل لهما إنه محظور. وبتحدّيهما للمحظورات، أمكن لهما أن يعيشا قصة حبّ عميقة، حتى وإن زعزعا النظام القائم وحطّما الحاجز الذي يفصل بينهما، كما تفصل المعتقدات التي انبنى عليها.

المسرحية يمكن أن تقرأ كحكاية فانتازية ذات محمل سياسي، فالمجتمع اللامرئي يرمز للأقليات المنبوذة في الغالب، تلك التي تقصى بألف وسيلة من المشهد العام، وتُبعَد إلى الضواحي الفقيرة، المهملة والمنسية، ثم ترفض المدينة أن تفتح حضنها لأفرادها، لمجرد أنهم مختلفون، يوصمون بالظنون بسبب لونهم أو اسمهم أو عرقهم. فهي تطرح قضية غمط حقوق الأقليات والمهمشين، وفي ذلك إدانة للمجتمع الذي يهمش الأفراد ويلغيهم ويخمد أصواتهم، بل يخلع عنهم إنسانيتهم.
وباقتفاء أثر رومي وبيير وصراعهما ضد شتى أنواع المخاوف تدعو المسرحية مشاهديها إلى التساؤل: ما الذي يبني الإحساس بالانتماء إلى مجموعة، إلى مجتمع؟ كيف نجد القوة اللازمة للخروج من النماذج المهيمنة؟ إلى أي حدّ يمكن أن يتخلى الفرد عن صورته الآدمية؟ ما هي مفاهيم السوية والإقصاء، والحرية والخضوع؟
ويمكن أيضا أن تقرأ كأنشودة تتغنى بالارتحال والحلم بأجواء وفضاءات أخرى، وتدين الامتثال والخضوع، لاسيما أنها معروضة للصغار والكبار. هي أنشودة بين الحلم والميتافيزيقا، تستحوذ على اهتمام الحاضرين منذ الكلمات والمشاهد الأولى بفضل أداء الممثلين، والإخراج الفني الذي يضع المتفرّج في موقع من يشاهد الفن السينمائي وهو يتشكل صوتا وصورة.
ذلك أن الإخراج اعتمد في سرد هذه الحكاية على الجمع بين المسرح والسينما والموسيقى والمؤثرات الصوتية، فالتوضيب الصوتي يتمّ أمام المشاهدين، وكذلك الصور الملتقطة التي تبث على شاشة عملاقة، فيبدو الحوار مباشرا بين الممثلين على الخشبة وبين زملائهم على الشاشة، أي أنها حكاية بصدد الإنجاز يدعى المشاهد من خلالها إلى متابعة عملية الخلق والابتكار. وكأنها دعوةٌ إلى الجمع بين عالم المرئيين وعالم اللامرئيين، ونداءٌ خافت لكسر الحواجز التي تعزل فئات مجتمعية بعضها عن بعض بذرائع واهية.