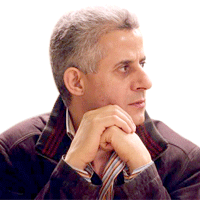طه حسين الشاعر صفحة مطوية في تاريخ عميد الأدب العربي

أورد محمد قابيل اسم طه حسين في “موسوعة الغناء في مصر” عام 2006، وسجل أن لعميد الأدب العربي تجربة وحيدة في كتابة أغنية عنوانها “لولاك”، لحّنها كامل الخلعي وغنتها سلطانة الطرب منيرة المهدية في إحدى مسرحياتها. ولم يذكر اسم المسرحية أو تاريخ عرضها، وإن أورد نص الأغنية، وهي بالعامية المصرية، وسجلها الخلعي بصوته، بعد ذلك، على أسطوانة أنتجتها شركة “فونوغراف”، ويقول مطلعها:
أنا لولاك.. كنت ملاك.. غير مسموح.. أهوى سواك
سامحني
في العشاق.. أنا مشتاق.. أبكي وأنوح.. بالأشواق
جاوبني
إذا وضعنا للقرن العشرين في مصر عنوانا أول، فيمكن أن يكون قرن طه حسين. وفقا لهذا الافتراض يسهل أن يقال “ما قبل” و”ما بعد” طه حسين، ذلك الطالب العصامي الذي تحدى بموهبته الطاغية الفقر والعمى وصدأ معرفيا راكمته القرون، وتمكن بكتابه “في الشعر الجاهلي” في العام 1926 من تغيير مجرى البحث الأدبي والتاريخي، ومهد الدرب لباحثين ونقاد أعفوا من معارك خاضها، وهو أعزل إلا من ثقته بمنهجه واعتداده بنفسه، في مواجهة جمود اليمين الديني، وتوازنات الساسة وفي مقدمتهم سعد زغلول الذي تملق لطلاب الأزهر، وزايد على غضبهم قائلا إن طه حسين ليس إلا “رجلا مجنونا يهذي في الطريق فهل يغير العقلاء شيئا من ذلك؟… فليشك ما شاء، ماذا علينا إذا لم يفهم البقر؟!”. ثم خرج طه حسين من المعركة منتصرا، نصر لا يخلو من جراح. ولكن لطه حسين وجه آخر، أو ربما وجوه أقرب إلى طبقات لجيولوجيا نفسية ومعرفية، حيث كان وجه الشاعر عنده سابقا على الصرامة المنهجية للرجل. في كتاب “طه حسين الشاعر الكاتب” الذي نشر عام 1963 يقول مؤلفه محمد سيد كيلاني إن طه حسين بدأ حياته الأدبية شاعرا، إذ رثى أخاه الذي توفي عام 1902، وكتب في سيرته “الأيام” أنه كان يختم كل قصيدة “بالصلاة على النبي، واهبا ثواب هذه الصلاة إلى أخيه”، ولم يدون ذلك الشعر الذي رافقه في رحلته من محافظة المنيا إلى القاهرة
وقال أحمد حسن الزيات في حفل تكريم طه حسين، بمناسبة حصوله على الدكتوراه من الجامعة المصرية عام 1914، إن الشيخ سيد علي المرصفي كلّف تلاميذه في الأزهر بالكتابة نثرا أو شعرا في إحدى القضايا، وتوقع رفاق طه حسين تفوّقه عليهم في الحفظ لا الكتابة، ولكنه فاجأهم “بقصيدة حماسية الموضوع، جاهلية الأسلوب، تمثل ما انطبع في خاطره من صور الشعر القديم.. سمعنا تلك القصيدة فازدرينا أنفسنا، وسترنا ما قلنا، وشعرنا بالضعف أمام تلك القوة النادرة”. وضاعت تلك القصيدة، كما يقول كيلاني؛ لأن الشاعر الشاب لم يكن على صلة بالصحف، أما أولى قصائده فنشرتها صحيفة “الجريدة” في 1 أغسطس 1908، وهي قصيدة موجّهة، عبء على الشعر، وربما إدانة للشاعر الذي أنقذه ذكاؤه بالهروب من معسكر مناوئ للروح الوطنية في بلد يعاني وطأة الاحتلال.
كانت “الجريدة” لسان حال حزب الأمة تنتهج الاعتدال في ما لا يصح فيه إلا الغضب والثورة، بعد جريمة دنشواي التي عبرت أصداؤها حدود مصر، وأدت إلى إنهاء عمل اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني المشهور بقبضته القوية، منذ أوفدته بلاده إلى القاهرة عقب احتلال مصر عام 1882. وجرى في يونيو 1906 حادث دنشواي الذي اتهم فيه 52 فلاحا بالقتل العمد لضابط إنكليزي توفي بضربة شمس.
وتشكلت محكمة برئاسة بطرس غالي وزير الحقانية بالإنابة، وشارك في عضويتها أحمد فتحي زغلول شقيق سعد زغلول. وتراوحت الأحكام بين الإعدام شنقا لأربعة، والأشغال الشاقة لفترات مختلفة والجلد للباقين. وأجبر كرومر على الاستقالة، وفي أبريل 1907 أقامت الحكومة المصرية بدار الأوبرا حفل وداع للرجل الذي كان يحكم مصر فعليا. وفي حين دعا الحزب الوطني إلى مقاطعة الحفل، كتب أحمد لطفي السيد في “الجريدة” في 30 أبريل 1907 مقالا عنوانه “المسالمة لا المعاندة ـ في وداع اللورد كرومر”.
وقضا التاريخ بأحكام أخرى خارج قاعات المحاكم، إذ وافق رئيس الوزراء بطرس غالي على مشروع تمديد امتياز شركة قناة السويس 40 سنة أخرى، لتنتهي عام 2008 بدلا من عام 1968. وظل المشروع سرا قرابة سنة، ثم توصل الزعيم محمد فريد إلى نسخة منه، ونشرها فى أكتوبر 1909 في صحيفة “اللواء” لسان حال الحزب الوطني الذي شن حملة لتعبئة الرأي العام ضد المشروع. وعزم الشاب إبراهيم الورداني (1886 – 1910)، العائد من دراسة الصيدلة في سويسرا وبريطانيا، على قتل رئيس الوزراء “الخائن”. واستطاع الورداني أن يغتال غالي في 20 فبراير 1910، وحكم عليه في 18 مايو بالإعدام. ويوم إعدامه في 28 يونيو 1910 ودعته “ملكة الأسطوانات” الست نعيمة المصرية بأغنية “قولوا لعين الشمس ما تحماشي، أحسن غزال البر صابح ماشي”.
في هذا السياق العاصف، أعلن طه حسين انحيازه السياسي والأدبي، بقصائد منظومة تعوزها روح الشعر، ويقترب بعضها من البيانات الخطابية، والبيانات بطبعها سهام حماسية موجهة لا تستتر بالاستعارة ولا تتوسل بالمجاز. وأدى الإعلان عن الانتصار لتيار إلى صمت “الشاعر” عن نظم قصائد في مواقف أخرى. هذا ما يرصده كتاب “طه حسين الشاعر الكاتب” الذي صدر في حياة طه حسين، ويوثق المرحلة المبكرة في مسيرة شاب طموح، سيكبر ويستوي وعيه وتنضج خياراته وعناده، ويصير اسمه طه حسين.
أولى قصائد طه حسين نشرتها “الجريدة” في 1 يناير 1908، في رثاء وكيل حزب الأمة، المعتدل تجاه دولة الاحتلال، حسن باشا عبدالرازق والد الشيخين مصطفى وعلي عبدالرازق. في ذلك الوقت كان خصوم الحزب الوطني يطلقون عليه “حزب الطيش”، ويتهمون زعيمه مصطفى كامل بأنه “الفتى الطائش”. ومن قاعدة الانتماء إلى حزب الأمة سخر طه حسين من الحزب الوطني وردد مزاعم يلصقها حزب الأمة بالحزب الوطني:
ومن يدّعي بالطيْش نصرة قومه
ورائده الأهواء أنّى تيمما
ويقول المؤلف “وكانت النتيجة الطبيعية لموقف طه حسين السياسي في هذه الفترة أنه أغفل موت الزعيم الوطني مصطفى كامل إغفالا تاما، فلم يقل في رثائه شيئا، لا شعرا ولا نثرا. إن موت مصطفى كامل الذي هز البلاد من أقصاها إلى أدناها، وأبكى المصريين أجمعين لم يحرك خاطر طه حسين بكلمة واحدة!”. ولم يتأخر طه حسين عن الانضمام إلى الحزب الوطني، وهو ما يفسره المؤلف بتغير سياسة بريطانيا مع تولي السير إلدون جورست خلفا لكرومر، إذ وثق المندوب السامي الجديد علاقاته بالخديو عباس حلمي، وفقد حزب الأمة أهميته، ووجد طه حسين في رواج صحف الحزب الوطني إغراء، “فالكتابة في هذه الصحف تضمن له الشهرة التي كان يتوق إليها منذ صباه”، وقد أخلص في انضمامه إلى الحزب الوطني، وتمسك بمبادئه حتى سفره إلى فرنسا عام 1914.
وفي 23 نوفمبر 1909 نشر طه حسين أولى قصائده في مرحلته الجديدة، في صحيفة “مصر الفتاة”، مهنئا الشيخ عبدالعزيز جاويش بالخروج من السجن. وكان جاويش رئيس تحرير “اللواء”، وفيها كتب يوم 28 مايو 1908 مقالا عنوانه “دنشواي أخرى في السودان”، وحوكم بسببه ثم نال البراءة في الاستئناف. وفي الذكرى السنوية لحادث دنشواي نشر في “اللواء” مقالا يندد ببطرس غالي رئيس المحكمة وفتحي زغلول عضو المحكمة. وتسبب المقال في سجنه ثلاثة أشهر. وفي عام 1910 سجن جاويش ومحمد فريد لكتابتهما مقدمتين لديوان “وطنيتي” للشيخ علي الغاياتي. وقد صودر ديوان الشعر، وهرب صاحبه إلى الأستانة وجنيف. ويبدأ طه حسين قصيدته متوجها إلى جاويش:

الآن حق لك الثناء/ فلتحي وليحي اللواء
ولتحي مصر وأهلها/ شاء العدى أو لم يشاءوا
ومما جاء في القصيدة:
إن كان ذكرك للجلاء يسوء فليكن الجلاء
أو كان صوت الشعب عندهمو هو الداء العياء
فليعل صوت الشعب حتى يرجعوا من حيث جاءوا
بانضمام طه حسين إلى الحزب الوطني اقترب من الشعب، وعبر عن أشواقه إلى الاستقلال واستعجال الجلاء، وترك هذا الانحياز أثرا في شعره السياسي، ففي قصيدته “هم جائش” رفض مشروع مد امتياز شركة قناة السويس، حين عرضته حكومة بطرس غالي على مجلس الشورى. ويخاطب الإنكليز في مطلع القصيدة:
تيمموا غير وادي النيل وانتجعوا
فليس في مصر للأطماع متسع
كفوا مطامعكم عنا، أليس لكم
مما جنيتم وما تجنونه شبع؟
وحتى في المناسبات الدينية لم تغب قضية الاستقلال عن شعره السياسي، ففي الاحتفال بالعام الهجري 1329 ألقى قصيدة ونشرها في مجلة “الهداية”، وتبدأ بهذا البيت:
كن أنت بعد أخيك خير هلال
وأضئ لمصر سبيل الاستقلال
ويلاحظ المؤلف أن الشاعر الشاب “لم يكن متطرفا يدعو إلى الثورة ويستعذب الموت في سبيل الوطن”، بل ينشد الإصلاح، وينتهج الدعوة السلمية:
اطلبوا الدستور يا قومي ونادوا بالجلاء
والزموا السلم فإن النصر للحق المبين
ويعلق على قصائد طه حسين السياسية آنذاك قائلا إن “شعره السياسي يدل على نفسية مضطربة، فقد كان طالبا في الجامعة، ومن المؤكد أنه خشي أن يتهم بالتحريض على الثورة فيفصل من الجامعة، أو يحدث له ما حدث لعبدالعزيز جاويش”، ولا ينسى الإشارة إلى ظروفه الخاصة التي تجعل من السجن فكرة مرعبة، وربما لهذه الأسباب توقف عن نظم الشعر السياسي في نهاية عام 1910. وقد عبر عن مخاوفه بقوله:
إني لأكتمك الحديث تحفظا
وأرى السكوت على الأذى أولى لي
فلقد تكون قصيدتي كوسيلة
بيني وبين السجن والأغلال
تنوعت آنذاك هموم طه حسين، فتناول قضية المرأة، وربط بين رقي الأمم وتعليم النساء:
نرجو الرقي، وكيف ترقى أمة/ سلكت سبيل التيه والإضلال؟
عبثت بحق الأمهات وأغفلت/ أمر الأمومة أيما إغفال
ساد الذين عنوا بأمر نسائهم/ وسموا بهن إلى مكان عال

ولكن طه حسين الشاب لم يكن متجهما يلتمس الجدية في السياسة والإصلاح الاجتماعي، بل كان يكتب في الغزل، شعرا ونثرا، ففي 31 يوليو 1911 نشر في “الجريدة” مقالا عنوانه “الذوق والجمهور” تناول فيه تردده على الملاهي، “وقد يكون هذا التصريح خطرا جدا، فإن الجمهور لا يقبل من كاتب مثلي أن يزج بنفسه بين صفوف المراقص وأندية الغناء، بل إن أسرتي نفسها قد تنكر علي ذلك أشد الإنكار.. وقد ألوم نفسي أيضا، بل قد لمتها من غير شك أشد اللوم”.
ويرى المؤلف أن تردد طه حسين على محال الرقص والغناء “أثر في شعره إلى حد بعيد”، ومنحه الكثير من العذوبة، كما في قصيدة عنوانها “آه لو عدل”:
شادن عطف/ عطفه الحبيب
بعد أن صدف/ صدفه الملول
كم سبى العقول/ قوله الخلوب
يملك القلوب/ ثم لا ينيل
إلا أنه يقول إن شعر طه حسين الغزلي “يمثل نفسية مضطربة، ليست مستقرة على حال واحدة”، ففي قصيدة عنوانها “الفجور بعد العفة”، المنشورة في مصر الفتاة في 27 نوفمبر 1909، اعتراف بأن الحب أصابه منذ الصغر وآلمه. وفي قصيدة أخرى يقول إنه يهيم بالجمال إلى درجة الجنون، ولولا كف بصره لسار على درب أبي نواس “أنا لولا سوء حظي/ لم أكن إلا ابن هانئ”. ولكنه في 7 نوفمبر 1910 كتب في “الجريدة” مقالا عنوانه “الحب” قال فيه إن “حياتنا الدائمة رهينة بالتناسل.. ولا أضرب مع الشعراء وكتاب الخيال بسهم في ما ذهبوا إليه من فنون الغرام”. وفي 28 أغسطس 1908 نشر في مصر الفتاة قصيدة “حديث مع النيل”، وفيها يتخذ هيئة رجل الدين، داعيا إلى الرجوع إلى الله لكي تنصلح أمور البلاد:
ندع الكافرين بالله لكن/ هل لدى المسلمين منا عذير؟
تلك بعض وجوه طه حسين الذي ودّع الشعر قبل سفره إلى فرنسا في العام 1914، وعاد عام 1919 مدرسا للتاريخ القديم بكلية الآداب، وشغلته الدراسات والسير، وهجره الشعر، وحسنا فعل. وانتقل من حزب إلى آخر، ثم كان أول من أطلق على ما جرى في مصر ليلة 23 يوليو 1952 “ثورة”، بعد أقل من أسبوعين.
أما محمد سيد كيلاني (1912 – 1998) فعاش راهبا، واستبدل بالزواج عكوفه على تحقيق الكتب التراثية، وكتابة مؤلفات مهمة، “إشباعا لشهوة نفسية عارمة”، كما قال في مقدمة هذا الكتاب.