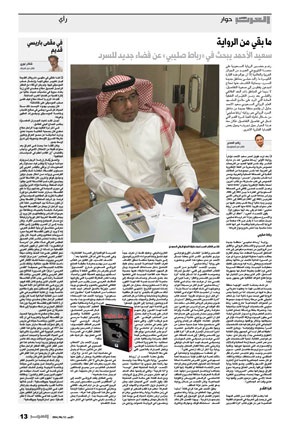شاهندة مقلد رفيقة غيفارا وسارتر غيابها يفضح غياب اليسار

القاهرة - “اتقي الله في كل كبيرة وصغيرة، ولا تفعلي سرًا ما تخشينه علنًا ودافعي عن رأيك حتى الموت” كلمات بسيطة يوصي بها عادة الآباء الأبناء، لكن المناضلة المصرية الراحلة شاهندة مقلد حوّلت نصيحة والدها ضابط الشرطة إلى منهج عمل التزمت به طوال حياتها قبل أن ترحل عن دنيانا الأسبوع الماضي.
الناظر إلى حياة مقلد وتطورها، لا يملك سوى أن يتوقف أمامها بمشاعر تحمل خليطا من الإعجاب والدهشة، فهي سارت على خطى المناضل الهندي الأشهر غاندي في تحويل كل مناسبة للانكسار في حياتها إلى نقطة للانطلاق نحو أفق جديد تتجاوز فيه ما حققته من نجاح فيما سبقه.
بداية الدهشة تعود إلى زمن ضارب في القدم، وتحديدا منذ سنوات تشكل وعيها الأولى، فرغم أن والدها الذي مثّل النموذج الكامل لما يجب أن تكون عليه، كان يميل نحو حزب الوفد الذي كان وقتها يعد حزب الشعب المعبّر عن آماله ومعاناته، لكن الطفلة الصغيرة قادها وعيها السياسي الغض نحو الطرف القصيّ، وتحديدا الاشتراكية الاجتماعية، كما وصفها كارل ماركس في كتابه “رأس المال” والتي تعني معاداة الإقطاع والالتحام مع الطبقات الدنيا من الشعب.
“يا شاهندة وخبرينا يا أمّ الصوت الحزين. يا أم العيون جناين يرمح فيها الهجين. إيش لون سجن القناطر وإيش لون السجانين. وإيش لون الصحبة معاكي نوار البساتين؟” بهذه الأبيات من العامية المصرية اختار الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم أن يعلن تضامنه مع أيقونة النضال العمالي بعدما عوقبت بالسجن في فترة حكم الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
كلمات نجم الذي كان أحد أشرس المعارضين في الوسط الثقافي والفني للسادات في سبعينات القرن الماضي، لخصت كيف كان اليسار المصري ينظر إلى شاهندة مقلد، باعتبارها رمزا من رموز الحركة الوطنية المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
اشتراكية مبكرة
الكثير من الكتابات خلصت إلى أن مقلد بدأت علاقتها بالأفكار الاشتراكية في مرحلة الإعدادية بفضل معلمتها وداد متري التي أعطتها كتاب إنجلز الشهير “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة” الذي يعدّ من الكتب المقدسة لدى قطاع من الماركسيين.
ذهبت كتابات أخرى إلى إسناد الفضل لزوجها الراحل صلاح حسين في توجهها الاشتراكي بالنظر لتاريخه الكبير في النضال، بداية من التطوع في حرب تحرير فلسطين عام 1948 وحتى قيادته فلاحي قرية كمشيش بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة) ضد سطوة الإقطاع.
لكن القراءة المتأنية في سيرة حياتها تدفع للاعتقاد بأنها تلقت تعاليم الاشتراكية الأولى من والدها ضابط الشرطة الوطني الذي ضحّى بحياة الرفاهية التي توفّرها وظيفته لعائلته ويتنقل مع أسرته الصغيرة من قرية إلى أخرى.
كانت أبرز صفتين في الأب ورثتهما ابنته انحيازه الواضح إلى جانب البسطاء والفقراء، لدرجة أنه خلال أحداث كمشيش الأولى في العام التالي لثورة يوليو 1952، رفض قرار مجلس قيادة الثورة بالقبض على عدد كبير من الفلاحين وأرسل للبكباشي جمال عبدالناصر خطابا قال فيه “إما أن تفرجوا عن المعتقلين أو تعتقلوني معهم”.
ذكرت شاهندة في مذكّراتها أنها كانت تلاحظ وهي صغيرة أنه عندما تندلع أيّ مظاهرة يقوم والدها برفع سماعة هاتف المنزل لكي يبقى الخط مشغولا، حتى لا يتلقّى أوامر حكومية بفض المظاهرة لكونه مأمور المركز وممثل الدولة في قريته.
"يا شاهندة وخبرينا يا أم الصوت الحزين. يا أم العيون جناين يرمح فيها الهجين. إيش لون سجن القناطر وإيش لون السجانين. وإيش لون الصحبة معاكي نوار البساتين؟" أبيات عامية لا يتوقف المصريون عن تردادها، اختار الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم أن يعلن بها تضامنه مع سيدة النضال العمالي بعد سجنها أيام السادات
لهذا لم يكن الانحياز للفقراء خطوة مفاجئة للفتاة العنيدة وإنما يمكن القول إنها بلورت ما تربت عليه في بيت والدها، حيث تحوّلت بعد زواجها من ابن عمتها صلاح حسين إلى مرحلة التنفيذ بعدما ظلت لفترة تدور داخل الإطار التنظيري للفكر الاشتراكي.
بعد الاغتيال
قصة كفاح شاهندة مقلد وزوجها الراحل تحمل مقومات النقاء الثوري كما وصفه عدد من منظّري الاشتراكية في بداية القرن الماضي، فقد نذرا حياتهما للدفاع عن البسطاء والمهمشين دون مقابل.
في وقت نجح فيه الزوجان الشابان في تحويل قريتهما الهامشية كمشيش إلى حركة مقاومة نموذجية من الفلاحين ضد الإقطاع لم ينتظرا أن يحصدا ما زرعاه.
الزوج لقي حتفه مقتولا على يد مأجورين من الإقطاعيين الذين عاداهم طوال حياته في منتصف ستينات القرن الماضي وتحديدا عام 1966، تاركا زوجته الشابة مع 3 أطفال ومسكن متواضع.
شاهندة نفسها لم تتربّح من زعامتها للحركة الفلاحية طوال ستينات القرن العشرين، ولا من علاقتها التي توطّدت بعد مقتل زوجها بكبار المسؤولين في الدولة ورموز التحرر في العالم مثل جيفارا وجان بول سارتر.
لم تسع للاستفادة من عضويتها في البرلمان المصري ممثلة للفلاحين مثلما فعل العشرات من النواب الذين تسللوا إليه من باب الدفاع عن العمال والفلاحين، ثم أداروا لهم ظهورهم ليتحولوا إلى ممثلين للإقطاعيين وليس للفلاحين داخل مجلس النواب.
نفس النقاء الثوري تبلور بقوة في إقدامها على تجميد عضويتها “ضمنيا” في حزب التجمع اليساري الذي كانت من بين مؤسسيه وقياداته في محافظة المنوفية عندما رأت ضعف تأثيره في الشارع، وتفرغ قياداته للتنظير مقابل التخلّي عن العمل وسط الناس.
كذلك لم تسع للاستفادة من مواقفها المؤيدة للقوات المسلحة مثل كثيرين غيرها، خاصة في الفترة الحرجة التي تلت ثورة يناير 2011، والتي استعانت فيها المؤسسة العسكرية بعدد كبير من المقربين منها لشغل مناصب هامة في الدولة.
على العكس انزوت مقلد عملا بالحكمة التي تقول “وأعفّ عند المغنم” معتبرة أن دفاعها عن المؤسسة العسكرية نابع من ثقتها في وطنيّتها وليس مطروحا في مزاد.
حتى اختيارها لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب ثورة 30 يونيو 2013 الذي لم تسع إليه رغم دورها المقدر في معارضة حكم الإخوان المسلمين، حوّلته من وجاهة اجتماعية يكتفي بها أغلب أعضاء المجلس إلى ممارسة حقيقية على الأرض من خلال زيارة السجون ولقاء المسجونين حتى المختلفين معها في التوجهات السياسية.
إذا كانت هناك عبارة واحدة يمكن أن تلخص حياة شاهندة مقلد فهي “مسيرة الأحزان” حيث يندر رصد أحداث سعيدة في الحياة الشخصية للمناضلة العتيدة التي لم تستسلم يوما للحزن، لذلك لم يفارق اللون الأسود حياتها تقريبا.
|
فاجعتها الأولى تلقتها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها برحيل أبيها المفاجئ عن الدنيا، لتفقد سندها الرئيسي في الحياة، ومعه فقدت الزهوّ بكونها “بنت البيه المأمور” لتواجه الحياة بمفردها.
ورغم صغر سنّها وحداثة خبراتها بالحياة لم تنثن شاهندة أمام جسامة الخسارة، ولا فداحة تداعياتها الحياتية، وإنّما قررت الاعتماد على نفسها والاكتفاء بالشهادة الإعدادية التي كانت قد حصلت عليها لتوها.
بعد ذلك تلقت فاجعتها الثانية التي توقع كثيرون أن تكون قاضية بفقدان الزوج والمعلّم والسند صلاح حسين مقتولا، قبل أن تكمل عامها السابع والعشرين أو أن تكمل أصغر بناتها الأربعين يوما.
لكن الجميع فوجئوا بأنها تقود مظاهرة متكونة من الفلاحين للاعتراض على السلطة التي قررت منع دفن جثمان الزوج في مقابر القرية خوفا من أن تتحول إلى بؤرة ثورية، وعندما نجحت في الحصول على مرادها تقدمت مشيّعي الزوج بدلا من أن تسلك سلوك النساء المعتاد بالبقاء في المنزل والبكاء على حالها.
في السنوات التالية حلت محل زوجها الراحل في قيادة نضال الفلاحين ما قادها إلى لقاءات متعددة مع كبار المسؤولين في الدولة، بداية من رئيس الجمهورية وقتها جمال عبدالناصر، فضلا عن لقاء المناضل العالمي جيفارا والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر.
حسب قوانين ألعاب الورق التي ترفع سقف التحدي كلما نجح أحد المتحدين في بلوغ السقف الحالي، واصلت الدنيا لعب الورق مع مقلد لتضيف المزيد من المآسي إلى حياتها كلما نجحت في تجاوز واحدة.
في بدايات عام 1970 الذي شهد زهوة نضالها الثوري عقب نجاحها في حشد الدولة بكاملها للتصدي للإقطاع الذي يهدد مصداقية عبدالناصر وشرعية حكمه القائم على العدالة الاجتماعية، كانت مقلد قد تلقت فاجعتها الثالثة باستشهاد شقيقها الذي كان قد التحق بالقوات المسلحة وعمل طيارا عسكريا، حيث لقي ربه في إحدى الطلعات الجوية خلال حرب الاستنزاف ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في سيناء وقت أن كانت محتلة.
ثم جاءت الفاجعة الرابعة لتكون الختام المثالي للأحزان بوفاة ابنها الثاني (أنجبت ولدين وبنتا واحدة) في ظروف غامضة بالعاصمة الروسية موسكو، حيث كان يدرس هناك في نهاية السبعينات من القرن الماضي.
علاقات ملتبسة
على الرغم من الحالة النضالية المستمرة لشاهندة مقلد وانحيازاتها الاجتماعية الواضحة التي كلفتها عداء ضاريا مع رئيس مصر الراحل أنور السادات، اكتست علاقتها بتيار الإسلام السياسي بإطار لافت من الالتباس.
لا أحد ينسى واقعتها الشهيرة أيّام حكم الإخوان حين خرجت في مظاهرة أمام قصر الاتحادية ضد الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره محمد مرسي في ديسمبر 2012، وتعرضت وقتها لاعتداء باليد من شاب إخواني حاول إسكاتها بوضع يده بالقوة على فمها، وهي واقعة أذكت نيران الغضب ضد الإخوان الذين تجاهلوا التاريخ النضالي الطويل لشاهندة، مثلما تجاهل الشاب سنّها الكبير وسمح لنفسه بالاعتداء عليها.
لكن هذا العداء لم يكن له ما يبرره من الناحية الأيديولوجية على الأقل، خاصة أن مقلد نفسها ذكرت في تصريحات متلفزة لها حين كانت تدافع عن قريتها من تهم الشيوعية التي ألصقت بها في فترة حكم السادات أن القرية في الأساس كانت إخوانا مسلمين.
|
كما أنها رحبت بقوة باغتيال السادات، وهو أمر قد يكون مفهوما قياسا على شراسة العداء بينهما، لكن غير المفهوم هو أن تشيد بقاتله خالد الإسلامبولي المنتمي لتيار الإسلام السياسي، حيث قالت “شعرت أنه حرر مصر بالكامل من خيانة السادات” المتمثلة بحسب وجهة نظرها في توقيع معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل.
أما عداء مقلد للسادات فيمكن أن يكتسب صفة التاريخية، لأنه سبق وصوله إلى الحكم بسنوات طويلة وما حدث وقتها من نفيها مع عدد من رموز النضال الفلاحي ضد الإقطاع، ثم سجنها مرتين خلال فترة حكمه.
بدأ العداء عام 1953 أي بعد عام واحد من ثورة يوليو حين تم تكليف السادات بتسوية أزمة كمشيش الأولى، فانحاز الرجل على غير توقع إلى الإقطاعيين بحسب ما ذكرت شاهندة مقلد في أكثر من مناسبة.
كان الانحياز مفاجئا لمقلّد وكثيرين غيرها من رجل يفترض أنه يمثل ثورة يوليو بميولها المعلنة ناحية الفقراء والمهمشين، لهذا نشأت بين الطرفين عداوة زادت وتبلورت مع السنوات، لم يخفف منها أن المناضلة دعيت لتناول الغداء في منزل السادات في قرية ميت أبوالكوم المجاورة لقريتها عقب وفاة زوجها. لكنها نسبت الفضل في تلك الدعوة لجمال عبدالناصر الذي كان يتناول الغداء في منزل السادات مع المناضل العالمي جيفارا.
وفي المقابل فسرت تراجع عبدالناصر عن نصرة الفلاحين في معاركهم مع الإقطاع لتأثير السادات عليه.
أما تعاطفها المعلن مع القوات المسلحة فيمكن إعادته إلى ارتباطها بشقيقها الطيار الحربي الذي فقدته بالاستشهاد في حرب الاستنزاف، كذلك إلى إيمانها الكبير بالدور الوطني للجيش، الذي دفعها لقيادة كتيبة من الفلاحين ذهبت إلى بورسعيد للمشاركة في النضال الشعبي ضد القوات الإسرائيلية.
هو الإيمان نفسه الذي قادها للدفاع عن الجيش في أزمة ما يسمى بـ”كشوف العذرية” التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، وهو ما ساهم بقوة في حصار حملة الهجوم النسائي على القوات المسلحة.
أزمة اليسار
اليسار المصري اليوم يعاني عصفاً من الأزمات الفكرية. ويقول المراقبون إن حزب التجمع يمثل اليسار التقليدي. أما الاشتراكيون الثوريون فيعانون من إشكال العلاقة مع النظام والتعاطف مع الإسلاميين.
الناصريون مؤمنون بالدولة، ويخلطون بينها وبين الحكم. ويحافظون على مسافة مع الأطراف. اليسار غير موجود في الشارع وغير مؤثر في مجريات الأمور، حتى أن موضوعه الرئيسي يشهد غيابا كبيرا له فيه، ألا وهو قطاع المناطق الشعبية والعمال والفلاحين.
وترى الباحثة ريهام مقبل من المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أن اللافت للنظر أن اليسار لم يحضّر مشروعا للتغيير الاجتماعي، بل جعل السياسة أداة من أدوات التغيير الاجتماعي لا بديلاً لها. مضيفة أن عزلة اليسار فرضها اليسار على نفسه بنفسه، خاصةً في إطار غياب وسائل الاتصال الرئيسية لأيّ حزب سياسي ناجح وفعال، وهي: القنوات التلفزيونية والجرائد والنقابات العمالية؛ فبعض الأحزاب لا تمتلك جرائد، وضعيفة في الحركة النقابية العمالية. ويرجع البعض أزمة اليسار إلى تداعيات سقوط النموذج السوفييتي والمنظومة الاشتراكية في العالم. حيث لم تستفق الأحزاب اليسارية العربية من تلك الصدمة بعد.