رسائل من الحرب العالمية الأولى: الحرب تخرج أفضل وأسوأ صفات الإنسان

غاب عن الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى اسم هذا الرجل، كونينجسبي داوسون، الذي ترك مكتبه وأوراقه ليخوض المعارك. ووسط هدير المدافع، حرّضه الشاعر والكاتب في داخله على كتابة اكتسبت شفافية وعمقا إنسانيا. وظل حريصا على أن يرسل إلى ذويه، من جبهة القتال، رسائل لا يستهدف نشرها، فهي تأملات إنسان يعيد اكتشاف ذاته في مسافة تتسع أو تضيق بين الحياة والموت، ولم يكن لديه ترف “تطوير” مشاعره التلقائية، أو إعادة الكتابة؛ فأمام الخطر يكتسب الكلام العفوي صدقا مضاعفا، حتى لو كان عزاء شخصيا لشاب لا تمثل له الكتابة ترفا، وقد عاتبه أهله ذات مرة على انقطاع رسائله، فأرسل إليهم متسائلا: كيف أكتب إليكم رسائل حب، ثم أستدير لأوجه إلى صدور الرجال رسائل قتل؟ مصارحة تشي بطبيعة مقاتل يجهل مصيره في اللحظة التالية، إذ رأى رجالا كثيرين “يموتون بشجاعة. لن أفجع إذا ما جاء دوري… للرعب سحر مخيف، مازلت إلى الآن خائفا، بي مخاوف صغيرة. أخيرا التقيت الخوف نفسه وربط كبريائي بشجاعة غير متعمدة”. إلا أن داوسون، في المطلق شأن الكثيرين، لم يرفض فكرة الحرب، ففي 6 فبراير 1917 كتب الرسالة الأخيرة، معلقا على خبر نشرته في اليوم نفسه إحدى الصحف عن تلويح الولايات المتحدة بالمشاركة في الحرب، وتمنى أن يحدث ذلك، وأخذ على الولايات المتحدة أن “ملايينها التسعين.. لم تتحرك دماؤهم البليدة لنداء الواجب… ستموت روح أميركا الحبيسة وستحترق”، أما روح إنكلترا فيراها تتجدد وتكبر.
تسع وأربعون رسالة من كونينجسبي داوسون (1883 – 1959) جمعها أبوه ويليام جيمس داوسون، في كتاب عنوانه “Carry On: Letters in Wartime”، أي “داوم على المراسلة في زمن الحرب”، وكتب الأب مقدمة وهوامش للكتاب الذي صدر في العام 1917، ويلي اسم المؤلف تعريف بأنه “روائي وجندي”.
ولم يترجم الكتاب إلى العربية إلى أن فاجأني به الشاعر المصري الحسين خضيري، وتحمستُ لنشره في بدايات عملي رئيسا لتحرير مجلة الهلال، واقترحت على المترجم تغيير العنوان، فأصبح “رسائل من الحرب العالمية الأولى”، وصدرت الترجمة في سلسلة “كتاب الهلال”، نوفمبر 2014.
ولد داوسون في باكينغهام شاير ببريطانيا، ودرس التاريخ في كلية ميرتون بجامعة أكسفورد ومنها تخرج عام 1905، وغادر إلى الولايات المتحدة وأقام بمدينة تونتون (ماساتشوستس) ولحقت به أسرته، وأمضى عاما في المعهد العالي للاهوت، ولكنه قرر أن يكون كاتبا.
ونشر قصائد وقصصا قصيرة وروايات منها “حديقة بلا أسوار” عام 1913. وفي عام 1916 صدرت له رواية “عبيد الحرية”، وكان قد التحق عام 1914 بالكلية الحربية الملكية الكندية في كنغستون أونتاريو في كندا، وصار ضابطا في سلاح المدفعية الكندية، وفي يوليو 1916 اختير مع 25 ضابطا للخدمة الفورية في فرنسا، وظل في الجبهة حتى نهاية الحرب التي عاد منها جريحا إلى الولايات المتحدة.
وفي عام 1919 ذهب إلى بريطانيا لإلقاء محاضرات عن إعادة بناء أوروبا، وزار مواقع منكوبة بالحرب في وسط أوروبا الشرقية، وقدم عنها تقارير بناء على طلب هربرت هوفر الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية عام 1929. وأصدر بعد انتهاء الحرب نحو عشرة أعمال آخرها رواية “وادي الإلهام” عام 1935.
رسائل خاصة

في مقدمة الكتاب وصف الأب ويليام جيمس داوسون رواية ابنه “عبيد الحرية”، التي طُبعت عدة طبعات، بأنها “كتابه الأخير” الذي انتهى من تأليفه وهو تحت ضغط كبير، “حين كان يجب عليه أن يتطوع في الجيش… وكان عليه إنهاء عمله بسرعة واللحاق بالحرب”، وأنه بالتزامن مع إرساله إلى مهمة عسكرية في فرنسا في العام 1916 تطوع أخواه الصغيران في البحرية الملكية، ثم جنّدا في كندا تحت إمرة القائد البحري أرمسترونغ.
وقال إن ابنه لم يكتب هذه الخطابات للنشر، فهي رسائل حميمة وخاصة جدا، ولم تكن لتنشر لولا شعور الذين أرسلت إليهم بأن “روح الكاتب وطباعه من الممكن أن تسهم في تقوية” عزيمة أمثاله ممن يُدعَون إلى تقديم تضحيات عظيمة من أجل دوافع سامية يراها واجبا مقدسا.
ونوه الأب إلى أن الخطابات لا تبوح بأي معلومات عسكرية عن عمليات جيش الحلفاء، ولم يفصح كاتبها عن مكانه النائي في ميدان المعركة طوال الفترة التي تغطيها الرسائل، بداية من 16 يوليو 2016، حتى 7 فبراير 1917، باستثناء الرسائل الأولى، وكتب إحداها في 23 يوليو 1916، وهو على متن السفينة العابرة للأطلسي إلى فرنسا، وتبدأ الرسالة بقوله “إنني متحير، كيف أجعل رسالتي شائقة، حيث لم يسمح لي إلا بالقليل من الحديث عن الرحلة، فكل شيء تحت الرقابة”، ثم يستعرض صفات رفاقه، ويبدو أنه كان يضع كوابح تمنع أو تنظم تدفق الكلام، “إيه..! وددت لو أخبرتكم عن أشياء كثيرة ليس من المسموح لي التحدث عنها، إذن لأضحى خطابي أكثر تشويقا”. وسوف يرسل إلى حبيبته “م”، حين ينخرط في المعارك، قائلا إن ما لا يكتبه في الرسائل كثير “ومرعب، لا يتحمله الورق”.
خرج داوسون من التجربة شخصا آخر، فالروح التي خبرت الموت، وكتبت لها النجاة، تميل إلى قبول الموت، وأحيانا أكثر رهافة، وتسمو على بغض “العدو الألماني”، من دون التنازل عن كراهية الأهداف التي يقاتل من أجلها هذا “العدو”.
وفي مقدمة الكتاب تفاصيل لم ترد في الرسائل، وتحمل بعضا مما يمكن اعتباره مبالغة في وصف قتال بتلك الدموية بأنه قتال نظيف، فيقول الأب إن ابنه روى له قصة تؤكد تلك المروءة في إحدى المعارك العنيفة، إذ رأى ضابط بريطاني ضابطا ألمانيا يتلوّى ألما، وهو مُطوّق بأسلاك شائكة، ورغم كثافة النيران فإنه كان مُعلقا لم تصبه المدفعية. ولم يطق الضابط البريطاني الانتظار، وقال “ليس بمقدوري النظر إلى هذا الشاب المسكين، أطول من ذلك”؛ ومضى إليه تحت وابل القذائف وحرّره، وحمله على كتفيه إلى الخندق الألماني. وتابع الطرفان الألماني والبريطاني ذلك المشهد، وتوقف إطلاق النار، وأقبل القائد الألماني وانتزع صليبا حديديا يعلقه على صدره، ووضعه على صدر الضابط البريطاني.
لا ترد الواقعة في رسائل داوسون، وربما حكاها لأبيه تدليلا على شهامة معسكر يقاتل في صفوفه، لكي يمهد لقوله إن “السجل الألماني زاخرٌ بالعديد من الأفعال الهمجية التي لا يستطيع العالم غفرانها”، وعلى الرغم من هذا السجل فإن الجانب الألماني ليس موضعا للكراهية وإنما الإشفاق.
في الرسالة الأولى يشير داوسون إلى تناوله الغداء مع أهله، قبل تلقيه أمرا بالإبحار، مع ستة آلاف من القوات، واثقا بأن أهله منذ زاروه في المعسكر يشاركونه الشعور بأنه “منطلق إلى جهاد، كنت سأفقد الكثير من الشرف إن لم أشارك فيه”.
الحرب عمل أخلاقي

ويقترن هذا الإيمان بأن هذه الحرب عمل أخلاقي بترديد اسم الله كثيرا، بداية بالرسالة الأولى “أتضرع إلى الله أن نجلس ثانية… ونصغي إلى حفيف الأشجار في البستان”، ودائما ما يختم رسائله قائلا “وفقكم الله وحفظكم”، “وفقنا الله جميعا ومنحنا قلوبا آمنة”.
ويستمر هذا الحس الديني في عدد من الرسائل، ففي الرسالة الثانية، 23 يوليو 1916، كلام عن الدين والجبر واختيار المصير، وأن عليهم أن يفخروا بالكاتب الذي صار جنديا، “كما لو أنني عشتُ أنجز كل ما تتمنونه لي… لقد صرت طفلا بين يدي الله مرة أخرى، على ثقة عظيمة بمحبته وحكمته وثقتي المتزايدة في أن ما يقضيه في أمري يظل دائما هو الأفضل لي”.
وفي رسالته إلى حبيبته “م” استعجال لصليب أرسلته إليه. وفي رسالة إلى أمه يطمئنها بأنه يعلق دائما صليب حبيبته. ويبدأ رسالة أخرى إلى أمه قائلا إن قلادتها وصلت الآن، وإنه يعلقها في عنقه مع صليب حبيبته “م” التي يرسل إليها أيضا، ذات مرة، رسالة يكتبها “على أضواء الشموع، وعلى دوي القنابل، يقفز كل شيء. أرتدي الآن القلادة والصليب طيلة الوقت”، ويكرر لها هذا الأمر في رسائل تالية معتبرا الصليب “تعويذة ضد الخطر”.
ثم يكتب إلى أمه إنه من الأفضل للإنسان أن يكون “على صلة وطيدة بقس ذي قلب كبير، يُخاطر بحياته يوميا كلما يحادث الجنود البريطانيين، الذين يموتون، عن الحياة الأبدية”، وإذا أصابه نوع من الشك في المشروعية الأخلاقية لما يشارك فيه، فإنه يقول “ليس بوسعنا أن نخمن ما سيقوله لنا الله، لكنه لن يكون قاسيا مع أُناس أدّوا واجبهم”.
وفي الرسالة الخامسة والثلاثين، نهاية العام 1916، خطاب يتسم بالحدة، يتوجه فيه إلى “السيد أ. د”، بسؤال عما إذا تخيل أنه يعيش في عالم “يتم فيه إثبات الفكرة البروتستانتية كل يوم لما سيحدث في النهاية، عندما يُدوّي النفير الأخير، عندئذ تدرك فكرة ما عن موقفي الغريب. وصل المرء إلى نقطة لا يعتد بالموت فيها، والخيبة الوحيدة هي الخسارة المطلقة. الحب والمستقبل وكل أحلام الماضي العذبة والجميلة كبيت أُسدلت ستائره، وذهب المشهد عنه. فقدت المشاهد الطبيعية جمالها، لقد تم تدمير كل ما صنع الله وكل ما صنع الإنسان، وليس سوى قدرة الإنسان على تحمل الأشياء التي خشيها مبتسما… لقد منح الله كل الرجال هنا تلك الفرصة المأمولة.. هل يرى المرء قيمة الحياة أكثر في المعركة؟”.
كان للحرب وجه كريه قبل انخراط داوسون في القتال، ففي رسالته الرابعة، 19 أغسطس 1916، يحكي عن انتهائه من التدريب على ركوب الخيل، واجتياز التدريب على إطلاق النار من وضع الرقود، وأنه سوف يتدرب على المدفعية، ويذكّرهم بالضابط “س″ الذي رأوه في المعسكر قبل الإبحار، وأن لهذا الضابط شقيقا دعاه داوسون إلى العشاء أمس، وأخبره بأن أخاه “س″ رجع من فرنسا بعين واحدة. ولكن هذا التمهيد لا يدفعه إلى استئناس الموت. كما أنه قابل الكثيرين ممن عادوا من الجبهة الأمامية للقتال، “لكن ما حيّرني فيهم دهشتهم لقبول الموت، لا أعتقد بأني أتقبل هذا كشيء طبيعي. إنه شيء سمج للغاية في إعاقته للعديد من الأحلام والخطط والحب”.
روائي غير معتدل

تبدو الحرب، في الوصف السابق، نزهة تؤجل الأشواق إلى الحب وإلى التحقق عموما، إلا أن داوسون سيقول بعد ذلك كلاما مختلفا، يصف فيه الحرب بأنها “لعبة تُخرج أفضل وأسوأ ما في الإنسان من صفات”، والبطولة المطلقة هي أجمل فضيلة يتمناها الإنسان، وكل من قابلهم في الجبهة لديهم الجرأة والشجاعة على ارتداء تاج من الأشواك، “أعتقد أن ما يعنيه أرسطو بالفضيلة هو القمة”، وأن ما يفعله هؤلاء الشبان الشجعان “تجاه الموت يُلهمني”. ويلاحظ أن الرجال الأكثر خوفا والأقل شجاعة “هم الذين يموتون بسهولة”. ورغم هذا التضارب في المشاعر الخاصة بالشجاعة والموت، فإن “ميدان الحرب الحديثة نوع من الكراهية… العيش والنوم في العراء يجعلان المرء جارحا مفترسا”.
والحرب بهذا المعنى، في الشعور العام، “قذرة”، ولكنها رائعة في الشعور الفردي حين يقهر المقاتل نفسه، وبشيء من التلخيص فإنه “ما من شيء رائع في ميدان القتال، حين ينتهي القتال”.
وعلى العكس من الخطابات الموجهة إلى شخص ذي مكانة خاصة مثل أمه أو حبيبته، فإن الرسائل الموجهة إلى عموم أهله تبدأ: أعزائي، أو أغلى الناس.
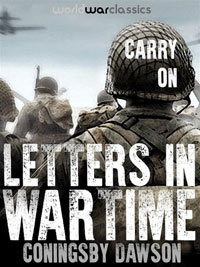
وفي بعضها يحكي عن تلقيه ترقية، وأنه أصبح قائدا لفصيلة، ولديه خادم وسائس خيل وجوادان، إلا أنه يكتب إليهم “الآن من حفرة على عمق ثماني أقدام تحت الأرض، مغطاة بالحديد المطلي وأكياس الرمال”، وأنه في هذه الأجواء يخطط لكتابة روايات، ويشغله السؤال عما إذا كان سيكتبها كما يتخيلها؛ لأن “خيالي زاخر بالأعاجيب الحقيقية إلى حد كبير. أعتقد بأنني تغيرت نفسيا، وأصبحت أكثر صرامة، تجردت من ليونتي، ربما أصبحت أكثر قسوة، لا يمكنني أن أجزم أنه يجب أن أكون روائيا غير معتدل. مر وقت طويل مذ تصرفت على سجيتي، أو قابلت أحدا على علاقة بالفن. لكن لدي من ثقتي بنفسي ما يكفي لأهتم بكتابي”.
ولا ينسى أن يؤكد لأهله أن أفكارهم “عن الجيش وأزراره اللامعة لمخطئة تماما؛ إننا لنبدو ثملين وغير منظمين، كمن أمضى الليل في ترعة، ولدينا ذاتُ الغريزة للحرب”، وقرب نهاية الكتاب يقول إن غاية ما يتمناه، حين تنتهي الحرب، أن يسمح له “بالنوم جالسا في مقعد ذي ذراعين، وأن يدعوني في هدوء تام”. وفي 3 ديسمبر عام 1916 كتب كونينجسبي داوسون “يبدو لي أن الحرب لن تنتهي أبدا قبل أقل من عامين”، ولعل تلك أصدق نبوءات الكتاب.
ومن النبوءات أيضا ما كتبه أبوه في مقدمة الكتاب عن فوز قوات الحلفاء بالحرب، ليس فحسب مصداقا لقول نابليون “إن الله في صف أقوى الكتائب”، وهذا ما يتفوق فيه الحلفاء، وإنما لأنهم يحاربون “من أجل الهدف الأسمى”.




























