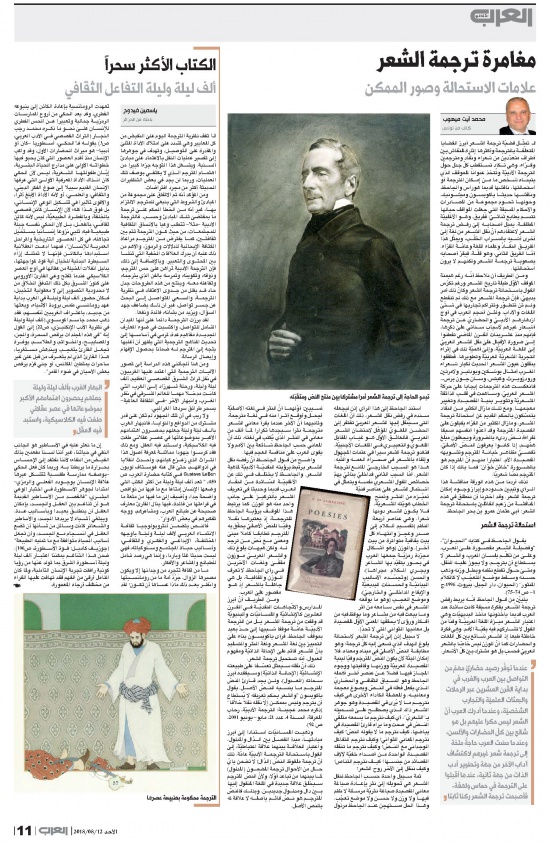تأثير الأدب على السينما في فيلم "عصافير النيل"

جاءت الأفكار الكبيرة في السينما المصرية من الأدب، أي من عالم الرواية، من أعمال طه حسين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وإحسان عبدالقدوس وفتحي غانم ويحيى حقي ولطيفة الزيات، وغيرهم، وتركت تأثيرها على الفيلم المصري، سواء في مضمونه الاجتماعي ودلالاته النقدية، أو في أشكاله السردية، حتى أنّ المرء يخال أنّ نجيب محفوظ كان يكتب وعينه على السينما، أي أنه كان يتأثر كثيرا في كتابة رواياته، بالسيناريو السينمائي.
المخرج مجدي أحمد علي، صاحب “يا دنيا ياغرامي”، “البطل”، “أسرار البنات”، “خلطة فوزية” عاد إلى الأدب للمرة الأولى في فيلمه “عصافير النيل” (2009)، الذي اقتبسه عن رواية إبراهيم أصلان وكان يأمل من وراء ذلك، أن يقدم رؤيته السينمائية للرواية.
للوهلة الأولى يمكن القول إن هناك علاقة ما بين فيلم “عصافير النيل”، والفيلم السابق لمجدي أحمد علي “خلطة فوزية”، وربما يكون ممكنا رصد ملامح هذه العلاقة في النقاط التالية:
1 - يدور الفيلمان حول شخصية فردية، ريفية أو شبه ريفية، تعيش على هامش المجتمع، في الأحياء العشوائية القريبة من نهر النيل بكل ما يجسده النيل من انسيابية وتدفق، كما لو كان في سرمديته وامتداده الذي يبدو موغلا في أعماق التاريخ، شاهدا على ما يقع فوق ضفتيه من أحداث. الشخصية الأساسية في الفيلم الأول هي “فوزية”، وفي الفيلم الثاني “عبدالرحيم”، وكلاهما يعاني من الإحساس بانعدام الأمان، بالرهبة من المدينة، والرغبة في إقامة علاقة جسدية مع الآخر، لعلها يمكن أن توفر نوعا من “الأمان” والدفء المفقود. ولا شك أن هذا الشعور، بكل ما يعتريه من اندفاع وتهور أحيانا، يمكن أن يؤدي إلى صدام بين الشخصية والواقع.
2 - الحضور القوي للموت في مجاورته للحياة في كلا الفيلمين. وعلى الرغم من قسوة الموت، ورغم الإحساس الشجي بالحزن الذي يغلف دواخل الشخصيات في الفيلمين، إلا أن الرغبة في الاحتفال بالحياة تظل رغبة دائمة ممتدة تحمل في داخلها القدرة على التجدد لبطلي الفيلمين، كما تبث للمشاهدين الأمل. هنا تتجلى قدرة مجدي أحمد علي كمخرج، في التعبير عن ذلك التناقض بين الحياة بكل عنفوانها، والموت في سكونه كنهاية للجسد.
نجح المخرج في التعبير عن التناقض بين الريف والمدينة، عن فكرة تجاور الموت والحياة، والبحث الدائم عن الحب ولو من خلال الجنس، وفكرة الجنس كرغبة تعكس القلق وانعدام الثقة
3 - الحبيب الأكثر تأثيرا يظل في الفيلمين هو الأقرب إلى الشخصية الرئيسية، لكنه يبتعد عنها بعد أن تفقده: في “خلطة فوزية” هو السباك (عزت أبوعوف) أحد أزواج فوزية السابقين، لكنه يغيب بعد وفاته المفاجئة، ويظل يتراءى لها شبحه طوال الوقت، فقد كان الأقرب إلى عقلها وربما أيضا إلى قلبها رغم خياناته الصغيرة لها.
وفي “عصافير النيل” تظل شخصية “بسيمة” هي الشخصية الآسرة، التي لا تفارق خيال البطل، فهي المرأة الأولى التي التقاها في القاهرة وتعرف عليها وأنس لها، ثم هجرته بسبب تردده في حسم موقفه تجاهها: هل يشترك مع أهل الحارة في اعتبارها امرأة “منحرفة” بالمعايير الأخلاقية السائدة، أم يستمع إلى نداء قلبه الذي يقول له إنها المرأة النظيفة الجميلة التي يمكنها أن تعيش له فقط؟
4 - التقلب بين الرجال بحثا عن الشريك المكتمل الذي يمكنه أن يستوعب طاقة وحيوية وعنفوان البطلة في “خلطة فوزية”، أو بحث البطل الدائم عن المتعة الأبدية مع المرأة، وهو ما يجعله ينتقل من واحدة إلى أخرى في “عصافير النيل”، مما يعكس أيضا فكرة النهم إلى الاستمتاع بالحياة، والتي تتجسد عن طريق الجنس، بغرض الارتواء، والإشباع النفسي، والتعويض عن الإحساس الدائم بالخسارة عند البطل في “عصافير النيل”. ورغم هذه التقابلات إلا أن هناك أيضا فروقا جوهرية بين الفيلمين ذات علاقة بالفرق بين المرأة والرجل في مجتمعاتنا المحافظة بطبيعتها في نظرتها إلى المرأة التي لا يمكنها التعبير ببساطة عن مشاعرها أو الظهور بالمظهر الذي تحبه.
في “عصافير النيل” مثلا هناك مشهد نرى فيه أحد المتشددين الأصوليين يعترض سبيل “بسيمة” في الشارع وينهيها عن تناول الطعام علانية في الطريق العام، بدعوى أن هذا “حرام”.
وفي الفيلم الكثير من المشاهد التي تتميز بالحس الرفيع، مثل مشهد اللقاء في بداية الفيلم، بين بسيمة وعبدالرحيم، ثم مشهد اصطياد العصفور بسنارة صيد السمك، ثم مشهد عبدالرحيم بعد إعفائه من العمل كساعي بريد وهو يعود إلى قريته التي جاء منها للقاهرة، وهناك يجلس في ظل شجرة، ويناجي نفسه بينما يبدو الأفق أمامه متسعا، وهي من المشاهد التي تتيح للمتفرج مساحة للتأمل والتفكير والمتعة.
ولا شك أن أداء فتحي عبدالوهاب للدور الرئيسي لا يهبط أبدا إلى مستوى محاكاة الريفيين بطريقة مفتعلة بل يسيطر بقوة على الشخصية حتى أنه يساعد الممثلين الذين يقفون أمامه، على الارتفاع إلى مستواه ومجاراته في إبداعه.
تجسيد الأفكار

نجح المخرج في التعبير عن التناقض بين الريف والمدينة، عن فكرة تجاور الموت والحياة، والبحث الدائم عن الحب ولو من خلال الجنس، وفكرة الجنس كرغبة تعكس القلق وانعدام الثقة، وربما أيضا كتجسيد لتلك الفكرة الشائعة عند الريفيين عن “نساء المدينة” الشهيات اللاتي يقدمن أنفسهن بسهولة. ومن أكثر العلاقات في الفيلم تجسيدا لهذا التناقض بين الشاب الريفي ونساء المدينة، تلك العلاقة بين “أشجان”.. الأرملة الأربعينية، والشاب الريفي عبدالرحيم، المندفع الذي لا يهدأ له بال في بحثه القلق عن السكينة.
“أشجان” تعرف كيف تغويه بعد أن تدرك أنه النموذج المستعد للوقوع في يدها بسهولة، لكنها تستدرجه وتوقع به لمصلحتها وطبقا لشروطها. إنها نموذج لامرأة المدينة، التي تعرف كيف تتحكم في الريفي المتدفق العاطفة، وتدفعه للسير إلى الوجهة التي تريدها، فتجعله يتزوجها رغم أن لديها ثلاثة أبناء، ثم هي التي تقرر في ما بعد، أن تنهي زواجها منه بالطلاق عندما تجد أن زواجهما يتعارض مع مصالحها المادية المباشرة، فربما تفقد بسببه، منحة تقاعد زوجها الراحل.. وهو ما يدفعه إلى العودة إليها بعد وقوع الطلاق، لكي يغتصبها، يريد أن يقول لنا إنه كريفي خشن، لا يقبل أن تلتقطه امرأة على هذا النحو، ثم تلقي به إلى الخارج وقتما تشاء، وكأنه يريد أن يحقق معها لحظة النشوة التي انقطعت، بالمفهوم الحسي المباشر، كما أنها، بسبب قوة شخصيتها، تظل في خياله المرأة الأكثر إثارة من الناحية الجسدية، وهو ما يؤكده لنا الراوي من خلال التعليق الصوتي من خارج الصورة.
أما “بسيمة” المطلقة الشابة التي كانت تجاورهم في السكن (عبدالرحيم يقيم مع شقيقته نرجس وزوجها البهي أفندي، موظف البريد) فهي تظل مثل الفاكهة المحرمة، رغم أنه نالها أيضا من البداية، لكنها حرمته من نفسها بعد أن تردد في الثقة بها.
وظل يعتبرها رمزا للجمال والرقة والأنوثة والدفء الذي كان يحتاج إليه. لكن الاثنين يلتقيان مجددا في المستشفى بعد أن تكون الشجرة قد ذبلت، أي بعد أن يصيب المرض العضال عبدالرحيم، وتكون بسيمة بالفعل قد سكنت المستشفى بعد إصابتها بالسرطان. يموت زوج شقيقة عبدالرحيم، أي “البهي”، وتموت “نرجس” بعد ذلك، ولكن تظل الأم: أم عبدالرحيم ونرجس، التي تقيم في القرية، تحلم بالأرض التي ربما تكون قد ضاعت بالفعل إلى الأبد، وتتذكر أشخاصا رحلوا عن عالمنا، لكنها لا تزال، بعد أن أصبحت طاعنة في السن، تتشبث بالحياة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال الموت. وعندما يصحبها عبدالرحيم للعيش في المدينة، لا يمكنها أن تتحمل، بل نراها في المشهد الأخير من الفيلم تغادر المدينة عائدة إلى القرية، لكي تموت هناك.
التأثير الأدبي
الرؤية الأدبية تلقي بظلالها على فيلم “عصافير النيل”، تمنحه الكثير من قيمته، وفلسفته ورؤيته وصوره الأخاذة بفضل مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، الذي يعرف كيف ينتقل من النهار إلى الليل، ومن الليل إلى النهار، وكيف يستخدم ببراعة المصادر الطبيعية للضوء. ورغم ذلك، يعاني الفيلم من الترهل في الإيقاع لولا أن مجدي يتمكن بحرفيته العالية، من شد المتفرج مجددا إلى الشاشة.
والمشكلة أن سيناريو الفيلم استسلم كثيرا لسطوة الأدب، والرغبة في التعبير عن الكثير من الأفكار الأدبية الكامنة في الرواية، مما أدى إلى شيوع بعض الاضطراب في الفيلم. وليس كل ما يرد في العمل الأدبي من “أفكار”، يصلح بالضرورة لكي يدخل إلى سياق الفيلم، ما لم تتم معالجته بطريقة لا تفقده قيمته البصرية وعلاقته “الخارجية” مع الصور واللقطات والمشاهد الأخرى في الفيلم، كما لا تفقده علاقته “الداخلية” بالفكرة الأساسية التي تدور حولها الدراما.
إلا أن الفيلم كثيرا ما ينحرف خارج الفكرة الرئيسية، إلى أفكار فرعية لا تضيف جديدا، بل تساهم في تشويش الرؤية عند المتفرج: من هذه الأفكار مثلا: فكرة التطرف الديني وتأثيره على الشارع، والتي يعالجها الفيلم بطريقة ساذجة.
في الفيلم الكثير من المشاهد التي تتميز بالحس الرفيع، مثل مشهد اللقاء في بداية الفيلم، بين بسيمة وعبدالرحيم، ثم مشهد اصطياد العصفور بسنارة صيد السمك
في الوقت نفسه، هناك ابتسار كبير في تقديم الشقيقين، أي ابني البهي ونرجس وهما: سلامة وإبراهيم، والمفترض أن أحدهما، أي إبراهيم، يتجه يسارا (لا أعرف إلى أين تحديدا.. فالفيلم لا يقول لنا شيئا عن نشاطه ولا حتى عن مواقفه الفكرية مما يحدث، بل هو صامت معظم الوقت، وعندما يتكلم يلقي بتعليقات عامة وسطحية)، في حين يختفي الابن الثاني من الفيلم تماما لكي يعود قرب النهاية، ونفهم أنه مرتبط باليمين الديني، وأنه يمكن حتى أن يشي بشقيقه للشرطة، مما يصيب أمه بصدمة توقعها مريضة إلى أن تغادر الحياة.
الواضح أن الرغبة في “الإخلاص” الشديد لما ورد في الرواية، أدى إلى التشتت في البناء، والهبوط في الإيقاع العام للفيلم. ومن بين العناصر الفنية الجيدة في الفيلم استناده إلى نسيج أفقي من الشخصيات والأحداث، تلتقي وتفترق، كما يجسد الفيلم فكرة مرور الزمن التي تبدو على ملامح الشخصيات وتنعكس مثلا على نرجس مع تقدمها في السن، وزوجها البهي، الذي يصل إلى مرحلة الهلوسة التامة قبيل موته، كما أن الأطفال يكبرون، وعبدالرحيم يصاب بالمرض وتبدو عليه آثار الزمن، وكذلك بسيمة.
من عيوب الفيلم المشهد الذي يخصصه مجدي أحمد علي للبهي أفندي، موظف البريد المتواضع المستوى، حياتيا وتعليميا، وهو يندفع فجأة ويهتف وسط أهل منزله بمونولوغ هاملت الشهير في مسرحية شكسبير، وباللغة الإنكليزية (أكون أو لا أكون)، في حين يتابع الجمهور المشهد الطويل (حوالي 5 دقائق) عن طريق الترجمة المطبوعة. وهذا المشهد تحديدا كاد يقضي على الفيلم كله، كما يضر بإيقاع الفيلم، بل ويبدو خارج السياق تماما، بل وخارج طبيعة الشخصية وطبيعة الفيلم نفسه.
من ناحية اللغة والشكل والأسلوب: يستخدم مجدي في فيلمه ثلاثة أصوات للراوي: صوت الراوي المحايد الذي يبدو مطلعا على كل ما يقع للشخصيات، وهو هنا صوت المؤلف، وهي وسيلة أدبية قديمة معروفة، أضفت طابعا أدبيا تقليديا على الفيلم، كما يستخدم صوت عبدالرحيم نفسه، الذي يروي أيضا ويعلق على بعض المواقف والأحداث من وجهة نظره الذاتية، ويستخدم بدرجة أقل، صوت بسيمة، التي تروي وتعلق على بعض ما يخصها من خارج الصورة.
ويستخدم مجدي ببراعة القطع في شريط الصوت قبل الانتقال في شريط الصورة، أي قبل أن ننتقل من مشهد إلى آخر، وهي وسيلة معروفة تزيد من تكثيف الموضوع، وتجعل المشاهد ينتبه، وينتقل من الاستغراق إلى المتابعة الذهنية، كما أنها تمهد نفسيا للانتقال إلى مشهد آخر.
الفيلم بكل اضطرابه وميزاته نموذج للميل التقليدي في السينما المصرية للتأرجح بين السينما السائدة، والسينما الفنية، بين سينما تريد أن تعبر بشفافية وشاعرية عن المشاعر الإنسانية، وسينما أخرى، تريد أن تغازل متفرجي السينما السائدة بتقاليدها المعروفة!