الفاعلية والمثقفون
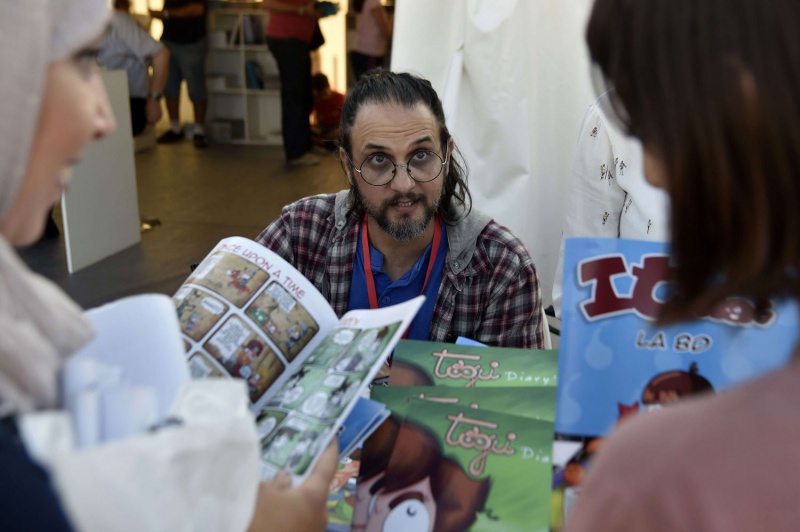
منذ عدة سنوات طرح أحد المثقفين الجزائريين مشكلة كبيرة تتصل بانعدام الفاعلية غالبا في ممارسات المثقف عندنا ولكنه لم يقدم دراسة تعرف هذا المفهوم وتكشف عن تاريخه وتضيء كيفية تطبيقه في الميدان العملي كما أنه لم يشر إلى الإكراهات التي تحول دون نمو وتحقق الفاعلية في هذه الثقافة الوطنية أو تلك وخاصة في مجتمعاتنا.
على مستوى الجزائر، مثلا، فإن مالك بن نبي هو الذي بادر باستخدام مفهوم الفاعلية في الخمسينات من القرن الماضي ولكنه لم يطور هذا المفهوم ليصبح محورا للتفكير في الحياة الفكرية الجزائرية عبر التاريخ.
تاريخيا يرجح مؤرخو الأفكار أن الفاعلية كمفهوم قائم بذاته قد برز في عصر الأنوار على نحو مرتبط بحرية الفرد في التحرر من الحواجز التي تعوق استقلال الذات عن البنيات التي تحاول أن تخضعها وتغلق عليها داخل سياجها. يتفق المنظرون أن الفاعلية هي “قدرات الفرد أن يفعل عن نحو مستقل وأن يقوم باختيار خياراته”، وذلك بعيدا عن تأثيرات “البنيات التي هي تلك العوامل المؤثرة (مثل الطبقة الاجتماعية، والدين، والجنوسة، والإثنية، والأعراف) التي تقرر أو تحد الفاعل وقراراته” حسب تعبير أحد النقاد الغربيين.
وفي حقل الدراسات الثقافية المعاصرة فقد تمت دراسة العلاقة المتبادلة بين الفاعلية والبنية والدعوة إلى بناء الوعي النقدي الذي يساعد الأفراد على صنع المسافة بينهم وبين البنيات التي تحول دون تحرير أفعالهم من الأنظمة الاجتماعية المهيمنة. ومن أبرز معوقات الفاعلية في مجتمعاتنا تعامل الأفراد مع أعراض الأزمات المختلفة وليس مع البنيات المختلة التي تفرز هذه الأعراض، وجراء ذلك نجد المثقفين عندنا يعادلون الأعراض بأصول الأزمات وبذلك يفشلون في فهم الخلل في المجتمع كما يفشلون في خلق البدائل والمبادرة بالإصلاح أو التغيير الجذري، وفي هذا السياق يمكن لنا أن نلاحظ أن مقاومة الأزمات مشروطة بالوعي الذي لا يتعامل مع الأعراض، أو يتجنب الواقع.
وتتمثل العقبة الأخرى التي تعرقل صنع الفاعلية في “حياد المفكر تجاه قضايا وطنه وأمته وعصره، الأمر الذي يفقده الموقف والدور والوظيفة…” كما يرى دارس جزائري آخر وهو الذي نجده يتساءل هكذا “لماذا يتفوق العلماء العرب في الجامعات والمعاهد الأجنبية ويتحولون إلى موظفين في بلدانهم؟” وأنه “من الملاحظ أن طالب الطب المسلم الذي يذهب لتلقي علومه في إحدى العواصم الأوروبية، يحصل على الديبلوم نفسه الذي يحصل عليه زميله الإنكليزي مثلا، بل إنه كثيرا ما يتفوق عليه إذا ما كان أكثر استعدادا وذكاء، لكنه لا يحصل غالبا على فاعليته، أعني طريقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحياة الاجتماعية” كما أكد مالك بن نبي مرارا وتكرارا.




























