الروائي الجزائري كمال بركاني: لا أؤمن بقارئ كسول

الهامش له تأثيرات عميقة في مسارات الكتاب والروائيين والشعراء، قد تكون سلبية أو إيجابية ومنتجة أو قاحلة، لكن يبقى الهامش محملا بالموروثات والأساطير والحكايا، وهي أمور يعرفها الروائي الجزائري كمال بركاني وقد ثبتها وكشف عنها في جل ما أصدره من أعمال روائية. في هذا اللقاء مع “العرب” يشرح الروائي هذه التيمات والعلامات والفوارق وما قدمته له من معان أخرى يندر وجودها في متون روائية جزائرية معروفة.
تختلف نصوص الروائي كمال بركاني عن مثيلاتها في المتن الروائي الجزائري، حيث يكتب بخصوصية نادرا ما تجدها عند غيره، ينحدر من مناطق بربرية، في الأوراس تحديدا معقل الثورة الجزائرية، وقد استثمر هذا العمق وهذا التاريخ المميز وكثف نصوصه به.
يقول الروائي عن نفسه “أنا كاتب منتم، مشبع بثقافة الأوراس المتفردة، حيث أجدادي مروا من هنا، تلك الوجوه البربرية المصطفة في يقين وتكبر، تلك الطقوس العتيقة والأهازيج القديمة، تلك الحلي والثياب، تلك الجبال والبيادر، وأنا مدين جدا لكل الذين مروا من هذا المكان أشعر بفخر حين أكتب عن اختلافهم، ولا أجد فرقا بين الهوية والإنسان، الذي لا يملك خصوصيته، كائن آخر، يتعثر في خطوته وسرعان ما يتلاشى”.
البداية لغة

ينظر كمال بركاني إلى اللغة على أساس أنها الأصل في كل شيء فمنها تبدأ كل الأمور وكل الهواجس والرؤى، يقول “إذا كان رولان بارت، يقول: من أين نبدأ؟.. فأنا سأنفذ من اللغة التي أكتب بها، تلك التي تتكاثر وتتناسل، فاسحة المجال لولادات أخرى، تنطلق من المعقول إلى الهوس، ومن الذاكرة إلى الوجع، وتصعد من الأرض إلى السماء، مصدر السكينة والهدوء، ربما في هذا، تختلف نصوصي، قد أزيد أشياء أخرى، ذلك التوظيف المكثف للقرآن الكريم، والتركيز على الأمكنة باعتبارها حاملا ثقافيا وهوياتيا بامتياز”.
ويذكر الكاتب أن نصوصه وليدة الأزمة، أو الراهن المرتهن، وصدمة سقوط الدولة القومية، وانحسار اليسار العربي، أزمة السقوط في اللاصوت واللاعقل واللامشروع، وهي نصوص تطرح أسئلة دون أن تجد الأجوبة لذلك، موغلة في الرمزية، خشية القتل الجسدي أو المعنوي، بعضها جدير بالقراءة وبعضها لم يبلغ النضج بعد.
ويضيف “الشعر ميلادي الأول، حينما أكتب الرواية، أفكر شعريا، لذلك تجيء اللغة مترعة بالحنين، موغلة في الرمز والإيحاء والإحالة، لا أؤمن بقارئ كسول، أكتب لقارئ يفترض أن يبذل جهده للشعور بالمتعة وللوصول إلى المعنى، حينما أكتب، تستيقظ داخلي، الذاكرة الشفوية – للشاوية، تمتزج في ذهني الأصوات والأهازيج، الأوشام والألوان، شجر الصفصاف والرمان، يمتد أمامي جسد جدتي فطوم، بكل ما يحمله من رمزية في ضميرنا الجمعي، وتلوح للا كلثوم من أعلى جبل شلية العملاق بكفيها المخضبتين بالحناء البربرية، فتغمرنا السكينة، أشعر حينها بفداحة الحنين لواقع لم يعد موجودا، التعريب أتى على كل خصوصية ثقافية، خرق الانسجام بين الإنسان وذاته”.
يقرأ بركاني التاريخ الغابر الذي مر على أرض الجزائر، ويوسعه في نصوصه حتى غدت كفسيفساء متنوعة متداخلة وهي على حد تعبيره “مغرية جدا، الحامل قد لا يعكس حقيقة المحمول أحيانا، ولأن الوطن كان نهبا للغزاة منذ فجر التاريخ، فمن الفينيقيين إلى الفرنسيين، مرورا بالرومان، البيزنطيين، الوندال، هنا أستثني الفتح الإسلامي من قبيل أنه ليس غزوا، رغم بعض ما يسجل من تجاوزات خلاله، والعثمانيين، كل هؤلاء مروا من هنا، واستوطنوا هنا لمئات أو آلاف السنين، تلاقحت الحضارات والثقافات والجينات، لذلك، أنا فسيفساء ثقافية بالمعنى الإيجابي، متعدد الثقافات، زاخر باللغات، وفسيفساء هوياتية بالمعنى السلبي، لست أجزم من أكون؟”.
هذا السؤال الأنطولوجي والصعب والخطير عمن يكون يرجع الروائي إلى خيارات الدولة الوطنية ويشير إلى أنها بعد الاستقلال، أزمت الوضع، وجعلت مسألة الهوية أكثر تعقيدا، عوض أن تبني مشروع مجتمع، يعترف بالخصوصية والإثنيات، ويعمل على معالجة الشروخ النفسية الرهيبة التي خلفها الاحتلال الفرنسي في هذه الهوية، لجأت إلى تعريب كل شيء لطمس هذه الخصوصيات، مرعب وموجع جدا، كما يقول بركاني، أن يتم تعريب أسماء الأماكن، الطبونيميا (علم أسماء الأماكن)، حاملة الخصوصية، مذبحة كبرى حدثت، بعيدا عن الفكر والثقافة، رغم ذلك، وبعد أن أتصالح مع ذاتي، سأقول بصوت مرتفع: أنا جزائري أمازيغي اللسان، مسلم، عربي، أفريقي متوسطي.
المركز والهامش
يعتقد الروائي كمال بركاني أن “المركزية جنت على كل الدول الوطنية، أن تمسك كل شيء بيدك، بمعنى أن تبتلع كل شيء، لتتعطل طاقات كبرى، كان يمكن أن تستعملها للإقلاع، مع المركزية، يتمركز الفضاء المفتوح والإعلام والجامعة والأكسجين في العاصمة، تنتعش الحياة هناك، وتبدأ بالموت كلما ابتعدت عنها نحو الهوامش، هذا الهامش يبدع بجمالية عظمى لا يحتفى بها، لذلك المبدع فيه، سرعان ما ينطفئ، لأن صوته لا يصل، أصوات أخرى فيه، هاجرت صوب المركز أو خارج الوطن وهي الآن تصنع بهجة الكتابة”. فالمركزية، في رأيه، نظام لا يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، جريمة عظمى في حق أولئك الذين سقطوا في منتصف الطريق أبدعوا في صمت رهيب، ومضوا في صمت مطبق.
الروائي يقر بأن الشعر هو ميلاده الأول، حينما يكتب الرواية، يفكر شعريا، لذلك تجيء اللغة مترعة بالحنين
ويأسف بركاني على حال النقد في الجزائر، يقول “نحن لا نملك على مستوى النص مؤسسة نقدية، فباستثناء بعض الأقلام المعدودة، الساحة فقيرة جدا، لست أدري إن كانت الدراسات النقدية تخصص غير مرغوب فيه، أم لأننا شعب لا يملك حسا نقديا أكاديميا بطبعه، حتى الإعلام الثقافي على مستوى الصحف فقد صيته الذي كان يبهر به في ما قبل تسعينات القرن الماضي، كل شيء تم إعادة رسكلته لصالح المال وثقافة الاستهلاك، ببساطة، ثمة خلل كبير في المشروع الثقافي الجزائري، عندما تتخلى الجامعة عن مركزها الإشعاعي، يتوقف كل شيء، قراءات قليلة شرحت نصوصي باحتفائية جليلة، دراسات نقدية أخرى تعرضت لها“.
المشهد الجزائري
ويتابع الروائي ما يكتب في الجزائر، ويتلمس نقاط القوة والضعف في المشهد الثقافي، وما يمكن له أن يسهم في الثقافة العربية عموما، فمثلا يرى على مستوى الرواية أنها “أثبتت جدارتها وحضورها المميز على مستوى الوطن العربي، فالجزائري يكتب بقوة وجمالية، بعنف أيضا وقسوة، ولعل ما يميزها أكثر عن غيرها، الزخم الفكري والفلسفي”.
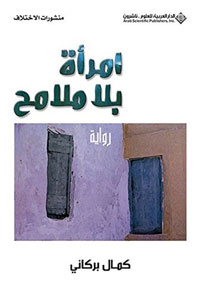
ويعدد بركاني بعض المشكلات التي تحول دون التدفق القوي للرواية الجزائرية، منها ما تعلق بـ”مستوى الماركتينغ، صناعة الكتاب وتسويقه، غياب لجان القراءة على مستوى دور النشر التي تحولت إلى دكاكين للبيع، وأغرقت الساحة الأدبية بمنتجات مضرة بالصحة الإبداعية وسلامة الذوق الرفيع، كما أن غياب ثقافة تسويق الكتاب والمرافقة النقدية والتحفيز المادي، حوّل الكتاب الحقيقيين إلى متسولين، ما جعلهم يتوقفون عن الكتابة، لأنها تأخذ كل شيء ولا تبقيك على قيد الحياة، مقابل ذلك، أفرز هذا الواقع المريض كتبة مثل آلات الطبع والنسخ تماما”.
وقد يكون الحل، في اعتقاد بركاني، في الدفع بالرواية الجزائرية إلى آفاق أكبر من خلال تشجيع النشر المشترك في الوطن العربي فهو قد “يسهم في إضاءة المدينة ولو بفانوس وحيد، كما أن إيجاد آليات لرفع نسبة المقروئية، مناخ ملائم للرفع من جودة النص، القارئ وتحفيز المؤلف مفتاحا ولوج الحضارة، فالعرب غادروا التاريخ منذ زمن سحيق، نحن يا سيدي مجرد حفريات عتيقة”.
كغيره يطرح الروائي كمال بركاني أسئلة كثيرة منذ أن بدأ الشارع يتحرك مطالبا بالحرية والتغيير ويعتبر أن أهم سؤال يجب أن يعاد التفكير فيه هو عن الأدوار الحقيقية التي يجب على المثقف أن يقوم بها.
يقول “هل للمثقف دور في حدوث هذا الحراك؟.. المتابع للحالة الجزائرية، وهي مطابقة لجميع ثورات الربيع العربي، يكتشف ببساطة أن الوعي السياسي صار يصنع خارج الأطر التقليدية؛ الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام، أعني في الملاعب والمقاهي الشعبية وشبكات التواصل الاجتماعي، وعليه يجدر بنا أن نعترف بأن المثقف تفاجأ مثل السياسي والإعلامي بهذا الحراك العظيم، جزء من المثقفين انضم إليه عن حب وقناعة، وجزء آخر، كعادته، باق يترصد الغنيمة، المشكلة أن أي حراك أو ثورة شعبية سلمية، إذا لم تؤطر مآلها الفشل، وهذا ما حدث في كل التجارب العربية مع فارق في التجربة التونسية، رغم نقاء الذين يمشون في الشوارع كل جمعة وإخلاصهم، إلا أن ذلك لا يكفي، لأن التنظير والتأطير يبقيان اللقاح الفعال لوقاية الحراك من الاختراق من عدوه أو الاحتراق بنفسه“.




























