الدراما الليبية بين الأمس واليوم.. من النقيض إلى النقيض

يشهد المنتج الدرامي الليبي تطوّرا لافتا في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الفني وقيمة الأعمال المقدمة أو على المستوى الثقافي والتاريخي. ولم تكتف الأعمال المنتحبة بالجانب الترفيهي فحسب، حيث مثّل الانفتاح على الأعمال المشتركة، خاصة مع تونس أين تم الاشتراك في تقديم مسلسلات مميزة تنافس على المستوى المغاربي والعربي، عاملا مهمّا عرفته الدراما الليبية، لكنّ العاملين فيها يطالبون بالمزيد من الإنجازات.
أشرف العزابي
طرابلس - عندما انتشر الستلايت في ليبيا مطلع التسعينات وجد المشاهدون في القنوات الفضائية ملجأ وبديلا عما كان يُقَدّم في تلفزيون البلاد الوحيد “قناة الجماهيرية”.
وكان التجاء الليبيين حينها إلى القنوات العربية شبيها بالهروب مما تقدمه القناة الرسمية من برامج وأعمال لم ترق إلى مستوى التطلعات.
ويقول الممثل عصام الزنتاني عن برامج التلفزيون في تلك الفترة إنها “كانت ركيكة في أغلب ما نقدمه، ولم تكن الدراما استثناءً”، وهو نفس رأي الكثيرين.
أعمال جديدة
يرى الزنتاني أنه “رغم القامات الكبيرة التي أسست قواعد الدراما والفنون عامةً، عانت أعمالنا برمتها من الإفراط في الرقابة، وصلت إلى حد إقصاء أي كلمة غير عربية من التلفزيون. حتى التلفزيون نفسه كنا نسميه الجهاز المرئي. وهذه المبالغات أبعدتنا عن وجدان المشاهد وحقيقة الشارع”.
ويتابع “كل عوامل صناعة الدراما (المالية والتقنية والفنية) كانت سيئة أيضاً، ومع هذا ما كان ينقصنا أكثر هو تحرر النص، ولقد بدأ الحلم يلوح سنة 2008 مع ظهور قناة الليبية”.
يؤكد ذلك المخرج والمنتج مؤيد زابطية، ويقول “ذاك العام كنت أقوم بإخراج مسلسل منوّع. وعندما عُرِضت أولى الحلقات على سيف الإسلام القذافي، أصدر تعليماته بإيقاف الرقابة عن العمل”.
ويصف الممثل عبدالرزاق أبورونية تلك الفترة قائلا “كاد الزمن يتجاوزنا، وكِدنا نفقد آخر المشاهدين لو لم نتحرك، وهذا ما شرعت فيه الدراما، بأفكار وجرأة وتقنيات الجيل الجديد، وخبرة القُدامى”.
هناك فنانون يرون أن الدراما الليبية انطلقت للتو فيما يرى آخرون في هذا الحكم تجنّيا على الأجيال السابقة
بعد انهيار النظام السياسي عام 2011 فُتِحت الأبواب على مصراعيها. يقول الزنتاني معلقاً “كنا بحاجة إلى تحرير العمل الفني، ولكن ليس إلى هذا الحد. لقد انتقلنا من النقيض إلى النقيض”.
عقب هدوء الأمور عام 2012 ظهرت قنوات وشركات إنتاج خاصة متعطشة إلى الإنتاج الدرامي. وكان موسم رمضان الخيار الأول وبوابة استعادة ثقة المشاهدين، فهل المسألة بهذه السهولة؟
تقول الممثلة أمل نوري “لم يكن من الهيّن إقحام أعمال جادة في رمضان، فالمشاهد الليبي اعتاد بعد الإفطار على وجبات مرِحة وخفيفة، وما يُعرض بعد ذلك قد لا ينال نصيباً من المشاهدة”.
المنتجون يدركون ذلك، ولم يخل الأمر من المغامرة، خاصة بأعمال ذات إنتاج مُكلِف. ومع هذا تسللت المسلسلات الليبية رويداً رويدا، ورغم قلّتها ظهرت أعمال بِحُلل جديدة ودماء شابة وتقنيات متطورة نسبياً، والأهم من ذلك نصوص متحررة قد تحاكي الواقع بشكل أفضل. وبعد سنين من الفُرقة التفت المشاهدون أخيراً إلى الدراما المحلية.
قد لا تُصدق التعليقات الإيجابية بداية، ولكن ما إن تُشاهد بعض الأعمال حتى تَقَع في فخها الجميل. ستشاهد مسلسلات تصور التاريخ، وأخرى تؤرخ الواقع. ستتابع أعمالا بسيطة الإنتاج كبيرة المحتوى، وأخرى تزينت بالاثنين، حتى أن بعضها بُثّ عربياً، وأحدها نجح في خلق رُعب يُحاكي العالمية، ولكن بِوحيٍ من التراث الليبي وحكايا الأجداد.
وفي تصريحات له أشاد الكاتب والناقد منصور بوشناف بنصوص العديد من المسلسلات، وتمنى تحويل بعض الأعمال الأدبية الليبية إلى سيناريوهات فنية. وله الحق في ذلك، فالمشاهدة تضمن الانتشار، والمكتبات شبه الخالية من القراء مليئة بالقصص والروايات والملاحم، حتى أن بعضها تحول إلى أعمال درامية أجنبية، كما حدث مع رواية “من مكة إلى هنا” للأديب الراحل الصادق النيهوم، والتي تحولت إلى مسلسل فنلندي بعد نشرها في نهاية الستينات.
اللحاق بالركب
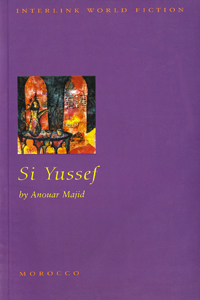
لقد اختلف الفنانون والمهتمون الليبيون في توصيف الحالة التي تمر بها الدراما في ليبيا؛ البعض يقر بأنها انطلقت تواً، وآخرون يرون في هذا الحكم تجنيا على الأجيال السابقة، إلا أن اتفاقاً ساد على ثبات الخطوات “في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل”. فهل يعني هذا أن الطريق ممهدة؟
يستبعد المنتج مؤيد زابطية ذلك، ويقول “بعد أن كانت المقارنة مع الأعمال العربية ظهرت نتفليكس Netflix. وهذا يزيد آفاق التحديات، لكنه سيدفع حتماً إلى تقديم الأفضل توالياً”.
ويضيف “المشكلة أن ساحتنا الفنية عذراء من ناحية الموارد البشرية، لهذا يجب على صاحب العمل تعليم جزء من الطاقم مهارات وتقنيات الأعمال الحديثة قبل التصوير، وهذا يستهلك الوقت والجهد والمال”.
لقد دفع ذلك إلى تطعيم بعض الأعمال بفنانين وفنيين عرب، ورغم أن التعاقد مع الفنيين كان مفيداً إلى حد ما إلا أنه خلق ركاكة في إتقان اللهجة الليبية بالنسبة إلى الممثلين.
يقول أبورونية “هذا صحيح بالنسبة إلى العنصر النسائي، لأنه نادر في الساحة الليبية، فخِرّيجات معهد الفنون قليلات، والباقيات هاويات لم تحنكهن التجارب”.
يختلف رأي الفنانة لطفية إبراهيم في المسألة، إذ تقول “كان هذا في الماضي، واليوم لدينا وجوه نسائية شابة موهوبة، لكنها لم تجد الفرصة بسبب قلة الأعمال وإغلاق معهد الفنون. والتعاون مع العرب يعود إلى الانفلات الأمني الذي دفع لتصوير بعض الأعمال خارج ليبيا، ومع أن ذلك يسرّع في الإنجاز لكنه يزيد في التكلفة. والدولة غائبة في سُباتها، وغاب معها حتى المسرح الوطني ودور السينما”.
غياب الدولة معضلة أخرى اختلفت حولها الرؤى، فقد طالب البعض بتدخلها لدعم الدراما، ومنهم من يريد دعماً غير مباشر كتوفير دورات فنية، في حين يفضل آخرون ابتعادها لِضمان حرية النص.
في أروقة وزارة الثقافة لا ينكر وكيل الوزارة خيري الراندي تقصير الدولة، ويرى في حديثه أن “أولى الخطوات يجب أن تتجه لتغيير القوانين، بحيث تحمي مصالح المستثمرين وتشجعهم على صناعة الدراما، ثم تلتفت إلى الفنانين وتساعدهم على تكوين نقابات لديها روح الاستمرار وسياسة الضغط على الدولة”.
ويختم قائلاً “بجانب قوس ماركوس أوريليوس التاريخي افتتح أول مسرح في طرابلس عام 1908. كنّا سبّاقين آنذاك، وأتمنى اليوم أن نلحق بالركب المتسارع”.






















