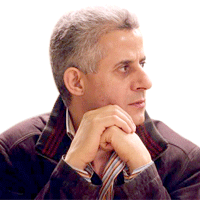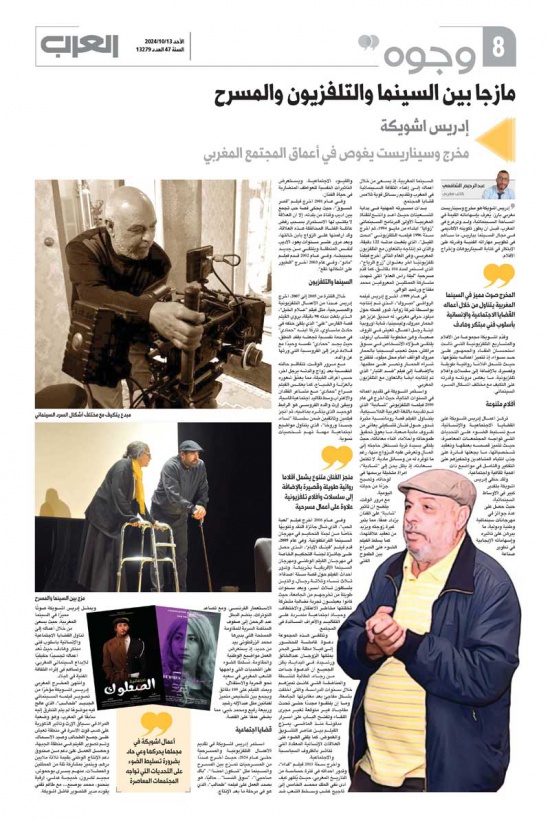التاريخ في مصر يعيد نفسه من المأساة إلى المسخرة

من المهم في مذكرات الشخصيات السياسية والمقربة من السلطة الحاكمة أنها لا تؤرخ للجانب الشخصي فحسب، بل هي في أغلبها شهادات على العصر وعلى خفايا السياسة والأحداث وكيف حيكت والأسباب والمآلات وغيرها من خفايا هامة للغاية لفهم مسارات الدول. ومن هذه المذكرات "مذكرات نوبار باشا".
أرّقتني “مذكرات نوبار باشا” في شهر رمضان. ظل شبح ساحة الفردوس في بغداد في التاسع من أبريل 2003 ماثلا. في العادة، أخصص رمضان لقراءات حرة، ومشاهدة مسلسل تلفزيوني واحد. وحرمني نوبار من هذا كله. جعل من الشهر المنذور للاسترخاء مسلسلا للقلق، وما يشبه اليأس في المدى القصير. أردت توثيق جملة محمد علي: “أنا رجل مسنّ وإبراهيم أكبر مني سنا بسبب مرضه”. كانا صقرين يتصارعان على غنيمة بحجم مصر، أب مسنٌّ أصابه خرف الشيخوخة، وابن مريض حقق انتصارات في المعارك الكبرى، وما يزال يشعر بالرعب من أبيه.
الطريق إلى هذه الجملة، لمحمد علي، أغراني بالسير في دروب مذكرات نوبار، والانخراط في دراما هوس الوالي سعيد بتقليد البريق الغربي، وغرق الخديو إسماعيل في أوحال التبعية والاستدانة، ورضوخه للرقابة المالية والإدارية البريطانية الفرنسية، ثم إجباره عام 1879 على التنحي ومغادرة مصر، وتنصيب ابنه توفيق، تمهيدا للغزو البريطاني الذي استمر أكثر من سبعين سنة، ثمنا للرغبة في الاستعراض والبهرجة، حتى إن نوبار قال لإسماعيل “سموكم كثيرا ما تأمرون بتنفيذ مشروعات من دون أن تتم دراستها إطلاقا، فتكون نتيجتها إهدار المال وإنفاقه فيما لا يفيد”، وذكر نوبار للخديوي أمثلة لمشروعات ليست لها دراسة جدوى، “وفشلت وتكلفت نفقات لا داعي لها”.
مأساة مصر
بعد قرن ونصف القرن سيقول عبدالفتاح السيسي عام 2018، في “منتدى أفريقيا” بمدينة شرم الشيخ، موجها الكلام إلى الدول المتقدمة: “وفق تقديري إن في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى، وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل، كنا هنحقق 20 – 25 بالمئة فقط مما حققناه”. لا تسأل ماذا تحقق؟ وبأي تكلفة؟ ولا تظن الكلام زلة لسان، فالممارسة تسبقه وتؤكده. وسيكرر الرئيس المصري استهانته بدرسات الجدوى عام 2022، في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: “لو فضلنا 3 أو 4 شهور ندرس الجدوى، وبعد كده نشوف التمويل، هنلاقي المشروع يطلع بعد أربع سنين». لا يريد الانتظار، ولا يعنيه أن العجلة من الشيطان.
لا أحب المأثورات. أعتبر إشهارها والتسلح بها دليل عجز، تبعية من نوع آخر. أُلزم نفسي بتفادي الجمل سابقة التجهيز، والموروثات التي أفقدَها الابتذال طاقتها التعبيرية والدلالية. والآن سأعتبر الضرورات تبيح المأثورات، وألجأ إلى مقولة كارل ماركس: “التاريخ يعيد نفسه. المرة الأولى كمأساة، والثانية كمهزلة”. أتأمّل طريق مصر في السنوات العشر الأخيرة، فأجده نسخة من طريق سلكه الخديو إسماعيل بين عامي 1863 و1879، ومهّده سلفه الوالي سعيد. نسخة مزيدة غير منقّحة. والكرة المتدحرجة لن تتوقف في منتصف المنحدر؛ لسرعتها وقوة الدفع الذاتي والارتطام بصخرة الحقيقة سيحدد حجم الانفجار القادم، وآثاره الكارثية.
"مذكرات نوبار باشا" كشفت عن حاكم شره إلى المال، مهووس بالبهرجة والاستعراض، ويدفعه العمى إلى الاستعجال
أخشى أن أثقل على القارئ باقتباسات كثيرة، مطولة، من “مذكرات نوبار باشا”. لعل هذا يكون من الضرورات، استثناء تكون فيها الشهادة وثيقة تاريخية. هي مذكرات مهمة، تبلغ 724 صفحة كبيرة القطع، ترجمة جارو روبير طبقيان، مقدمة وملاحظات ميريت بطرس غالي، مراجعة الدكتورة إلهام ذهني، ونشرها مركز الدراسات التاريخية لدار الشروق في القاهرة، برئاسة تحرير الدكتورة لطيفة محمد سالم.
تبدأ المأساة بانتقاص آدمية الإنسان، واعتبار الشعب مجرد شيء استعمالي، جموع في خدمة الحاكم. فمع بداية حكم الوالي سعيد حصل الفرنسي دي ليسبس على امتياز يسمح له بتأسيس شركة تتولى شقّ قناة السويس، ومن أجل هذا المشروع وافق الوالي على إدخال السخرة، وكان “شديد السطحية… كنا في بلد كانت فيه إرادة ونزوات الحاكم هي القانون الذي لا رجعة فيه”.
حملة دي ليسبس في أوروبا جمعت 112 مليون فرنك فقط، من مئتي مليون مطلوبة لبدء التنفيذ، فبادر باكتتاب 88 مليونا باسم الوالي، بصفته وكيله، ومن دون استشارته، ويُسدد المبلغ على خمسة عشر قسطا. قرأ دي ليسبس سيكولوجية الوالي؛ فورّطه في أمور أخرى. أغراه بثلاث سفن في ترسانات مدينة سيت الفرنسية، ثمن الواحدة 800 ألف فرنك، فأمر سعيدٌ بشرائها. سدد الثمن، وعند التسليم كانت الأولى لا تصلح للإبحار، وقد وصلت إلى الإسكندرية “وهياكلها الداخلية مفككة”. وتم تكهين الثانية فور وصولها. “أما الثالثة فلا نعلم ماذا حدث لها”. يسجل نوبار أنهم اكتشفوا أن شركة طلبت السفن الثلاث، للإبحار بين إسبانيا والجزائر، وأعادتها بسبب سوء الصناعة، وتحمل “صانعها تكاليفها”.
كان إبراهيم باشا قد أخذ نوبار في زيارات متعددة، لباريس ولندن والقسطنطينية وغيرها، “كان إبراهيم نفسه يعيش مثلنا ويقرأ التقارير والرسائل تحت ضوء الشمعة المثبتة على عنق نفس الزجاجة لأن إبراهيم كان يهتم بالشعب ومطالبه”. أما سعيد فمغرم بالمعسكرات، وشهد نوبار معسكرا في القناطر، أشرف سعيد على تفاصيله التي تشمل مسرحا للسمر، لإبهار ضيوفه الأوروبيين. خيمة الوالي “قصر منيف”، وبجوارها خيمة كصالة انتظار، وخيمة لإقامة الموظفين، ويجري التدريب على استعراض عسكري، والضباط يرتدون أفخم الأزياء.
لم يهتم سعيد إلا بجيشه، وكانت كل احتياجات الجيش ترد من باريس مثل الأقمشة غالية الثمن، “ورفيعة الذوق. ومحظوظة كانت الوكالة التجارية التي تستطيع الحصول على حق توريد أحد هذه الطلبات”. وقد طلب اثنتي عشرة مرآة كبيرة، يتراوح ثمن الواحدة بين خمسة وستة آلاف فرنك، لكنهم باعوه الواحدة بثمانية آلاف. وتم التعاقد على صناعة يخت كبير تكلف مئتي ألف جنيه إسترليني، “ملكة إنجلترا نفسها لم تكن تملك مثله.
حين نتأمل طريق مصر في السنوات العشر الأخيرة سنجده نسخة من طريق سلكه الخديو إسماعيل بين 1863 و1879
كان سعيد “لا يحب القراءة أبدا”، لم يقل نوبار إن الحاكم التعيس هو الذي لا يجيد قراءة التاريخ ولا الواقع ولا المستقبل. نوبار يقصد قراءة الكتب، ويمكن أن أقول عن الوالي سعيد إنه لم يقرأ المشهد الذي جعل نفسه بطلا فيه، ثم تخيل الخلاص على يد الإنجليز. ففي صيف 1862 صدمه الاستقبال الإنجليزي، بعد مروره بفرنسا. وتحدث مع اللورد بالمرستون عن أزمته المالية، فقال أحد المقربين من اللورد لنوبار “أي شخصية تلك التي يتمتع بها واليكم؟! يتكلم مع اللورد بالمرستون عن المشكلات التي أوقع هو نفسه فيها مع المسيو دي ليسبس وشركته ويتوقع أن اللورد هو الذي سيخلصه منها؟!”.
الوالي محمد سعيد الذي حكم مصر بين عامي 1854 و1863 انتهى نهاية بائسة. ولعله كان يخشى تلك النهاية. في نوبة مكاشفة ذاتية كان حزينا، والدموع في عينيه، وقال لنوبار “خربتُ مصر! خربتها تماما!! ماذا سيقولون عني؟”. أفاق متأخرا، وفكر في محكمة التاريخ، وعاجله الموت، أو أراحه. ولو علم بالمشهد في قصره، في اللحظة التالية لموته لأعاد النظر في سياساته، وتدبّر أوّليّاته.
توفي سعيد في الإسكندرية، يناير 1863، فتجمع الموظفون وكتبوا تلغرافا إلى وليّ العهد إسماعيل في القاهرة، يسألونه عن التعليمات. يسجل نوبار أن الوالي الجديد دعاهم إلى الحضور إلى القاهرة، فنسوا الوالي الميت، وسرعان ما “تهافت الجميع على أول قطار يغادر إلى القاهرة وهرعوا للذهاب دون ترك أي أوامر أو اتخاذ أي إجراءات بخصوص مراسم الدفن. ولا أعلم كيف تم الدفن: لأن الجميع سافر إلى القاهرة“.
رجال الوالي سعيد، هم رجال أي حاكم ما دام حيّا، سارعوا إلى السفر للقاء الوالي الجديد، من دون ترك تعليمات أو أوامر تخص إجراءات دفن جثمان الوالي الراحل، حتى إن نوبار لم يعلم كيف تم دفن سعيد الذي رافقه إلى قبره “النسيان واللامبالاة الكاملة… وعلمتُ أيضا فيما بعد أن جثمانه دفن في مسجد النبي دانيال“.
موتٌ فقير، يخلو من المهابة، لكنه أكثر كرامة من النهاية الأكثر بؤسا لخلفه الخديو إسماعيل.
الوالي المهووس بباريس

عمل نوبار باشا مترجما للوالي محمد علي. وإبراهيم باشا صحبه في جولات أوروبية. نوبار رأى في الرجل الكبير وابنه إبراهيم شخصين عظيمين. وأعاد الاعتبار إلى الوالي عباس الأول، في شهادة تضعه في مكانة تلي عمه إبراهيم. أما الوالي محمد سعيد فكان يعامل ولي العهد إسماعيل “كأنه بقال وكان يقول دائما: سوف تفتقدونني عندما يصبح واليا عليكم”. في مساء اليوم الأول لتسلم السلطة أبدى إسماعيل لنوبار “فكرة كانت تراوده منذ عهد سعيد ألا وهي تقسيم الأزبكية وبيعها”. كانت الأزبكية بحيرة تم تجفيفها، وجعلها محمد علي حديقة زرع فيها أشجارا متنوعة، ولخّصت الحديقة تفاصيل الأجواء العمومية، والعادات الاجتماعية المصرية. كانت ملتقى للترويح عن أهل القاهرة وزائريها.
لم يتوقع نوبار الفكرة الشريرة، المبكرة، لإسماعيل بقطع “الأشجار التي زرعها محمد علي وراقب نموها بكل حب لتحل محلها العمائر والمنازل القبيحة من أجل جمع المال”. الأموال تعمي البصائر عن الجمال، فتتم التضحية به. والحدائق لا تنمو أشجارها في يوم وليلة، لكن هذا حاكم شرهٌ إلى المال، مهووس بالبهرجة والاستعراض، ويدفعه العمى إلى الاستعجال. تبدو الأشجار والحدائق في المدن، وكذلك الإسفلت، عقدة المستبدين.
من المأساة إلى المسخرة، لا تخطئ العين الآن وجود خطة شريرة لتصحير القاهرة، بالانتقام من الأشجار في الشوارع، وحدائق الميادين. هناك في الظلام شخص كاره للحياة، يخطط ويصدر الأوامر. والموظفون ينفذون قطع الأشجار، وتعرية الشوارع وسرقة الظل. ما لا يمكن اجتثاثه بضربة سريعة تم إغلاقه، مثل حديقتي الحيوان والأورمان. والشرير الخفي، عدوّ النور، لا يجيب عن الأسئلة.
وهناك في الخلاء كيان مسلح، يشبه قلاع المماليك، وبدلا من الاسم الدال عليه وجدوا له صفة تمثل خبرا لمبتدأ محذوف، الخبر هو “العاصمة الإدارية الجديدة”. في هذه العاصمة أُعلن، في مارس 2024، عن إنشاء غابة عمودية تتكلف مئتي مليون دولار، مبلغ ضخم يساوي عشرة مليارات بالجنيه المصري الفصيح. ربما تكون هذه الغابة العمودية مسوّغا لإطلاق اسم “الواحة” على تلك العاصمة، القاصمة.
قصر نظر الوالي جعله يتعجل رصف الطرق، ويظن ذلك خارج الميزانية بسبب السخرة. وكان نوبار يرى أن السخرة تكلف مصر أكثر بكثير من أجرة العمال، إذ أدت إلى تراجع الاقتصاد الزراعي. تلك الخطوط لم تستهدف المنفعة العامة، “وإنما من أجل المنفعة الخاصة وهي خدمة الأراضي الشاسعة التي كان سموُّه قد استباحها لنفسه”. وكان الفلاحون يُنتزعون من أرضهم للعمل في رصف الطرق، ويُطالبون بدفع الضرائب عن محاصيلهم التي أُجبروا على هجرها.
والقروض أيضا ليست بريئة من اتهامات تصيب الطرق “الخاصة”. في أغسطس 1865، طلب إسماعيل سبعة ملايين جنيه، قرضا من بنك التسليف الباريسي، “لحساب أبعاديته الخاصة”.
كان نوبار يرى أن السخرة تكلف مصر أكثر بكثير من أجرة العمال، إذ أدت إلى تراجع الاقتصاد الزراعي
لعل الخوْتة أصابت إسماعيل في باريس، وحضوره المعرض الدولي 1867، وقد دعي إلى سهرة مع الإمبراطور، وفي المدخل دقّ الحاجب السويسري كعب الصولجان بيده، وأعلن بصوت مجلجل “صاحب الجلالة ملك مصر”، وذلك بتأثير حصول إسماعيل على لقب “خديو”، وكان يريد لقب “عزيز”. وبدلا من الانشغال بالإصلاح القضائي، وهو مشروع استهلك من نوبار سنين، في جولات بين القسطنطينية والعواصم الأوروبية، شغل نفسه “بأمور تبدو له أكثر جدية حيث إنه كان مشغولا بتجميل القاهرة”، يريدها مثل باريس، وقد التقى المهندس هاوسمان، وحدثه عن هذا الهوس.
وتوالت القروض، ففي عام 1868 أبرم إسماعيل اتفاقية لاقتراض عشرة ملايين جنيه إسترليني، ولم يكن يستشير “من اختصاصهم تنفيذ أو تحقيق الفكرة أو المشروع، لقد كان الوالي هو كل شيء”. وقال رجل البنوك المسيو جرنشي لنوبار إنه أثناء نسخ هذا العقد، راودته فكرة “نصح الوالي بأنه إذا تم صرف المبلغ واستخدامه في غرض غير إخماد العجز والدين العام، ويتم صرفه على عمليات التجميل التي كانت مستمرة في القاهرة أو صرفه على مؤسسات أخرى غير منتجة، فإنني كنت أعتقد أنه من واجبي أن أنبه عظمته إلى أنه سينتهي به الأمر بأن يجد نفسه في ورطة اقتصادية ستنتهي بشكل مرير عاجلا أم آجلا إلى إعلان إفلاس مصر”.
مهم التنبيه، هنا وفي نهاية كل فقرة، إلى أن رجل البنوك يتكلم عام 1868، عن الخديو، وليس عن المشهد المصري الآن، عام 2024.
اعتمد تمويل الخزانة على القروض والضرائب المتزايدة. وحال الخبَل الشخصي للخديو دون رؤية أوّليّات الإنفاق، فأهدر مبالغ كبيرة في أمور أكبر من سلطاته،إذ أبرم اتفاقية قرض بلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني لشراء سفينتين حربيتين عام 1869 من فرنسا، ولم يكن لمصر الحق في امتلاك أسطول. وطلب الباب العالي التخلي عن السفن الحربية، “وعلمنا فجأة ومن دون أن يقول لنا شيئا أنه قد امتثل لسيده”. هكذا جلبت “عملية التسليح البائسة” المزيد من الديون.
الآخر يفهم سيكولوجية أمثال إسماعيل، ولا يأبه لدولته، ففي افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الفرنسي عام 1869 لم يذكر الإمبراطور الفرنسي “حتى اسم مصر” في كلامه عن افتتاح قناة السويس، وعن فرنسا. سلوك الإمبراطور أثار دهشة نوبار الذي يسجل أن حفلات افتتاح القناة تكلفت “كثيرا لا أعرف كم من الملايين، لكن أعرف فقط أن أحد متعهدي توريد الأطعمة وكانوا كثيرين، سددنا له مبلغ مئتي ألف جنيه إسترليني”، وأسعد الوالي أنه خفض المبلغ إلى النصف. وقد تم “تهميش الشخصيات الرزينة”.
سقوط الخديو

لكل مستبد مخالب، يداريها أحيانا بقفاز وزاري. جاء دور وزير المالية إسماعيل المفتش أمين أسرار الخديو. بعد افتتاح القناة بلغ الدين العام نحو ثلاثين مليون جنيه إسترليني، “تمثّل شيئا مخيفا”، فوائدها السنوية تتراوح بين 20 و30 في المئة “يتم إخراجها من جيوب الشعب”. وكان الخديو يمتلك ربع المساحة المزروعة في مصر.
كان لهذه المبالغ المستخرجة من جيوب الشعب أن تخفف الديون، لو عكف الوالي على إصلاح إدارته، أو “أن يقوم بإصلاح نفسه”، لكن توفير هذه الأموال شجعه على المزيد من إهدار المال، فشيّد سراي الرمل الذي دمره حريق، فأعاد بناءه بتكلفة تسعمئة وخمسين ألف جنيه. وتكلف قصر الجزيرة ثلاثة ملايين، واستمر عمل المسيو هاوسمان في تجميل القاهرة، بالتوازي مع نفقات عسكرية “كما لو كنا قوة عسكرية عظمى”.
وسوف تكتشف لجنة التحقيق العليا الأوروبية عام 1878 أن أملاك الوالي مليون ومئتا ألف فدان، من رقعة الأرض الزراعية في مصر، وقدرها أربعة ملايين ومئتا ألف فدان.
ومع استمرار العجز عن سداد أقساط فوائد الدين، أبرم الوالي مع بنك أوبنهايم عام 1873 عقد قرض جديد قدره ثلاثون مليون جنيه إسترليني، دخل الخزانة منه 20.740.077 جنيها، “بعد خصم مصروفات وخلافه”. لم يوضح نوبار طبيعة المصروفات، ومن المستفيد منها، كما لم يفسّر معنى “خلافه”.
العجز جعل الإفلاس حقيقة تنتظر التوقيع على إعلانها. إشهار الإفلاس معناه ضياع الوالي، وهنا بيعت أسهم مصر في قناة السويس في نوفمبر 1875، للحكومة البريطانية بأربعة ملايين جنيه إسترليني، وخيمت على القصر فرحة بدخول هذه الملايين الأربعة، “وبهذا سيتم تجنب الإفلاس، فرحة ساذجة”؛ لأن بريطانيا امتلكت نصف أسهم القناة، وهكذا “حصلت على حق اتخاذ القرار وأصبح لها نفوذ لدرجة الحصول على حق واضح في إدارة شؤون القناة”، وصارت مصر تحت رحمة بريطانيا. وبهذه الذريعة سوف تنضم إلى فرنسا والكيان الصهيوني في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
في فمي ماء يمنعني أن أقفز قفزة زمنية، لكنها مكلفة. اللهم إني خائف. فلأرجع إلى الماضي أسلم.
استمرار الأزمة الاقتصادية أرّق الوالي الذي هزّه إرسال الحكومة الإنجليزية، عام 1875، المسيو “كيف” على رأس لجنة اقتصادية ومالية، لمراقبة الموارد التي ستخصص لسداد الديون، وكتابة تقرير عن الوضع الاقتصادي، كما طالب بفحص سجلات وزارتي المالية والتجارة، “الأمر الذي أصاب الوالي بالرعب واليأس… ولمدة ليلتين أو ثلاث كان كتبة الوزارة مشغولين بتعديل هذه السجلات”. الوصاية الأجنبية تعني السيطرة على الإدارة المصرية، وعلى الإرادة أيضا. وأُجبرت مصر على قبول تأسيس صندوق الدين العام سنة 1876، وفي السنة نفسها وصلت لجنة تمثل الدائنين، برئاسة جوشن الإنجليزي وجوبير الفرنسي؛ للمراقبة المالية، وتقرير مدى القدرة على الوفاء بالتزامات السداد.

بناء على تقرير المراقبين الإنجليزي والفرنسي تشكلت لجنة تحقيق أوروبية عام 1878، للتفتيش المالي والإداري. أذعن الوالي للجنة التي مثّلها الإنجليزي ولسون والفرنسي دي بلينيير ومبعوثون من ألمانيا والنمسا وإيطاليا. كان الخديو يدعو إلى الثقة في موارد البلاد المثقلة بالديون. طوال أربعة عشر عاما من حكم إسماعيل، وُضع تحت تصرفه مئتان وخمسون مليونا، منها مئة وأربعون مليونا لم تُعرف الجهة التي أنفقت فيها. وقامت اللجنة بإجبار الخديو على أن يعيد إلى الحكومة أراضيه التي تُقدر بمليون ومئتي ألف فدان، هي تقريبا ربع مساحة الأرض الزراعية. وقد هاجمه الميجور إيفلن بيرنج (الذي حمل اللقب اللورد كرومر منذ عام 1892) بعنف أمام اللجنة، “وهدده بكل ما لدى القوى العظمى من سلطات في حالة عدم قبوله لقرارات اللجنة وتوصياتها”.
في تقدير نوبار أن فرض الرقابة المالية والإدارية يعني أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية “تحكمان حكومة ثالثة وهي الحكومة المصرية”. ويسجل أنه شرح للخديو عام 1878 جانبا من سوء الإدارة، بقيام الخديو بإعطاء أوامره مباشرة إلى المديرين ومساعديهم “وإلى رؤساء الأقسام والأقاليم وإلى مفتشي الضرائب بعيدا عن الوزراء المسؤولين”، وهذا يسبب الفوضى والحيرة “بالإضافة إلى أن سمّوكم كثيرا ما تأمرون بتنفيذ مشروعات من دون أن تتم دراستها إطلاقا، فتكون نتيجتها إهدار المال وإنفاقه فيما لا يفيد”، وضرب نوبار للخديو أمثلة لمشروعات فشلت؛ لأنها لم تُدرس قبل التنفيذ.
وأضاف نوبار “يجب على سموّكم أن تتعهد بألا تقوم بتنفيذ أي عمل من أعمال الأشغال العمومية أو أي عمل آخر يحتاج إلى إنفاق من دون أن يقوم النظار المختصون والمسؤولون بدراسته أولا ومن دون أن يناقشه ويوافق عليه جميع النظار في اجتماع موسع… على سموّكم أن تلتزم أيضا بعدم تخطي اختصاصات الوزير المسؤول بإصدار أوامر مباشرة لمن هم تحت قيادته وإدارته. باختصار يا سيدي يجب أن يتعهد سموُّكم بشيء واحد فقط وهو أن تحكم من خلال مجلس النظار“.
وفي الوزارة التي تشكلت في أغسطس 1878 عُيّن ولسون الإنجليزي وزيرا للمالية، والفرنسي دي بلينيير وزيرا للأشغال العمومية. ومع نقص الموارد وضغوط مستحقي الديون الأوروبيين اقترب “وقوع الكارثة التي كانت تنتظرنا”. بحجة ضغط المصروفات، قرر ولسون الإنجليزي وزير المالية تسريح 2500 ضابط، ولم تكن رواتبهم قد دفعت منذ عامين؛ فتظاهر الضباط في 18 فبراير 1879، واعتدوا على نوبار، واقتحموا قاعة مجلس النواب التي هرب منها النواب. ولم يكن “في الخزانة فلس واحد”.
في صباح اليوم التالي، 19 فبراير، قام محمود سامي البارودي رئيس البوليس بزيارة نوبار، وأبلغه بانسحاب الضباط إلى ثكناتهم. وبناء على اقتراح الميجور بيرنج (كرومر، الذي سيكون المندوب السامي) أرسل فيفيان قنصل إنجلترا برقية إلى الأميرال البريطاني في مالطا؛ “حتى يأتي بأسطوله إلى الإسكندرية”. وفي رأي نوبار أن الضباط كانت بينهم مجموعة “تتهم الوالي بصفته السبب الأول والرئيسي لما يحدث من سوء… أعتقد أنهم كانوا مستعدين للانقلاب عليه إن وجدوا وراءهم قوة يستطيعون الاعتماد عليها”.
تصاعد الغضب البريطاني – الفرنسي في مايو 1879، وتساءل نوبار هل يريدون تسوية حقيقية للديون، “تنقذ البلاد وأصحاب الديون؟ أم كانوا يريدون التضحية بالبلاد لصالح الدائنين؟”. وفي الشهر التالي أجبروا الخديو على التنازل عن الحكم. وافق على التنازل، ثم وصله قرار العزل من السلطان العثماني. هكذا أهلكت الأفكار الجامحة إسماعيل الذي “خربها وأضاعها”.
كان المشهد جاهزا لعواصف رهيبة، وصراع قوى غير متكافئة. وفي عام 1881 بدأت حركة أحمد عرابي، أول ثورة دستورية في مصر والعالم العربي، للمطالبة بنظام برلماني، يجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب. وتواطأت بريطانيا والسلطة العثمانية على إجهاض الثورة، ووقعت البلاد في قبضة بريطانيا لأكثر من سبعين سنة.
لا أعاد الله تلك المأساة، يكفينا احتمال المسخرة.